سرديات عودة
فصل من رواية " الحالم" للروائي الجزائري سمير قسيمي (الثلاثاء 26 حزيران 2012)
جلستُ وليليا أنطون بشرفة كافيتيريا "ميلك بار" بعد أن انتظرتها قرابة الساعة ببهو فندق "ريجينا" حيث كانت تقيم. ففي صبيحة ذلك اليوم هاتفتني حوالي العاشرة تخبرني أنها وصلت الجزائر قادمة من بيروت وحجزت غرفة بالفندق، وأن علينا أن نلتقي حوالي الواحدة زوالا. لم تضف شيئا إلا أن الأمر مهم ولا يجب أن أتأخر عنها.
كانت ليليا ربّة عملي. هكذا أحبّ أن أعتبرها. تعارفنا منذ عشرة أعوام بالصدفة حين بعثت لدار نشرها مخطوطة رواية كتبتها. كنت وقتها في العشرين فحسب. ومع ذلك لم تكن تلك إلا واحدة من أربع روايات كتبتها في وقت سابق. ففي تلك السنة، شعرت أن المخطوطة التي أرسلتها إلى ليليا تستحق أن تنشر. لا أعرف سبب ذلك الشعور إلا اعتزازي بها، فهي لم تكن رغم ما اجتهدتُ في اختلاقه، إلا قصة حقيقية حدثت معي.
المهم، لم تمرّ ثلاثة أشهر حتى وصلني ردّ ليليا الذي يمكن أن أصفه بصفعة حررتني من أوهامي. كتبت تقول:
" عزيزي..
وصلت روايتك وعرضت على لجنة القراءة. وحتى لا أطيل عليك فقد كان رأيها سلبيا مشفوعا بما معناه أن ما قرأوه لا يمكن أن يعتبر نصا أدبيا أيا كان نوعه. وخشية من أن تكون اللجنة قد تشدّدت في معاييرها فقد قرأتها بدوري، ووجدت عند الانتهاء منها أن اللجنة كانت غاية في اللطف معك، حين لم توجه إليّ إنذارا بعدم قبول استلام أي عمل يحمل اسمك في العقدين القادمين على الأقل، فأنا ومع احترامي لحلمك في أن تكون روائيا، أنصحك قبل أن تبدأ في كتابة أي شيء تصفه بالرواية لاحقا، أن تقرأ جميع ما كُتب لحد الآن في هذا الفنّ. وحين تنتهي، فحاول ألا تجرؤ على القلم وتمهّل حتى تقرأ ما سيكتب في العشرين سنة القادمة. وبعدها سيكون من حقك تضييع وقت أيٍّ قارئ..
محبّتي الخاصة.
ليليا أنطون".
بمجرد أن قرأتها تملّكني الغضب. أخرجت ورقة وكتبت من دون أن أفكر:
"عزيزتي..
وصلني ردّك ورأيك في روايتي. ومع شكري الخالص لك على نصائحك الصادقة، لا يسعني إلا أن أصارحك بما لم يستطع أحد مصارحتك به من قبل. أقول لك بكل حب.. أنت عاهرة بحق.
محبتي المفرطة
سمير قسيمي".
ثم وضعت الرسالة في مظروف وأرسلتها إلى دار نشرها.
كان من الممكن أن ينتهي الأمر على هذا النحو. بل وكان يجدر به أن ينتهي هكذا، فمع مرور الوقت أتذكّر ما حدث فأضحك على نفسي، أوّلا لأنني حاولت أن أكون شخصا لم أكنه، وثانيا لأنني تجرّأت ووصفت سيدة مجتمع معروفة كليليا بالعاهرة. ولكن الأمر لم ينته عند هذا الحد، فقد وصلتني بعد أشهر رسالة أخرى من ليليا، تعتذر مني على تجرئها عليّ، وتنصحني، إثباتا لحسن ظنّها بي، بإعادة كتابة روايتي من جديد، مع وعد بنشرها إذا شعرت بوجود تحسّن فيها. وهكذا فعلت وأعدت كتابتها ستّ مرات وأرسلتها إليها. وبالفعل نشرتها ليليا حين رأت بأن النص أصبح قابلا للقراءة.
بعدها لم أنشر أيَّ عمل. حتى إنني لم أحاول كتابة أي شيء أدّعي لاحقا أنه رواية. واكتفيت بترجمة الأشعار وبعض القصص القصيرة. وحين بدأت أتحكّم أكثر في ناصية الترجمة خضت غمار الروايات المكتوبة بالفرنسية، وتخصّصت في بعض كتابها، حتى بدأت كبريات دور النشر العربية والفرنسية تستعين بخدماتي، لاسيما وأنني كنت أترجم من اللغتين العربية والفرنسية وإليهما أيضا.
لا أذكر أنّ هناك نصا جعلني أقضي فيه أكثر مما أُمهل نفسي لترجمته، إلا "الحكاّءة" لريماس إيمي ساك، الذي جعلني ألعن اليوم الذي تجرأت فيه على الترجمة. كان نصا معقدا، بحبكة لا يمكن القبض عليها، حتى الزمن فيه كان متشابكا، إلى درجة أنني كنت أضيع فيه من دون أن أعي حقا في أيّ شيء يخوض إيمي ساك: في واقع بطلته "الحكاءة" أم في خياله هو. ولكن باستثناء هذا النص، لم يعجزني أي عمل من أعماله، حتى تلك التي صنعت بريقه على غرار "انتحار"، "الجدار" و"رسل الحقيقة". لهذا اعتُبرتُ وقبل أن أبلغ الثلاثين من العمر متخصّصا في ترجمة أعمال ريماس إيمي ساك، حتى أنني ترجمتها أكثر من مرة وبمستويات أدبية مختلفة.
لن أدّعي بالطبع أن عالم الترجمة جعلني أرغب عن كتابة الرواية، لأن المسألة لم تكن تتعلق بالكتابة بقدر ما تعلقت بالشعور الملازم لها، فلقد أدركت من خلال محاولاتي اللاحقة لنشر روايتي الأولى أنني كاتب جيد. ومع ذلك كانت كتاباتي خالية من الشعور. وحين أقول ذلك فأنا أعني الهوس والجنون والرغبة والاندماج والإيمان.. كل الأحاسيس التي تتقمص الكاتب الحقيقيّ حين يشتغل على الكتابة.
هذا ما أخبرتُ به ليليا بعد أن توطدت علاقتي بها، رغم أنها استمرت تسألني مرارا أن أحاول من جديد. فقد كانت تشعر بأنها السبب في توقفي عن الحلم. ولعل شعورها بالذنب نحوي جعلنا نتقرب من بعضنا أكثر، ونمزج بتجرؤ كبير لاحقا بين علاقتنا المهنية وعلاقتنا الشخصية التي تطورت لتصبح "صداقة ببعض المنافع". منافع كنا نقطفها كلّما تواجدت ليليا في الجزائر لسبب أو لآخر، بحيث أمنع عنها شعور الغربة وتمنحني بالمقابل بعض ما يجعل الحياة قابلة للاحتمال. وفيما عدى تلك الساعات التي اعتدنا قضاءها معا مرة أو مرتين في السنة. لم نكن إلا صديقين يشغلنا الأدب عن الحياة، إلى درجة أنني كثيرا ما اعتبرت أن ما أقوم به من ترجمة وتصحيحات وملخصات لصالح ليليا ليس عملا بحدّ ذاته. ولولا الشيكات التي كانت تصلني بين الحين والآخر من دار نشرها، لاعتبرت الأمر تطوّعا يستحق مجانيته.
كانت ليليا تكبرني بنحو عشرين سنة. ومع ذلك لم أهتم يوما بهذا الفارق في العمر بسبب أننا كنا منسجمين على نحو كبير. ولو أنها لم تكن متزوجة لكنت فكرت في أن أعرض الزواج عليها، فكثيرا ما حلمت بأن تكون المرأة التي تقاسمني حياتي امرأة تفهم في الحرف. أما كيف يكون شكلها، فهذا أمر ما كان ليشغلني على الإطلاق، ما دمتُ أملك من الخيال ما يجعلني أعجنها على الشكل الذي أرغب فيه حتى وإن كانت تشبه الجاموس.
مهما يكن، كان أول سؤال طرحتُه على ليليا بمجرد أن طلبنا المشاريب "لماذا حجزت في فندق ريجينا ذي النجمتين ولمَ أصرّت أن نلتقي في شرفة كافيتيريا "ميلك بار" بالتحديد؟"، وهي التي أعرف ولعها بالفنادق الفخمة بكل ما فيها من ترف. ثم إنها لم تكن تعرف من العاصمة إلا موقع المطار وفندق "سان جورج" الذي اعتادت الحجز فيه، فكيف اكتشفت وجود فندق ريجينا هذا، وعرفت أسماء الشوارع المحيطة به. فبمجرد أن خرجنا من الفندق سألتني أن آخذها إلى "ميلك بار" ولكن عن طريق شارع "مصطفى بن بولعيد".
ابتسمت ليليا وقالت وكأنها لم تصغ إليّ: "آه.. كدت أنسى". ثم أشارت إلى النادل وطلبت فنجان قهوة إكسبريس ببعض ماء الزهر.
أدهشني أنها تطلب مثل هذا، وهي التي كثيرا ما عنّفتني على شرب القهوة. كانت تقول لي بالحرف الواحد "إنك يا حبيبي تشرب موتك سائلا". ولكن الذي أدهشني أكثر أن تطلب مع قهوتها قطرات ماء الزهر.
قلت مجددا: "تبدين مختلفة حبيبتي.". فأجابت بدلال: أتعتقد؟..
أدركت حينها أن تلك لم تكن ليليا التي عرفت من قبل. فقبل هذا اليوم كنت لأقسم أنه لا توجد في كل قواميس العالم أية كلمة من شأنها إذا نطقنا بها أن تظهر الأنثى في ليليا في غير أوقات الجنس. فلطالما كانت من النوع الصارم في أحاديثها حتى العاطفية. أما دلال المرأة الشرقية فلم يكن يظهر فيها إلا في ساعات حميمياتنا لا أكثر، فإذا انقضت ولو بدقيقة واحدة تعود لتتقمص جسد امرأة أعمال متأصلة في الحساب.
في الحقيقة، كان هذا ما أحببت في ليليا. أقصد قدرتها على الفصل بين رغباتها وحياتها العادية، والخوض فيهما بمنتهى الصدق. قدرة ما كنت لأحلم بامتلاكها حتى وإن تظاهرت بذلك، ليس خوفا من أي شيء، بل لأنني ومنذ وقت طويل أدركت في أي مجتمع أعيش. لهذا فضلت أن أختار لي وجه الرجل الطيّب، ذي الملامح الصبيانية البريئة، رغم أن في داخلي كانت براكين الرغبة لا تكفّ عن الثوران. ربما لم أكن في ذلك مختلفا عن سواي إلا في كوني لم أنافق نفسي كلّما واتتني الفرصة. وكانت ليليا فرصة جنسية جعلتني أرضى بالصوم لأشهر من دون أن تستثيرني أية أنثى.
قلت وأنا أرى ابتسامتها طافية على وجهها: "أكيد. أنت مختلفة اليوم. صبغت شعرك كما أرى. كنت أعتقد أنك تمقتين هذا اللون".
"كنت مخطئة فيما يبدو..".
قالت وهزت رأسها ليتدلى شعرها الأشقر المتموّج. لا أنكر أنني وددت لو فعلت هذا ونحن بمفردنا، فقد بدأتُ أشعر لحظتها أن عليّ أن أتدارك الأمر وأضع أي شيء على حجري. لطالما كان من المحرج أن يحدث لي مثل هذا في مكان عرضة للتلصص.
- أكيد.. كنتِ مخطئة بلا ريب..
قلت ومططت شفتيّ رغبة في ترطيبهما وقد جفّتا على حين غرة. ثم أضفت حين شعرت بأنها كانت تحاول بنظراتها أن تورطني مع رغبتي فيها:
- لم تخبريني عن سبب حجزك في هذا الفندق وجلوسنا هنا.
لم تجب واستمرّت في نظراتها إليّ. وما هي إلا دقائق حتى أدركتُ أن وضع شيء على حجري لم يعد أمرا يقبل التأجيل.
ومن دون أن ترتشف قهوتها، قامت ليليا من مكانها ومالت نحوي وكأنها كانت ستقبّلني. أحرجني الأمر أن تفعل ذلك في مثل هذا المكان. ولكنني في قرارة نفسي وددت لو أنها تفعل حقا، فتلامس شفتاها شفتيَّ وتدرك أيّ نار كانت تلتهمني ساعتها. ولكن ما أن بلغ فمها وجهي حتى همست لي "أنا في الغرفة 142، احجز لنفسك غرفة أيضا". وانصرفت من غير أن تلتفت.
لم أكن محتاجا إلى المزيد من التفكير لأوقن أن بليليا خطبا ما. ولكنني ومع كل ما كنت أقاومه لحظتها لم أفكر إلا في أن أجد أسرع طريقة تجعلني أخمد كل تلك البراكين التي ثارت داخلي في وقت واحد.
حين هدأت، دفعت الحساب وقمت مسرعا لألحق بليليا، ولكنها كانت قد سبقتني إلى الفندق بلا شك، فالوقت الذي استغرقته للهدوء كان كافيا لتبلغ الفندق وتصعد إلى غرفتها، ولربما أيضا لتستحم وتغير ثيابها. فلطالما كنت من النوع الذي يحتاج إلى الكثير من الوقت ليفرِّغ أولى حمولاته. ولعلّ من عرفنني من النساء كنّ يزددن فيّ غراما لهذا الأمر، أو لعله كان وحده ما يجعلهن يغرمن بي في الأصل.
ما أن دخلت الفندق وحجزت غرفة حتى هاتفت ليليا. وصفت لي موقع غرفتها. كانت في الطابق الثالث تطلّ على مبنى المركز الثقافي الفرنسي من الجهة الخلفية، ولكنها استمهلتني لما بعد العصر، فلم أجد بدّا من الموافقة. فقد كنت أعلم أن لليليا طقوسها في الجنس، فهي من النوع المرتاب في جسدها وأناقتها. وحين تواتيها مناسبة للمضاجعة لا تترك أي شيء للصدفة. ومع علمي بذلك وددت لو تخلصت من عاداتها تلك هذه المرة.. فقط هذه المرة إلى حين ترسي سفينتي، لئلا تغرق وتغرقني معها.
وكانت الثالثة والنصف مساء حين فكرتُ في الخروج لأقضي ما تبقى من الوقت في التسكّع. هكذا يمكنني احتمال وطأة الانتظار، ولكنني حين هممت بذلك هاتفتني ليليا لتخبرني أنها قريبا ستكون مستعدة، وأن موعد ما بعد العصر قد يتغير في أية لحظة. لذلك ألغيت فكرة الخروج وحاولت إلهاء نفسي بمشاهدة التلفاز حتى رنت الساعة الخامسة.
أمهلت ليليا نصف ساعة أخرى ولكنها لم تهاتفني، فخمّنت أنها ترغب في أن أهاتفها أنا وفعلت. لكن هاتفها بقي يرن من دون جواب لقرابة ربع الساعة. وحين يئست كلّمتني وادعت أنها كانت نائمة ولم تشعر بالوقت. لم أحاججها وانطلقت مهرولا إلى غرفتها.
دخلت وفي رأسي مشاريع أسرعها إنجازا ينتهي في منتصف الليل. ولكنني بمجرد أن تجاوزت عتبة الغرفة رأيتها واقفة بجانب السرير ذي المكانين في كامل أناقتها. قالت لحظة رأتني أنها فكرت في أن نتعشى أولا حتى لا نضطر للخروج ليلا. ومن دون أن تسمع رأيي، تجاوزتني ووضعت المفتاح في قفل الباب وأضافت "أسرع، دعنا نذهب لنعود بسرعة. لا تعلم كم اشتقت إليّك حبيبي".
هكذا خرجنا وقضينا ساعات بين عشاء لم أستلذه وأحاديث فارغة لم تكن لتهمني في شيء. ولعلّ أهم جملة قالتها في كل تلك السهرة، ما تعلقت برغبتها في أن نعود إلى الفندق لنكمل ما لم نبدأه في الأصل.
هذه المرّة صعدنا إلى غرفتها معا رغم ادعائنا أمام أمين الفندق أننا لا نعرف بعضنا كي لا يفكر في أي شيء بغيض، فالحبّ في هذا البلد –كالموت تماما- يحتاج لممارسته إلى وثيقة تجيزه. وبمجرد أن دخلنا، حتى تعرّت ليليا من كل شيء. قالت وهي تنزع آخر قطعة من لباسها: "ألم تلاحظ أيّ شيء؟".
قلت وأنا ألتصق بها: "هذا..". ووضعت يدي على عُنَّتها. ثم أضفت هامسا مدنيا شفتيّ من شحمة أذنها اليمنى: "أصبح زغب عنتك أشقر ومشذوبا على غير العادة". وطفقت أقبلها على رقبتها وهي تتأوّه وقد لفتني بساقها حتى سقطنا على السرير، أنا فوق وهي تحت. وحين هممت بأن أجعل المسألة أكثر عمقا دفعتني حتى تراجعت. قالت وهي ترمقني بنظرة داعرة: "انتظر حبيبي.. عندي لك مفاجأة". وقامت إلى حقيبتها وأخرجت سروالا داخليا أحمر اللون. لوّحت لي به من دون أن أتمكن من معرفة تفاصيله. أضافت بخفوت: "اقتنيته من باريس منذ أشهر وأنا أفكر فيك..". وبدلال أكثر: "دعني أرتديه لأجلك".
حركت رأسي موافقا، ثم استدرت لأتركها على راحتها ولكنها التصقت بي من خلف وهمست لي: "لا عزيزي.. تذهب إلى غرفتك وتعود بعد ربع ساعة. أكون فيها قد ارتديت هذا ومفاجأة أخرى لن تخطر على بالك. أريدك هذه الليلة أن تجعلني سعيدة. لا.. لا.. أرغب في أن تجعل مني عاهرة.. اجعلني أشعر بك داخلي حتى الفجر".
كان الحديث عن العهر والفجر والسعادة والمفاجآت الجنسية كافيا ليقنعني بالخروج ربع ساعة وأعود. فقد كانت ليليا تفهم في تخيّلاتي التي كثيرا ما جسدتها معي، والتي كانت كلما رغبتْ في أن نكررها تجدني قد أبدعت تخيلات أخرى أكثر إمتاعا من الأولى.
وبعد ربع ساعة عدت. هذه المرة وجدتُني أمام باب مقفل. حاولت أن أهاتفها لتفتح لي ولكنها لم ترد، حتى يئست وعدت مكتئبا إلى غرفتي، وأنا ألعن اليوم الذي احتلمت فيه.
في الصباح. توجهت إلى أمانة الفندق وسألت عنها. أخبرني الأمين أنها غادرت ليلا ولكنها تركت لي مظروفا سلّمنيه. وحين هممت بالخروج رن هاتفي..
- ألو حبيبي.
- ليليا؟!.. أين أنت؟.
- في المطار، ستقلع الطائرة بعد ساعة. المهم، هل تسلّمت ما تركته لك.
- نعم ولكن..
- لا بأس إذن، نلتقي بعد شهرين.
- شهرين؟
- نعم، بعد شهرين نلتقي وفيهما حاول أن تتم العمل الذي كلفتك به.
- أي عمل؟
- أوه.. لم تفتح المظروف بعد. طيّب.. لا بأس، حين تفتحه ستفهم.. باي حبيبي.
وانقطع الخط.. تماما كما فعلت رغبتي
التعليق
سمير قسيمي روائي جزائري، نشر حتى الآن أربع روايات هي: «تصريح بالضياع» التي فازت بجائزة الهاشمي سعيداني للرواية، «يوم رائع للموت» الصادرة في لبنان عن الدار العربية للعلوم ناشرون، ومنشورات الاختلاف بالجزائر والتي وصلت إلى القائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية لعام2010، «هلابيل» الصادرة أيضا عن الدار العربية والإختلاف، وآخر كتاباته الروائية: «في عشق امرأة عاقر» الصادرة عن منشورات الإختلاف وجاءت في 215 صفحة.
جلستُ وليليا أنطون بشرفة كافيتيريا "ميلك بار" بعد أن انتظرتها قرابة الساعة ببهو فندق "ريجينا" حيث كانت تقيم. ففي صبيحة ذلك اليوم هاتفتني حوالي العاشرة تخبرني أنها وصلت الجزائر قادمة من بيروت وحجزت غرفة بالفندق، وأن علينا أن نلتقي حوالي الواحدة زوالا. لم تضف شيئا إلا أن الأمر مهم ولا يجب أن أتأخر عنها.
كانت ليليا ربّة عملي. هكذا أحبّ أن أعتبرها. تعارفنا منذ عشرة أعوام بالصدفة حين بعثت لدار نشرها مخطوطة رواية كتبتها. كنت وقتها في العشرين فحسب. ومع ذلك لم تكن تلك إلا واحدة من أربع روايات كتبتها في وقت سابق. ففي تلك السنة، شعرت أن المخطوطة التي أرسلتها إلى ليليا تستحق أن تنشر. لا أعرف سبب ذلك الشعور إلا اعتزازي بها، فهي لم تكن رغم ما اجتهدتُ في اختلاقه، إلا قصة حقيقية حدثت معي.
المهم، لم تمرّ ثلاثة أشهر حتى وصلني ردّ ليليا الذي يمكن أن أصفه بصفعة حررتني من أوهامي. كتبت تقول:
" عزيزي..
وصلت روايتك وعرضت على لجنة القراءة. وحتى لا أطيل عليك فقد كان رأيها سلبيا مشفوعا بما معناه أن ما قرأوه لا يمكن أن يعتبر نصا أدبيا أيا كان نوعه. وخشية من أن تكون اللجنة قد تشدّدت في معاييرها فقد قرأتها بدوري، ووجدت عند الانتهاء منها أن اللجنة كانت غاية في اللطف معك، حين لم توجه إليّ إنذارا بعدم قبول استلام أي عمل يحمل اسمك في العقدين القادمين على الأقل، فأنا ومع احترامي لحلمك في أن تكون روائيا، أنصحك قبل أن تبدأ في كتابة أي شيء تصفه بالرواية لاحقا، أن تقرأ جميع ما كُتب لحد الآن في هذا الفنّ. وحين تنتهي، فحاول ألا تجرؤ على القلم وتمهّل حتى تقرأ ما سيكتب في العشرين سنة القادمة. وبعدها سيكون من حقك تضييع وقت أيٍّ قارئ..
محبّتي الخاصة.
ليليا أنطون".
بمجرد أن قرأتها تملّكني الغضب. أخرجت ورقة وكتبت من دون أن أفكر:
"عزيزتي..
وصلني ردّك ورأيك في روايتي. ومع شكري الخالص لك على نصائحك الصادقة، لا يسعني إلا أن أصارحك بما لم يستطع أحد مصارحتك به من قبل. أقول لك بكل حب.. أنت عاهرة بحق.
محبتي المفرطة
سمير قسيمي".
ثم وضعت الرسالة في مظروف وأرسلتها إلى دار نشرها.
كان من الممكن أن ينتهي الأمر على هذا النحو. بل وكان يجدر به أن ينتهي هكذا، فمع مرور الوقت أتذكّر ما حدث فأضحك على نفسي، أوّلا لأنني حاولت أن أكون شخصا لم أكنه، وثانيا لأنني تجرّأت ووصفت سيدة مجتمع معروفة كليليا بالعاهرة. ولكن الأمر لم ينته عند هذا الحد، فقد وصلتني بعد أشهر رسالة أخرى من ليليا، تعتذر مني على تجرئها عليّ، وتنصحني، إثباتا لحسن ظنّها بي، بإعادة كتابة روايتي من جديد، مع وعد بنشرها إذا شعرت بوجود تحسّن فيها. وهكذا فعلت وأعدت كتابتها ستّ مرات وأرسلتها إليها. وبالفعل نشرتها ليليا حين رأت بأن النص أصبح قابلا للقراءة.
بعدها لم أنشر أيَّ عمل. حتى إنني لم أحاول كتابة أي شيء أدّعي لاحقا أنه رواية. واكتفيت بترجمة الأشعار وبعض القصص القصيرة. وحين بدأت أتحكّم أكثر في ناصية الترجمة خضت غمار الروايات المكتوبة بالفرنسية، وتخصّصت في بعض كتابها، حتى بدأت كبريات دور النشر العربية والفرنسية تستعين بخدماتي، لاسيما وأنني كنت أترجم من اللغتين العربية والفرنسية وإليهما أيضا.
لا أذكر أنّ هناك نصا جعلني أقضي فيه أكثر مما أُمهل نفسي لترجمته، إلا "الحكاّءة" لريماس إيمي ساك، الذي جعلني ألعن اليوم الذي تجرأت فيه على الترجمة. كان نصا معقدا، بحبكة لا يمكن القبض عليها، حتى الزمن فيه كان متشابكا، إلى درجة أنني كنت أضيع فيه من دون أن أعي حقا في أيّ شيء يخوض إيمي ساك: في واقع بطلته "الحكاءة" أم في خياله هو. ولكن باستثناء هذا النص، لم يعجزني أي عمل من أعماله، حتى تلك التي صنعت بريقه على غرار "انتحار"، "الجدار" و"رسل الحقيقة". لهذا اعتُبرتُ وقبل أن أبلغ الثلاثين من العمر متخصّصا في ترجمة أعمال ريماس إيمي ساك، حتى أنني ترجمتها أكثر من مرة وبمستويات أدبية مختلفة.
لن أدّعي بالطبع أن عالم الترجمة جعلني أرغب عن كتابة الرواية، لأن المسألة لم تكن تتعلق بالكتابة بقدر ما تعلقت بالشعور الملازم لها، فلقد أدركت من خلال محاولاتي اللاحقة لنشر روايتي الأولى أنني كاتب جيد. ومع ذلك كانت كتاباتي خالية من الشعور. وحين أقول ذلك فأنا أعني الهوس والجنون والرغبة والاندماج والإيمان.. كل الأحاسيس التي تتقمص الكاتب الحقيقيّ حين يشتغل على الكتابة.
هذا ما أخبرتُ به ليليا بعد أن توطدت علاقتي بها، رغم أنها استمرت تسألني مرارا أن أحاول من جديد. فقد كانت تشعر بأنها السبب في توقفي عن الحلم. ولعل شعورها بالذنب نحوي جعلنا نتقرب من بعضنا أكثر، ونمزج بتجرؤ كبير لاحقا بين علاقتنا المهنية وعلاقتنا الشخصية التي تطورت لتصبح "صداقة ببعض المنافع". منافع كنا نقطفها كلّما تواجدت ليليا في الجزائر لسبب أو لآخر، بحيث أمنع عنها شعور الغربة وتمنحني بالمقابل بعض ما يجعل الحياة قابلة للاحتمال. وفيما عدى تلك الساعات التي اعتدنا قضاءها معا مرة أو مرتين في السنة. لم نكن إلا صديقين يشغلنا الأدب عن الحياة، إلى درجة أنني كثيرا ما اعتبرت أن ما أقوم به من ترجمة وتصحيحات وملخصات لصالح ليليا ليس عملا بحدّ ذاته. ولولا الشيكات التي كانت تصلني بين الحين والآخر من دار نشرها، لاعتبرت الأمر تطوّعا يستحق مجانيته.
كانت ليليا تكبرني بنحو عشرين سنة. ومع ذلك لم أهتم يوما بهذا الفارق في العمر بسبب أننا كنا منسجمين على نحو كبير. ولو أنها لم تكن متزوجة لكنت فكرت في أن أعرض الزواج عليها، فكثيرا ما حلمت بأن تكون المرأة التي تقاسمني حياتي امرأة تفهم في الحرف. أما كيف يكون شكلها، فهذا أمر ما كان ليشغلني على الإطلاق، ما دمتُ أملك من الخيال ما يجعلني أعجنها على الشكل الذي أرغب فيه حتى وإن كانت تشبه الجاموس.
مهما يكن، كان أول سؤال طرحتُه على ليليا بمجرد أن طلبنا المشاريب "لماذا حجزت في فندق ريجينا ذي النجمتين ولمَ أصرّت أن نلتقي في شرفة كافيتيريا "ميلك بار" بالتحديد؟"، وهي التي أعرف ولعها بالفنادق الفخمة بكل ما فيها من ترف. ثم إنها لم تكن تعرف من العاصمة إلا موقع المطار وفندق "سان جورج" الذي اعتادت الحجز فيه، فكيف اكتشفت وجود فندق ريجينا هذا، وعرفت أسماء الشوارع المحيطة به. فبمجرد أن خرجنا من الفندق سألتني أن آخذها إلى "ميلك بار" ولكن عن طريق شارع "مصطفى بن بولعيد".
ابتسمت ليليا وقالت وكأنها لم تصغ إليّ: "آه.. كدت أنسى". ثم أشارت إلى النادل وطلبت فنجان قهوة إكسبريس ببعض ماء الزهر.
أدهشني أنها تطلب مثل هذا، وهي التي كثيرا ما عنّفتني على شرب القهوة. كانت تقول لي بالحرف الواحد "إنك يا حبيبي تشرب موتك سائلا". ولكن الذي أدهشني أكثر أن تطلب مع قهوتها قطرات ماء الزهر.
قلت مجددا: "تبدين مختلفة حبيبتي.". فأجابت بدلال: أتعتقد؟..
أدركت حينها أن تلك لم تكن ليليا التي عرفت من قبل. فقبل هذا اليوم كنت لأقسم أنه لا توجد في كل قواميس العالم أية كلمة من شأنها إذا نطقنا بها أن تظهر الأنثى في ليليا في غير أوقات الجنس. فلطالما كانت من النوع الصارم في أحاديثها حتى العاطفية. أما دلال المرأة الشرقية فلم يكن يظهر فيها إلا في ساعات حميمياتنا لا أكثر، فإذا انقضت ولو بدقيقة واحدة تعود لتتقمص جسد امرأة أعمال متأصلة في الحساب.
في الحقيقة، كان هذا ما أحببت في ليليا. أقصد قدرتها على الفصل بين رغباتها وحياتها العادية، والخوض فيهما بمنتهى الصدق. قدرة ما كنت لأحلم بامتلاكها حتى وإن تظاهرت بذلك، ليس خوفا من أي شيء، بل لأنني ومنذ وقت طويل أدركت في أي مجتمع أعيش. لهذا فضلت أن أختار لي وجه الرجل الطيّب، ذي الملامح الصبيانية البريئة، رغم أن في داخلي كانت براكين الرغبة لا تكفّ عن الثوران. ربما لم أكن في ذلك مختلفا عن سواي إلا في كوني لم أنافق نفسي كلّما واتتني الفرصة. وكانت ليليا فرصة جنسية جعلتني أرضى بالصوم لأشهر من دون أن تستثيرني أية أنثى.
قلت وأنا أرى ابتسامتها طافية على وجهها: "أكيد. أنت مختلفة اليوم. صبغت شعرك كما أرى. كنت أعتقد أنك تمقتين هذا اللون".
"كنت مخطئة فيما يبدو..".
قالت وهزت رأسها ليتدلى شعرها الأشقر المتموّج. لا أنكر أنني وددت لو فعلت هذا ونحن بمفردنا، فقد بدأتُ أشعر لحظتها أن عليّ أن أتدارك الأمر وأضع أي شيء على حجري. لطالما كان من المحرج أن يحدث لي مثل هذا في مكان عرضة للتلصص.
- أكيد.. كنتِ مخطئة بلا ريب..
قلت ومططت شفتيّ رغبة في ترطيبهما وقد جفّتا على حين غرة. ثم أضفت حين شعرت بأنها كانت تحاول بنظراتها أن تورطني مع رغبتي فيها:
- لم تخبريني عن سبب حجزك في هذا الفندق وجلوسنا هنا.
لم تجب واستمرّت في نظراتها إليّ. وما هي إلا دقائق حتى أدركتُ أن وضع شيء على حجري لم يعد أمرا يقبل التأجيل.
ومن دون أن ترتشف قهوتها، قامت ليليا من مكانها ومالت نحوي وكأنها كانت ستقبّلني. أحرجني الأمر أن تفعل ذلك في مثل هذا المكان. ولكنني في قرارة نفسي وددت لو أنها تفعل حقا، فتلامس شفتاها شفتيَّ وتدرك أيّ نار كانت تلتهمني ساعتها. ولكن ما أن بلغ فمها وجهي حتى همست لي "أنا في الغرفة 142، احجز لنفسك غرفة أيضا". وانصرفت من غير أن تلتفت.
لم أكن محتاجا إلى المزيد من التفكير لأوقن أن بليليا خطبا ما. ولكنني ومع كل ما كنت أقاومه لحظتها لم أفكر إلا في أن أجد أسرع طريقة تجعلني أخمد كل تلك البراكين التي ثارت داخلي في وقت واحد.
حين هدأت، دفعت الحساب وقمت مسرعا لألحق بليليا، ولكنها كانت قد سبقتني إلى الفندق بلا شك، فالوقت الذي استغرقته للهدوء كان كافيا لتبلغ الفندق وتصعد إلى غرفتها، ولربما أيضا لتستحم وتغير ثيابها. فلطالما كنت من النوع الذي يحتاج إلى الكثير من الوقت ليفرِّغ أولى حمولاته. ولعلّ من عرفنني من النساء كنّ يزددن فيّ غراما لهذا الأمر، أو لعله كان وحده ما يجعلهن يغرمن بي في الأصل.
ما أن دخلت الفندق وحجزت غرفة حتى هاتفت ليليا. وصفت لي موقع غرفتها. كانت في الطابق الثالث تطلّ على مبنى المركز الثقافي الفرنسي من الجهة الخلفية، ولكنها استمهلتني لما بعد العصر، فلم أجد بدّا من الموافقة. فقد كنت أعلم أن لليليا طقوسها في الجنس، فهي من النوع المرتاب في جسدها وأناقتها. وحين تواتيها مناسبة للمضاجعة لا تترك أي شيء للصدفة. ومع علمي بذلك وددت لو تخلصت من عاداتها تلك هذه المرة.. فقط هذه المرة إلى حين ترسي سفينتي، لئلا تغرق وتغرقني معها.
وكانت الثالثة والنصف مساء حين فكرتُ في الخروج لأقضي ما تبقى من الوقت في التسكّع. هكذا يمكنني احتمال وطأة الانتظار، ولكنني حين هممت بذلك هاتفتني ليليا لتخبرني أنها قريبا ستكون مستعدة، وأن موعد ما بعد العصر قد يتغير في أية لحظة. لذلك ألغيت فكرة الخروج وحاولت إلهاء نفسي بمشاهدة التلفاز حتى رنت الساعة الخامسة.
أمهلت ليليا نصف ساعة أخرى ولكنها لم تهاتفني، فخمّنت أنها ترغب في أن أهاتفها أنا وفعلت. لكن هاتفها بقي يرن من دون جواب لقرابة ربع الساعة. وحين يئست كلّمتني وادعت أنها كانت نائمة ولم تشعر بالوقت. لم أحاججها وانطلقت مهرولا إلى غرفتها.
دخلت وفي رأسي مشاريع أسرعها إنجازا ينتهي في منتصف الليل. ولكنني بمجرد أن تجاوزت عتبة الغرفة رأيتها واقفة بجانب السرير ذي المكانين في كامل أناقتها. قالت لحظة رأتني أنها فكرت في أن نتعشى أولا حتى لا نضطر للخروج ليلا. ومن دون أن تسمع رأيي، تجاوزتني ووضعت المفتاح في قفل الباب وأضافت "أسرع، دعنا نذهب لنعود بسرعة. لا تعلم كم اشتقت إليّك حبيبي".
هكذا خرجنا وقضينا ساعات بين عشاء لم أستلذه وأحاديث فارغة لم تكن لتهمني في شيء. ولعلّ أهم جملة قالتها في كل تلك السهرة، ما تعلقت برغبتها في أن نعود إلى الفندق لنكمل ما لم نبدأه في الأصل.
هذه المرّة صعدنا إلى غرفتها معا رغم ادعائنا أمام أمين الفندق أننا لا نعرف بعضنا كي لا يفكر في أي شيء بغيض، فالحبّ في هذا البلد –كالموت تماما- يحتاج لممارسته إلى وثيقة تجيزه. وبمجرد أن دخلنا، حتى تعرّت ليليا من كل شيء. قالت وهي تنزع آخر قطعة من لباسها: "ألم تلاحظ أيّ شيء؟".
قلت وأنا ألتصق بها: "هذا..". ووضعت يدي على عُنَّتها. ثم أضفت هامسا مدنيا شفتيّ من شحمة أذنها اليمنى: "أصبح زغب عنتك أشقر ومشذوبا على غير العادة". وطفقت أقبلها على رقبتها وهي تتأوّه وقد لفتني بساقها حتى سقطنا على السرير، أنا فوق وهي تحت. وحين هممت بأن أجعل المسألة أكثر عمقا دفعتني حتى تراجعت. قالت وهي ترمقني بنظرة داعرة: "انتظر حبيبي.. عندي لك مفاجأة". وقامت إلى حقيبتها وأخرجت سروالا داخليا أحمر اللون. لوّحت لي به من دون أن أتمكن من معرفة تفاصيله. أضافت بخفوت: "اقتنيته من باريس منذ أشهر وأنا أفكر فيك..". وبدلال أكثر: "دعني أرتديه لأجلك".
حركت رأسي موافقا، ثم استدرت لأتركها على راحتها ولكنها التصقت بي من خلف وهمست لي: "لا عزيزي.. تذهب إلى غرفتك وتعود بعد ربع ساعة. أكون فيها قد ارتديت هذا ومفاجأة أخرى لن تخطر على بالك. أريدك هذه الليلة أن تجعلني سعيدة. لا.. لا.. أرغب في أن تجعل مني عاهرة.. اجعلني أشعر بك داخلي حتى الفجر".
كان الحديث عن العهر والفجر والسعادة والمفاجآت الجنسية كافيا ليقنعني بالخروج ربع ساعة وأعود. فقد كانت ليليا تفهم في تخيّلاتي التي كثيرا ما جسدتها معي، والتي كانت كلما رغبتْ في أن نكررها تجدني قد أبدعت تخيلات أخرى أكثر إمتاعا من الأولى.
وبعد ربع ساعة عدت. هذه المرة وجدتُني أمام باب مقفل. حاولت أن أهاتفها لتفتح لي ولكنها لم ترد، حتى يئست وعدت مكتئبا إلى غرفتي، وأنا ألعن اليوم الذي احتلمت فيه.
في الصباح. توجهت إلى أمانة الفندق وسألت عنها. أخبرني الأمين أنها غادرت ليلا ولكنها تركت لي مظروفا سلّمنيه. وحين هممت بالخروج رن هاتفي..
- ألو حبيبي.
- ليليا؟!.. أين أنت؟.
- في المطار، ستقلع الطائرة بعد ساعة. المهم، هل تسلّمت ما تركته لك.
- نعم ولكن..
- لا بأس إذن، نلتقي بعد شهرين.
- شهرين؟
- نعم، بعد شهرين نلتقي وفيهما حاول أن تتم العمل الذي كلفتك به.
- أي عمل؟
- أوه.. لم تفتح المظروف بعد. طيّب.. لا بأس، حين تفتحه ستفهم.. باي حبيبي.
وانقطع الخط.. تماما كما فعلت رغبتي
التعليق
سمير قسيمي روائي جزائري، نشر حتى الآن أربع روايات هي: «تصريح بالضياع» التي فازت بجائزة الهاشمي سعيداني للرواية، «يوم رائع للموت» الصادرة في لبنان عن الدار العربية للعلوم ناشرون، ومنشورات الاختلاف بالجزائر والتي وصلت إلى القائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية لعام2010، «هلابيل» الصادرة أيضا عن الدار العربية والإختلاف، وآخر كتاباته الروائية: «في عشق امرأة عاقر» الصادرة عن منشورات الإختلاف وجاءت في 215 صفحة.
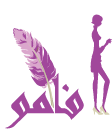

 من نحن
من نحن أشواك الورد
أشواك الورد قصاصات.كوم
قصاصات.كوم متابعات
متابعات فضاء للبوح
فضاء للبوح سرديات
سرديات قصائد
قصائد آراء حرة
آراء حرة في المرآة
في المرآة الأسوأ
الأسوأ دليل فامو
دليل فامو Boutique FaMoh
Boutique FaMoh Café FaMoh
Café FaMoh إتصل بنا
إتصل بنا