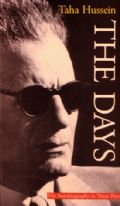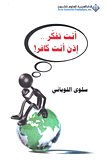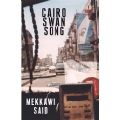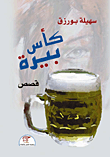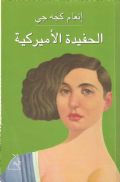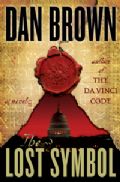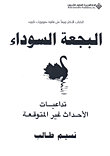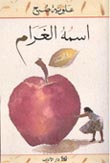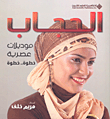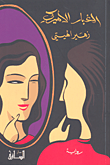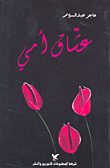الاهمية التي تقدمها الرواية تتجاوز جوانب الابداع الادبي وتصدر اوجهه الاكثر جذباً للجمهور قراءة ومتابعة وتمتعاً. فالرواية وعبر تنوع موضوعاتها, وكثافة أبعادها الاجتماعية والسياسية والثقافية, وجموح كتّابها توفر مسباراً بالغ العمق, واسع الانتشار, جريء المعالجة, لاختبار التحولات القائمة في مجتمع ما, او تلك الكامنة وقيد التحول. تماهي خيالات الروائيين مع اجزاء الواقع وتشظياته, وما يصلون إليه عبر هذا المزج المتواصل يضع كثيرين منهم في مقدم مستشرفي التحولات الكبرى في مجتمعاتهم. هناك امثلة عالمية عدة على النبوغ المدهش لكتابات ابداعية وفنية وروائيين مغامرين استشرفوا مستقبلات بلدانهم وتوقعوا مآلاتها في الوقت الذي نظر من حولهم إلى تلك التوقعات والتنبؤات بكونها تهويمات الكتاب وشطط خيالهم. في عام 1948 كتب الروائي البريطاني جورج اورويل, الذي بهرته الماركسية في شبابه, والذي انشق عنها لاحقاً, روايته الشهيرة التي كانت بعنوان 1984. عندها لم يتلاعب اورويل بأرقام السنوات وحسب متخيلاً اوضاع المجتمعات في كثير من الدول بعد اربعين سنة, بل كان يتنبأ بمصائر الانظمة الشمولية والديكتاتوريات الطاحنة للشعوب والناس وفردياتهم وطموحاتهم ومنظومات القيم التي تعودوا الحياة بها. تنبأ بفشل الشيوعية وسقوط فكرتها باكراً جداً في وقت كانت فيه في عز شبابها. عربياً وراهناً جداً, تتيح قراءة الروايات التي وصلت إلى القائمة القصيرة, وقبلها القائمة الطويلة, في مسابقة الجائزة العالمية للرواية العربية (أو «البوكر» العربية) لعام 2012, التقاط احدث الخطوط والمسارات التي يسير فيها الفن الروائي العربي واستغراقاته المختلفة. ومن هذه المسارات مسألة استشراف التحولات السياسية والاجتماعية في العالم العربي ومجتمعاته, بناء على اظلامات الواقع وانسداداته. ليس من مهمة الرواية, بطبيعة الحال, ان تتصدى لمهمة استنطاق المستقبل او تسطير تنبؤات كما لو انها جزء من حقل الدراسات المستقبلية. بل يمكن القول ان اي إطلالة مستقبلية في العمل الروائي ستبدو مفتعلة ما لم تأتِ في سياق تطور درامي مقنع وعفوي لا يربك النص ولا الفكرة الاساسية فيه. وإذا نجح العمل الدرامي في تضمين استنتاجات جانبية, تنبؤية واستشرافية على وجه التحديد, بسلاسة وعفوية وتناغم مع السرد والبنية العامة له, فإن قيمته تتضاعف, وتتجاوز به موقعه الادبي. في روايات جائزة «البوكر العربية» الفائزة لهذا العام، نقرأ نصوصاً كثيرها يرصد بدقة عيش ناس ومجتمعات ما قبل الثورات العربية, ذلك ان الروايات التي شاركت في مسابقة هذا العام نشرت جميعاً في 2010 او 2011, اي عشية الانتفاضات وربيعها. وتوقيت النشر هذا يوفر خاصية مميزة لروايات هذا العام تثير فضول الباحث للتنقيب في الاعمال الروائية والفنية الاخرى, التي صدرت قبيل اندلاع تلك الثورات. هناك ست روايات تمكنت من الوصول الى القائمة القصيرة، إثنتان من مصر, واثنتان من لبنان, وواحدة من تونس, وأخرى من الجزائر, ومن هذه القائمة سوف تفرز لجنة التحكيم الرواية الفائزة بالجائزة الاولى في شهر آذار (مارس) المقبل في ابو ظبي. فضاءات هذه الروايات تتنوع, ففيها متعة التاريخ ومآسيه, الحب وأحلامه الكسيرة, الشباب وطموحاته وإحباطاته, المرأة وتوقها الدائم الى التحرر من سلطة الذكورة, انتشار قيم جديدة في المجتمعات وأفول اخرى, تكرس الاستبداد والفساد, وهكذا. ليس من الإنصاف القول إن معظم هذه الروايات يندرج في هم المعارضة, وبالتالي الدعوة الى الثورة على الديكتاتورية, وتوقع الثورة او سواه. لو كان الامر كذلك لتورطت في التقريرية والتسييس المباشر والخطابة, وبالتالي لفقدت هذه الروايات سمات كثيرة من جوهرها وشكلها الابداعي الذي كان في الأساس جواز نسبتها الى التفوق والتميز, وهو المعيار الذي تعتمده لجان التحكيم في اختيار الاعمال الفائزة كل عام – اي القيمة الابداعية (وليس السياسية) فيها. هذه السطور تتوقف عند ما بعد القيمة الابداعية والادبية لهذه الاعمال, وتتأمل في موضوعين عريضين تعددت الاشارة اليهما مباشرة او مواربة كثيراً في فصول الروايات الفائزة, هما الانسداد السياسي والاجتماعي المطبق الذي يستلزم ثورات وانتفاضات, وتفاقم حالة التدين المهووس بالمظاهر على حساب الروحانية و «دين المعاملة». في «نساء البساتين» للروائي التونسي الحبيب السالمي نرافق استاذ الثانوية المقيم في باريس في زيارة صيفية طويلة إلى تونس زائراً بيت شقيقه وبعضاً من عائلته الكبيرة وأصدقائه. «توفيق» يأتي إلى حي «البساتين» بعد غياب سنوات طوال, ويريعه ان يرى الحي والناس الذين عرفهم طويلاً في الماضي يندرجون في نمط تديّن متسارع يركز على المظهر العام والتشاوف الجماعي: الحجاب, عدم المصافحة, صلاة الجمعة..., الخ, لكن من دون ان يخترق هذا التدين جوهر السلوك الفردي او حتى الجماعي: ديمومة النميمة, حب المظاهر والتنافس في الاستهلاك, الغدر, الكذب, الأحكام المُسبقة... الخ. «توفيق» الذي يحس بالغربة في تونس, يرصد ايضاً تدهور السياسة, وتأزم المجتمع, والرغبة الجامحة عند الجميع للهجرة, وبخاصة الشباب. «حي البساتين» ونساؤه ورجاله شريحة ممثلة لتونس المأزومة التي تواجه انسدادات في كل المجالات, ولو لم تقم الثورة التونسية، فإن قارئ الرواية سوف يقترح ان الخروج من تلك الانسدادات لا يتم إلا بثورة. ليس بعيداً من ذلك الجو الذي يرسمه الروائي المصري ناصر عراق, عن مصر في روايته «العاطل». هنا نرى مصر التحتانية, الضواحي المعدمة في القاهرة, ومراهقيها الذين يأملون في الالتحاق بالجامعة لنفض الارتباط الابدي بالفقر والعوز والانشداد إلى اسفل. بطلنا هنا, المقموع من أبيه ومجتمعه الصغير, ضعيف الشخصية دوماً, يلتحق بالجامعة ويتخرج فيها ولا يجد سوى عمل كنادل في مقهى يقدم الشاي وجمر الشيشة للزبائن. في خلفية المشهد نتابع مجتمعاً محبطاً, وشرائح اجتماعية متشظية بين مطاردة الرغيف وبين ما يطاردها من مشاهد تديّن زاحف. الناشطون السياسيون في الجامعة, اصحاب مشاريع التغيير الكبرى, يتسربون واحداً تلو الآخر الى الخارج, يبحثون عن العمل. تتراكم احباطات خريج الجامعة في العمل والحياة, والحب والجنس, ثم يساعده شقيقه للوصول الى دبي والعمل في سوبرماركت. هناك يكتشف عجزه الجنسي وعدم قدرته على مواجهة أية امرأة. في غياب المرأة تلتهب خيالاته الجنسية ويمتلك قدرته كاملة, اما عند حضورها فكل ذلك يختفي فجأة, ويصبح هو وعضوه «عاطلين». في تحليل العجز الجنسي الذي اذهله نكتشف ان جذوره قابعة في القمع الاجتماعي والعائلي الذي تعرض له. في «دمية النار» للروائي الجزائري بشير مفتي غوص تخيلي مذهل في تراتبية السلطات الخفية في الجزائر منذ نهايات عهد هواري بومدين, ثم عقد الثمانينات, وانفجار التيار الاسلامي ومعه الحرب الاهلية. يرسم لنا مفتي صورة لسلطة موازية للحكومة والنظام, هي منه وتحميه, لكنها اقوى نفوذاً منه, وهي عملياً من يدير المشهد السياسي برمته. هذه «الجماعة» هدفها البقاء في القمة والسيطرة على الجميع والتمتع بالنفوذ والثروات. ومن اجل هذا هي مستعدة لافتعال وإدارة حرب اهلية, لدفع الجماعات المسلحة الى الواجهة, ثم تنفيس الشعب من أية احتمالات للثورات. بعد الحرب الاهلية الطويلة والدموية يقول احد الجنرالات: نجحنا, فالآن انتهت طاقة الشعب في ان يقوم بأية ثورة ضدنا. «عناق عند جسر بروكلين» للروائي المصري عز الدين شكري فيشر تأخذنا إلى اميركا وأوروبا, ويظل أبطالها مرتبطين ذهاباً وإياباً من مصر وإليها. بروفسور مصري متفوق في جامعة نيويورك, سئم الاحباط العلمي وانسداد الفرص في القاهرة بعدما عاد إليها يحمل الدكتوراة في التاريخ من جامعة لندن. في نيويورك يندمج في الحياة وينجح. هو النقطة لشبكة من العلاقات العائلية والاجتماعية التي نلاحقها حوله: زوجتاه, ابناؤه, تلامذته, احباؤه, خصومه. حيوات هؤلاء جميعاً نرصدها وهم في طريقهم لحضور حفلة عيد ميلاد لحفيدته التي قصد منها لقاءهم جميعاً قبل موته المحقق بالسرطان. في الرصد التفصيلي المثير لرحلة قدومهم الى الحفل يسترجع كل منهم حياته وإحباطاته وهروبه من بلده, تحول بعضهم الى مندمج «متأمرك» وآخر إلى اصولي في قلب نيويورك يفرح لعملية تفجير البرجين في 11 أيلول (سبتمبر). ربيع جابر الذي ادهشنا في روايته «اميركا» قبل عامين وانضمت الى اللائحة القصيرة لجائزة «البوكر» آنذاك, يدهشنا ثانية في عمل بديع بعنوان «دروز بلغراد». يتحدث عن نفي الحاكم التركي لمئات من الدروز إلى البلقان بسبب القتل الذي ارتكبوه ضد المسيحيين خلال الخصومات الاهلية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر في جبل لبنان. مع اولئك الدروز المنفيين يتم بالخطأ نفي حنا يعقوب, شاب مسيحي بسيط يعمل بائعاً للبيض المسلوق, حديث الزواج, وحدث أن كان قريباً من المرفأ لحظة تنفيذ النفي. رحلة النفي نفسها في بلاد البلقان والبلغار وتشتت اولئك المئات في قلاع بلغراد والهرسك وبرشتينا, والعذاب المذهل الذي واجهوه يصوره جابر بإبداع, وفي خلفية ذلك كله نرقب انهيار الدولة العثمانية, تمردات الصرب وثوراتهم, صعود القوى الاوروبية, وارتباط ذلك كله بفسيفساء الطوائف في جبل لبنان. الرواية اللبنانية الاخرى الفائزة في القائمة القصيرة هي «شريد المنازل» لجبور الدويهي, وهي عمل فني رفيع يصور طحن الهويات القاتلة في لبنان الحرب الاهلية في السبعينات. نظام العلمي طفل لعائلة مسلمة من طرابلس يتربى مع زوجين مسيحيين لا ينجبان, ومع السنوات تصبح الهوية الدينية لهذا الشاب ملتبسة لكنه مرتاح بها, هو مسلم ومسيحي في آن. لكن مع قدوم نذر الحرب الاهلية والقتل الذي انتشر على الهوية، تتحول هوية نظام الى لعنة, اذ يصبح غير معترف به من الجانبين. ينخرط على هوامش عمل حزبي شيوعي لا يعترف بكل تلك الهويات فيحب أجواءه, لكنه يكون غارقاً في قصة حب خاصة به, وغير منجذب للسياسة والنضال اساساً. «شريد المنازل» هو شريد الهويات في مجتمعات مهجوسة بها ومتوترة. * خالد حروب : محاضر وأكاديمي - جامعة كامبردج, بريطانيا khaled.hroub@yahoo.com نقلا عن الحياة اللندنية
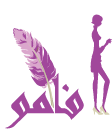

 من نحن
من نحن أشواك الورد
أشواك الورد قصاصات.كوم
قصاصات.كوم متابعات
متابعات فضاء للبوح
فضاء للبوح سرديات
سرديات قصائد
قصائد آراء حرة
آراء حرة في المرآة
في المرآة الأسوأ
الأسوأ دليل فامو
دليل فامو Boutique FaMoh
Boutique FaMoh Café FaMoh
Café FaMoh إتصل بنا
إتصل بنا
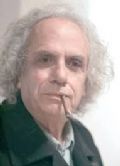













































.JPG)




















.JPG)






















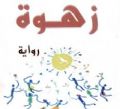














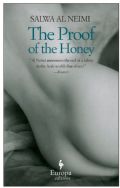




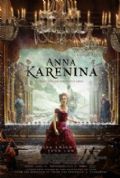
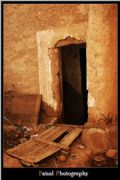


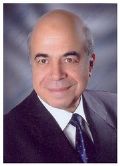





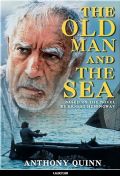






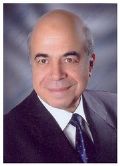

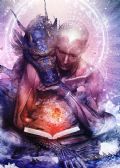




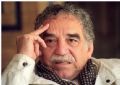

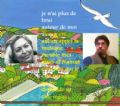





.jpg)












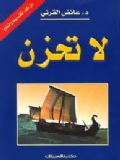








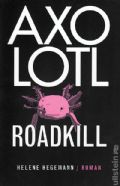






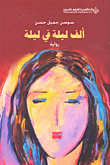

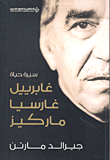
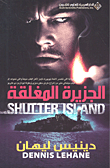
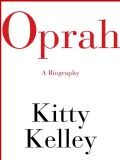
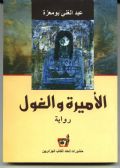




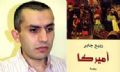
.jpg)