سرديات عودة
من رواية " سرمدة" للروائي السوري فادي عزام (السبت 9 حزيران 2012)
سؤادة
لم يكن بها شيء يلفت الانتباه، أصلا لم أنتبه لها، حتى عرَّفني صديقي بالعربية إلى رجل من سورية يقف إلى جوارها ، تبادلنا المجاملات العادية لأهل البلد الواحد حين يلتقيان في الغربة. مجاملات متحفظة ومشكوك بنواياها.
سألني من أين؟ قلت: من الجبل.
وحين استوضح من أيّ مكان في الجبل، أجبت: سؤادة !!
وما أن لفظتُ: إني من بلدة سؤادة، حتى استدارت إلينا وكأن للكلمة وقعاً خاصاً عليها. رمقتني بتلك النظرة المحيرة، واعتذرت لاقتحامها تعارفنا.
- هل قلت إنك من سؤادة؟
أجبت بهدوء الحائر:
- نعم، هل تعرفين أحداً منها؟
تساءلت وأنا أحاول تقصي نظرات هذه السيدة الأربعينية، المرتدية فستانا أسودَ مطرّزاً بخرز لمّاع، ومن نفس اللون، وقد استدارت إلينا فجأة وشاركتنا الحديث.
ابتسمت بهدوء.
- غريب أن التقي أحداً من سؤادة في باريس. هل تقيم هنا؟
- لا أبداً، في زيارة عمل سريعة، سأسافر غداً.
- كيف سؤادة؟ كيف أحوالها؟ سألتني بلهفة.
- بخير .. !
قاطعني تصفيق حادٌّ اندلع في القاعة حين دخل إعلامي فرنسي بارز، ليبدأ حفل تكريمه في معهد العالم العربي. غاب صوتها، وتقدم منها أحد الكهول المتأنقين يحثها على إنهاء المحادثة والاهتمام بالحفل. وقبل أن تغادر قالت:
- اسمي عزة توفيق.. معك قلم؟
فتشت جيوبي فلم أجد. استعارت واحداً من الرجل الكهل المتأنق الرصين، وهو يرمقني بنظرات باردة. خطّت رقم هاتف على محرمة كلينكس. أعطتني إياها، وعينها الفاحصة تعج بكلام كثير.
- اتصل بي، ضروري.. وغابت في زحمة الاحتفال.
كان المكان مكتظاً، والكل يتكلم الفرنسية التي لا أفهمها. تسللت خارجاً بهدوء.
مشيت بمحاذاة السين، بخطوات بطيئة. كيف أعادت هذه المرأة سؤادة دفعة واحدة إلى رأسي؟ فهذا الحنين الفارغ لم يستطع يوما أن ينال مني. تحصّنت ضده منذ خروجي قبل سنوات طويلة من بلادة الفراغ. ومطحنة الأعمار ولزوجة الانتظار لما لا يأتي.
لم تكن سؤادة بالنسبة لي سوى مكان أجوف مررت به. عشت فيه مرارة أيامي، دمغني بالألم والخوف والخفوت. احتجت لسنوات لأخرج منه وأخرجه مني.
لكن الآن على ضفة "السين" كان ثمة شيء مختلف يبرق في داخلي. ويجعل سؤادة تعود إلي.
أو لأقل ما تبقى منها: بضعة وجوه مغبرة وذاكرة بلا ملح التذكر. بلا طعم ما أو مذاق يثير الشوق لأي أحد. ومع خطواتي المتسارعة كنت أقع في حيرة الممسوس بلوثة نقاء مباغتة.
كيف يمكن أن ينكر المرء منبته أو يحاول التخلص منه، التنصل من وعثائه؟ بدأ الأمر مثل وكسة في حمأة طين لزج.
دخلت فندق "ألبا" في سان ميشيل. الساعة تجاوزت الحادية عشرة. جهزت حقيبتي. أخذت حماما دافئا، وابتلعني النوم.
كنت نشيطاً تماماً بعد ليلة نوم مذهلة. نزلت إلى الاستقبال، تناولت فطوري، وحاسبت وأنهيت إجراءات الإقامة. وضعت حقيبتي في غرفة الأمانات، واتصلت بها. صوت من الطرف المقابل ما زال مغموساً بالنعاس مشبعاً بالأنوثة.
- أنا رافي عزمي.
- مين؟
- التقينا البارحة في تكريم الأستاذ "ألان غيوش" وأعطيتني رقمك.
شيء ما مسها من جديد، فانتعش صوتها.
- أهلا أهلا، أين نتقابل ومتى؟
- طائرتي ستقلع اليوم مساء من شارل ديغول. الآن إذا لم تكوني مشغولة.
- لا.. أوكي، أين أنت؟
- مقهى " لي ديبار" سان ميشيل.
- نصف ساعة وأكون هناك.
كان يومي الأخير في باريس، وبعدها حيث علي السفر إلى دمشق لمتابعة أبحاثي عن الفيلم الوثائقي الخاص بالحجاب، فعملي كمعد ومنتج للفيلم، يستدعي مني السفر إلى مجموعة من البلدان لتهيئة وإعداد المقابلات والتصوير. من الجيد أنني قد أنهيت كل الأعمال البارحة، وختمت يومي بالذهاب إلى حفل تكريم لإعلامي معروف بمساندته للقضايا العربية، دعاني إليها صديق من أيام الجامعة، فقابلت هذه السيدة.
على الطاولة الموجود في الزاوية المقابلة لمكتبة "جلبرت" جلسنا.
العينان البنيتان الواسعتان، فيهما جدية صارمة، وحزن هامس، ومسحة من النبل تعتلي معالم هذه السيدة ذات اللهجة اللبنانية.. بعد بضع كلمات قالت؟
- أنا من الشوف، ولي أقارب في سؤادة.
- أه، إذاً هذا يفسر كل شيء. أجبتها وأضفت بمثاقفة واستعراض:
- يعني نستولوجيا الطائفة.
- لا أبداً، الموضوع غير هذا.
وصمتت قليلاً، ثم ثبتت نظرتها علي وقالت بجدية تامة:
- أنا - في حياتي السابقة - عشت في سؤادة. إذا كنت تؤمن بالتقمص أو سمعت عنه، راح تفهم ماذا أقصد!
لم أجب، كنت مصعوقاً بدهشة مباغتة. صحيح أنني نشأت وتربيت في جو يعتبر التقمص جزءاً لا يتجزأ من الإيمان العام، ويضج بحكايات لمتقمصين يروون قصصاً تتراوح بين التسلية الساذجة وتهويل المبالغة، لإثبات حقيقة تميز (الدروز) كفرقة ناجية تمتلك الحقيقة المطلقة وحدها، وتؤثر نقاء الدم والسلالة. ولكني في حياتي كلها، لم أعر هذا الموضوع اهتماماً، وأعتبره واحدة من الشطحات الدينية الجميلة التي تحفل بها سوريا.
تابعت السيدة كلامها بثقة وهي تقول:
- أنا متُّ قتلاً، الساعة الرابعة والنصف مساء يوم الثلاثاء الأول من شهر كانون أول عام 1968. اسمي في حياتي السابقة (هيلا منصور)، (وبعدني بتذكر الكثير من حياتي الماضية و - إذا بدّك - الكثير من تفاصيل أخر ساعتين ونص من عمري) أراها بكل وضوح وكأن الأمر حدث البارحة.
فغرت فمي أطالع وجه هذه السيدة الذي تعكر بفعل حديثها الغامض.
- بصراحة لا أعرف ماذا أقول: ولكني حقيقة، لا أؤمن بالتقمص، وإنْ شئت أكثر. لا أؤمن إلا بالعقل والعلم، وأعتبر حكايات التقمص من الذاكرة الاسترجاعية. يعني من يتذكر حياته الماضية يتذكر بضعة أحداث بسيطة عامة.
وحاولت أن أضيف إلى حديثي نكهة العارف الثقيل الوزن، ولكن شيئاً ما في نظراتها، مع ابتسامة ساخرة منها، أوقف منطقي البارد.
- اسمع يا أستاذ رافي: أنا (برفسورة) في مكانيك الكم. أدرّس في (السوربون)، وموضوع الدكتوراة الخاص بي، يعتمد على تطوير نظرية (الشاوش)، (وأضافت متهكمة ): إذا كنت سمعت بها.
وها أنا أقول لك: إني عشت سابقاً، وقتلت على يد أشقائي.. أريد أن أسألك عنهم: كيف هم، وما هي أحوالهم؟ وقبل هذا وذاك لا يهمني كل منطق العلم في حياتي الخاصة. وما سأقوله لك الآن لم أروه سابقاً، كما سأرويه لك، ودعني أستشهد بمقولة (أنشتاين): (إذا لم يوافق الواقعُ النظريةَ، غيِّر الواقع).
عقبت على حديثها متهكماً بنفس النبرة:
- يعني تملكين نظرية عن التقمص!
- لا أبداً، فغروري الشخصي وعقلي البارد كانا يرفضان دائماً الاعتراف بحياتي السابقة. ثم إني لا أستطيع إثبات ذلك بالعلم. ولكنّ حقيقةً أدركها بداخلي وتعيش معي، تجعلني أحمل حياتين على الأقل، وهذا الأمر لم يعد يزعجني وبخاصة أنني بت أرى الأشياء بصورة أوضح أقلّ حدّة. وعلى كلٍّ، (أنشتاين) -أيضاً- يقول:
"الخيال أهم من المعرفة، لأن المعرفة لها حدود".
أسعفتني ذاكرتي بعبارة للمدعو (أنشتاين) أضفتها إلى الحديث -ليس رغبة بالمناكفة- إنما، ربما للمشاركة أو الاستعراض.
- "الحقيقة ليست سوى وهم، لكنه وهم ثابت".
وأردفت مشاكساً:
- وعملياً، الوهم الثابت خير من خيال عابث.
كنت أشعر بأن أحداً يريد خلخلة مسلماتي، وإعادتي إلى مرحلة قلق كبير تخلصت منه منذ زمن طويل دفعة واحدة؛ فلا الله ولا شعوذات الآخرة ولا كل ما ينتجه الدين، يمكن له أن يهزني أو يشغلني مرة أخرى؛ ولكنها قطعت علي محاكمتي الصامتة لنفسي، مستشهدة بـ (بعبقري النسبية) أيضا، تستحضره بانسياب العارف:
- كلما اقتربت القوانين من الواقع، أصبحت غير ثابتة، وكلما اقتربت من الثبات، أصبحت غير واقعية.
تراجعت أمام هذا الحزم المباغت. وبصراحة، أصلا لم يكن أحد في العالم يستطيع دحض الثقة والحزن في عيني هذه السيدة الجميلة.
كانت تسأل عن تفاصيل في البلدة، عن أناس أعرف بعضهم، وآخرين سمعت بهم، وقلة لا أعرفهم أبدا.
ورويداً رويداً بدأنا نستعيد معا المكان. نروي حكايته ونحضر أناسه هنا إلى هذا المقهى الباريسي، وصار الحديث أليفاً فيه الكثير من الفرح الغامض. كنت محتاجاً فعلا إلى هذه السيدة لأستطيع رؤية البلدة التي نشأت فيها وغادرتها منذ سنوات طويلة، ولا تعدو بالنسبة لي سوى مكان ضيق أحبّ زيارته كل بضعة أعوام لألتقي أهلي وما تبقى من أصدقائي، وأغادر على عجل.
مرت الساعات الستّ بسرعة، وكان علي أن أغادر. أخبرتها أنني سأعود بعد شهر ونصف للتصوير في باريس. وسأكون سعيداً إن نلتقي مرة أخرى.
حضنتني وقبلتني على وجنتي. كان شعورنا، أننا نعرف بعضنا منذ زمن طويل. تمنت لي السلامة، وكنت كمن أودع أحداً من عائلتي .
في الطائرة، وعلى مدى خمس ساعات ونصف، لم تبارح حكاية السيدة عزة توفيق رأسي؛ بالطبع لم أصدق حرفا واحدا مما حكته، ولكن ثمة مسّ من الرأفة والحزن يجعلني أتنازل عن برودة عاطفتي، ويتلبسني شوق حار بدأ ينمو. في داخلي، لأول مرة مذ غادرت سؤادة قبل سنوات عديدة. شيء ما حدث فيّ، لحظة إشراق أو كشف تشعرني أنني شخص آخر. أخرجت دفتر ملاحظاتي. وبدأت أدون - ولا أريد أن أقول أكتب - حكاية عزة توفيق أو هيلا منصور.
سرمدة صدرت عن الدار العربية للعلوم ناشرون - بيروت 2011
التعليق
سؤادة
لم يكن بها شيء يلفت الانتباه، أصلا لم أنتبه لها، حتى عرَّفني صديقي بالعربية إلى رجل من سورية يقف إلى جوارها ، تبادلنا المجاملات العادية لأهل البلد الواحد حين يلتقيان في الغربة. مجاملات متحفظة ومشكوك بنواياها.
سألني من أين؟ قلت: من الجبل.
وحين استوضح من أيّ مكان في الجبل، أجبت: سؤادة !!
وما أن لفظتُ: إني من بلدة سؤادة، حتى استدارت إلينا وكأن للكلمة وقعاً خاصاً عليها. رمقتني بتلك النظرة المحيرة، واعتذرت لاقتحامها تعارفنا.
- هل قلت إنك من سؤادة؟
أجبت بهدوء الحائر:
- نعم، هل تعرفين أحداً منها؟
تساءلت وأنا أحاول تقصي نظرات هذه السيدة الأربعينية، المرتدية فستانا أسودَ مطرّزاً بخرز لمّاع، ومن نفس اللون، وقد استدارت إلينا فجأة وشاركتنا الحديث.
ابتسمت بهدوء.
- غريب أن التقي أحداً من سؤادة في باريس. هل تقيم هنا؟
- لا أبداً، في زيارة عمل سريعة، سأسافر غداً.
- كيف سؤادة؟ كيف أحوالها؟ سألتني بلهفة.
- بخير .. !
قاطعني تصفيق حادٌّ اندلع في القاعة حين دخل إعلامي فرنسي بارز، ليبدأ حفل تكريمه في معهد العالم العربي. غاب صوتها، وتقدم منها أحد الكهول المتأنقين يحثها على إنهاء المحادثة والاهتمام بالحفل. وقبل أن تغادر قالت:
- اسمي عزة توفيق.. معك قلم؟
فتشت جيوبي فلم أجد. استعارت واحداً من الرجل الكهل المتأنق الرصين، وهو يرمقني بنظرات باردة. خطّت رقم هاتف على محرمة كلينكس. أعطتني إياها، وعينها الفاحصة تعج بكلام كثير.
- اتصل بي، ضروري.. وغابت في زحمة الاحتفال.
كان المكان مكتظاً، والكل يتكلم الفرنسية التي لا أفهمها. تسللت خارجاً بهدوء.
مشيت بمحاذاة السين، بخطوات بطيئة. كيف أعادت هذه المرأة سؤادة دفعة واحدة إلى رأسي؟ فهذا الحنين الفارغ لم يستطع يوما أن ينال مني. تحصّنت ضده منذ خروجي قبل سنوات طويلة من بلادة الفراغ. ومطحنة الأعمار ولزوجة الانتظار لما لا يأتي.
لم تكن سؤادة بالنسبة لي سوى مكان أجوف مررت به. عشت فيه مرارة أيامي، دمغني بالألم والخوف والخفوت. احتجت لسنوات لأخرج منه وأخرجه مني.
لكن الآن على ضفة "السين" كان ثمة شيء مختلف يبرق في داخلي. ويجعل سؤادة تعود إلي.
أو لأقل ما تبقى منها: بضعة وجوه مغبرة وذاكرة بلا ملح التذكر. بلا طعم ما أو مذاق يثير الشوق لأي أحد. ومع خطواتي المتسارعة كنت أقع في حيرة الممسوس بلوثة نقاء مباغتة.
كيف يمكن أن ينكر المرء منبته أو يحاول التخلص منه، التنصل من وعثائه؟ بدأ الأمر مثل وكسة في حمأة طين لزج.
دخلت فندق "ألبا" في سان ميشيل. الساعة تجاوزت الحادية عشرة. جهزت حقيبتي. أخذت حماما دافئا، وابتلعني النوم.
كنت نشيطاً تماماً بعد ليلة نوم مذهلة. نزلت إلى الاستقبال، تناولت فطوري، وحاسبت وأنهيت إجراءات الإقامة. وضعت حقيبتي في غرفة الأمانات، واتصلت بها. صوت من الطرف المقابل ما زال مغموساً بالنعاس مشبعاً بالأنوثة.
- أنا رافي عزمي.
- مين؟
- التقينا البارحة في تكريم الأستاذ "ألان غيوش" وأعطيتني رقمك.
شيء ما مسها من جديد، فانتعش صوتها.
- أهلا أهلا، أين نتقابل ومتى؟
- طائرتي ستقلع اليوم مساء من شارل ديغول. الآن إذا لم تكوني مشغولة.
- لا.. أوكي، أين أنت؟
- مقهى " لي ديبار" سان ميشيل.
- نصف ساعة وأكون هناك.
كان يومي الأخير في باريس، وبعدها حيث علي السفر إلى دمشق لمتابعة أبحاثي عن الفيلم الوثائقي الخاص بالحجاب، فعملي كمعد ومنتج للفيلم، يستدعي مني السفر إلى مجموعة من البلدان لتهيئة وإعداد المقابلات والتصوير. من الجيد أنني قد أنهيت كل الأعمال البارحة، وختمت يومي بالذهاب إلى حفل تكريم لإعلامي معروف بمساندته للقضايا العربية، دعاني إليها صديق من أيام الجامعة، فقابلت هذه السيدة.
على الطاولة الموجود في الزاوية المقابلة لمكتبة "جلبرت" جلسنا.
العينان البنيتان الواسعتان، فيهما جدية صارمة، وحزن هامس، ومسحة من النبل تعتلي معالم هذه السيدة ذات اللهجة اللبنانية.. بعد بضع كلمات قالت؟
- أنا من الشوف، ولي أقارب في سؤادة.
- أه، إذاً هذا يفسر كل شيء. أجبتها وأضفت بمثاقفة واستعراض:
- يعني نستولوجيا الطائفة.
- لا أبداً، الموضوع غير هذا.
وصمتت قليلاً، ثم ثبتت نظرتها علي وقالت بجدية تامة:
- أنا - في حياتي السابقة - عشت في سؤادة. إذا كنت تؤمن بالتقمص أو سمعت عنه، راح تفهم ماذا أقصد!
لم أجب، كنت مصعوقاً بدهشة مباغتة. صحيح أنني نشأت وتربيت في جو يعتبر التقمص جزءاً لا يتجزأ من الإيمان العام، ويضج بحكايات لمتقمصين يروون قصصاً تتراوح بين التسلية الساذجة وتهويل المبالغة، لإثبات حقيقة تميز (الدروز) كفرقة ناجية تمتلك الحقيقة المطلقة وحدها، وتؤثر نقاء الدم والسلالة. ولكني في حياتي كلها، لم أعر هذا الموضوع اهتماماً، وأعتبره واحدة من الشطحات الدينية الجميلة التي تحفل بها سوريا.
تابعت السيدة كلامها بثقة وهي تقول:
- أنا متُّ قتلاً، الساعة الرابعة والنصف مساء يوم الثلاثاء الأول من شهر كانون أول عام 1968. اسمي في حياتي السابقة (هيلا منصور)، (وبعدني بتذكر الكثير من حياتي الماضية و - إذا بدّك - الكثير من تفاصيل أخر ساعتين ونص من عمري) أراها بكل وضوح وكأن الأمر حدث البارحة.
فغرت فمي أطالع وجه هذه السيدة الذي تعكر بفعل حديثها الغامض.
- بصراحة لا أعرف ماذا أقول: ولكني حقيقة، لا أؤمن بالتقمص، وإنْ شئت أكثر. لا أؤمن إلا بالعقل والعلم، وأعتبر حكايات التقمص من الذاكرة الاسترجاعية. يعني من يتذكر حياته الماضية يتذكر بضعة أحداث بسيطة عامة.
وحاولت أن أضيف إلى حديثي نكهة العارف الثقيل الوزن، ولكن شيئاً ما في نظراتها، مع ابتسامة ساخرة منها، أوقف منطقي البارد.
- اسمع يا أستاذ رافي: أنا (برفسورة) في مكانيك الكم. أدرّس في (السوربون)، وموضوع الدكتوراة الخاص بي، يعتمد على تطوير نظرية (الشاوش)، (وأضافت متهكمة ): إذا كنت سمعت بها.
وها أنا أقول لك: إني عشت سابقاً، وقتلت على يد أشقائي.. أريد أن أسألك عنهم: كيف هم، وما هي أحوالهم؟ وقبل هذا وذاك لا يهمني كل منطق العلم في حياتي الخاصة. وما سأقوله لك الآن لم أروه سابقاً، كما سأرويه لك، ودعني أستشهد بمقولة (أنشتاين): (إذا لم يوافق الواقعُ النظريةَ، غيِّر الواقع).
عقبت على حديثها متهكماً بنفس النبرة:
- يعني تملكين نظرية عن التقمص!
- لا أبداً، فغروري الشخصي وعقلي البارد كانا يرفضان دائماً الاعتراف بحياتي السابقة. ثم إني لا أستطيع إثبات ذلك بالعلم. ولكنّ حقيقةً أدركها بداخلي وتعيش معي، تجعلني أحمل حياتين على الأقل، وهذا الأمر لم يعد يزعجني وبخاصة أنني بت أرى الأشياء بصورة أوضح أقلّ حدّة. وعلى كلٍّ، (أنشتاين) -أيضاً- يقول:
"الخيال أهم من المعرفة، لأن المعرفة لها حدود".
أسعفتني ذاكرتي بعبارة للمدعو (أنشتاين) أضفتها إلى الحديث -ليس رغبة بالمناكفة- إنما، ربما للمشاركة أو الاستعراض.
- "الحقيقة ليست سوى وهم، لكنه وهم ثابت".
وأردفت مشاكساً:
- وعملياً، الوهم الثابت خير من خيال عابث.
كنت أشعر بأن أحداً يريد خلخلة مسلماتي، وإعادتي إلى مرحلة قلق كبير تخلصت منه منذ زمن طويل دفعة واحدة؛ فلا الله ولا شعوذات الآخرة ولا كل ما ينتجه الدين، يمكن له أن يهزني أو يشغلني مرة أخرى؛ ولكنها قطعت علي محاكمتي الصامتة لنفسي، مستشهدة بـ (بعبقري النسبية) أيضا، تستحضره بانسياب العارف:
- كلما اقتربت القوانين من الواقع، أصبحت غير ثابتة، وكلما اقتربت من الثبات، أصبحت غير واقعية.
تراجعت أمام هذا الحزم المباغت. وبصراحة، أصلا لم يكن أحد في العالم يستطيع دحض الثقة والحزن في عيني هذه السيدة الجميلة.
كانت تسأل عن تفاصيل في البلدة، عن أناس أعرف بعضهم، وآخرين سمعت بهم، وقلة لا أعرفهم أبدا.
ورويداً رويداً بدأنا نستعيد معا المكان. نروي حكايته ونحضر أناسه هنا إلى هذا المقهى الباريسي، وصار الحديث أليفاً فيه الكثير من الفرح الغامض. كنت محتاجاً فعلا إلى هذه السيدة لأستطيع رؤية البلدة التي نشأت فيها وغادرتها منذ سنوات طويلة، ولا تعدو بالنسبة لي سوى مكان ضيق أحبّ زيارته كل بضعة أعوام لألتقي أهلي وما تبقى من أصدقائي، وأغادر على عجل.
مرت الساعات الستّ بسرعة، وكان علي أن أغادر. أخبرتها أنني سأعود بعد شهر ونصف للتصوير في باريس. وسأكون سعيداً إن نلتقي مرة أخرى.
حضنتني وقبلتني على وجنتي. كان شعورنا، أننا نعرف بعضنا منذ زمن طويل. تمنت لي السلامة، وكنت كمن أودع أحداً من عائلتي .
في الطائرة، وعلى مدى خمس ساعات ونصف، لم تبارح حكاية السيدة عزة توفيق رأسي؛ بالطبع لم أصدق حرفا واحدا مما حكته، ولكن ثمة مسّ من الرأفة والحزن يجعلني أتنازل عن برودة عاطفتي، ويتلبسني شوق حار بدأ ينمو. في داخلي، لأول مرة مذ غادرت سؤادة قبل سنوات عديدة. شيء ما حدث فيّ، لحظة إشراق أو كشف تشعرني أنني شخص آخر. أخرجت دفتر ملاحظاتي. وبدأت أدون - ولا أريد أن أقول أكتب - حكاية عزة توفيق أو هيلا منصور.
سرمدة صدرت عن الدار العربية للعلوم ناشرون - بيروت 2011
التعليق
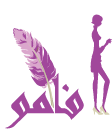

 من نحن
من نحن أشواك الورد
أشواك الورد قصاصات.كوم
قصاصات.كوم متابعات
متابعات فضاء للبوح
فضاء للبوح سرديات
سرديات قصائد
قصائد آراء حرة
آراء حرة في المرآة
في المرآة الأسوأ
الأسوأ دليل فامو
دليل فامو Boutique FaMoh
Boutique FaMoh Café FaMoh
Café FaMoh إتصل بنا
إتصل بنا