سرديات عودة
فصل من رواية “بروكلين هايتس” بقلم: ميرال الطحاوي/ أمريكا (الخميس 19 نيسان 2012)
فولتون ستريت
Fulton Street
يقع “فولتون ستريت” في قلب “بروكلين”، وفي أحد أزقته المطلة على الكنيسة، يقع مبني صغير أرضي، بحديقة خلفية ذات شرفة قريبة. يسمونه مبنى “وكالة غوث اللاجئين”. تجلس هناك كل أسبوع إلى جانب سيدات صغيرات، أو كبيرات مثلها، يأتين بحثا عن فرص للعمل وكوبونات للطعام، ومعاش أسبوعي شحيح. سيدات من بورما أو البوسنة، أو عراقيات في ملابس سوداء قاتمة وحزينة كُرديات بيضاوات.. كثيرات منهن أفغانيات بوجوه حمراء متّقدة.
تجلس دائما بجوار” نزاهات ” التي هربت منذ سنوات من البوسنة. تخرج من جيبها بطاقة تثبت أنها كانت تعمل طبيبة في “بوسنيا”، تلبس نظارة طبية لتبدو أكثر وقارا، وتتحدث بجدية طبيبة سابقة، في مدينة لم يسمع بها أحد، بكلمات إنجليزية قليلة ولكنة روسية ووجه أحمر صغير، لا تعرف هند كيف تتعاطف معه؛ “نزاهات” مطلوبة دائما لقدراتها المتعددة. يعرف مهارتها من لا يملكون غطاء صحيا، وهم كثيرون خصوصا في “وكالة غوث اللاجئين”، وفي أطراف “بروكلين” ومنطقة “كنارسي”، وهي من المناطق المليئة بالمهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين، خصوصا من الأسر اليمنية المسلمة المحافظة، الذين يتقاسمون بيوتا كبيرة يتشاركون فيها. مهارة “نزاهات “هي التي قادتها إلى عوالمهم؛ فهي خبيرة بالأوجاع والوصفات الطبية. كما أنها طبيبة تراقب الضغط والنبض والحرارة، وتتفحص النساء الحوامل والمرضعات، ويطلبونها في الحالات الحرجة. ويسمونها “الدكتوره”، ويثقون بها، ويرون أنها على أية حال مسلمة، ويصح لها أن تنكشف على عورات المسلمين. كانت أيضا تحمل معها ماكينة خياطة صغيرة، وتنتقل من بيت إلى آخر وهي تعدّل العباءات السوداء والمزركشة بالتطاريز، تلك الملابس التي يجلبها الحجاج والتجار بلا مقاس سابق، وتحتاج إلى تضييق وتحبيك؛ ليكون لها خصر وفتحة مقوّرة للصدر والأرداف. يد “نازاهات” مدربة على أشياء كثيرة، ومليئة بالعروق الدقيقة لكنها سريعة وصغيرة ، يد طبيبة تصنع بها المعجزات. لا تفهم “نزاهات” من كلماتهم العربية، غير “إن شاء الله. الحمد لله. وسّع. ضيّق”، وبعض المصطلحات التي تحتاجها للتواصل، خصوصا مع الجدة الكبيرة التي تدير كل هذه البيوت من على سجادة الصلاة، وهي تسبح وتحوقل. الصغيرات لا يشبهن الأمهات فهن يلبسن الماركات الشهيرة كافة، ويتحدثن بلكنة أمريكية أيضا. على الرغم من أنهن عادة لا يذهبن أبعد من المدرسة المتوسطة، حيث تدبر الجدة زيجات البنات من على فرشتها، وتكثر الحاجة إلى “نزاهات” في مواسم الأعراس، فهي التي تقص وتَحْرِد وتضيّق وتوسّع، وتجهز ماسكات الوجه، وتتابع حالات الالتهابات التناسلية، وتصف المراهم، وتقوم بدور البلاّنة، ومداوية الأوجاع في الوقت نفسه. تحبها الجدة التي تفترش الأرض، وتمضغ القات المنزرع في الحديقة الصغيرة خلف المنزل، وتشرب الماء، وتدهن يديها بمسك العود والزعفران، وتقول عنها “موحدة بالله”.
تقوم “نزاهات” بالتسوق للعرب من أصول يمنية، لأنهم لا يرسلون نساءهم إلى السوبر ماركت، وتقريبا لا يخرجن إلا مع أزواجهن، وينشغلن بعمل الوجبات المنزلية. وتعرف أن كثيرا من العائلات اليمنية التي حققت ثراء كبيرا، يملكون كثيرا من محلات “الدّلي” المنتشرة لبيع البقالة في كل مكان، وأنهم يملكون أيضا نصف مغاسل “بروكلين لاندري كلين”، أو التنظيف الجاف، وينافسون المكسيكيين في أعمال البناء، فهم يقومون بأعمال الهدم والبناء كمقاولين صغار، كبروا وأصبحوا أسرا ممتدة، يعرفون بعضهم ، ويتزوجون من بعضهم ، ويكوّنون “جيتو” يمتد من “كنارسي” حتى “الأفنيو” الخامس.
تجلس “نزاهات” على مقعد وكالة غوث اللاجئين إلى جوار البوسنيات الصغيرات اللاتي يتعثرن في ثيابهن الإسلامية الطويلة، وتحدثها عن ” عمر عزام”، تقول إنه غني جدا ويرسل إليهم وإلى عائلات مسلمة أخرى معونات شهرية كبيرة. تحثها على مقابلة زوجته “إريكا” فهي فتاة أمريكية مهتدية إلى الإسلام على يديه. تقول لها إن “إريكا” تتعاطف مع اللاجئين المسلمين. تقول لها إنه غني، أغنى مما يتصور أحد، أغنى من اليمنيين بل هو يشارك بعض اليمنين محالهم وشركات الهدم والبناء. تدير هند وجهها إلى النافذة، كما اعتادت كلما أرادت الهروب من حديث لا يعجبها. وقالت لـ”نزهات”:” أنا لا تجوز عليَّ الصدّقة. أنا لا أعرف شيئا عن هذا الرب الذي تتحدثون عنه. أحاول نسيانه على الأقل الآن”. فتدير “نزاهات” ظهرها إليها، ولا تنطق.
النساء اللاتي اتخذن جانبا، بعيدا عن حلقة الرجال، واتضح لها كم يشبهنها الآن، خصوصا إذا كانت أوراقهن مزيّنة بتلك العبارة “انتهاك بدني ونفسي.. لجوء إنساني” ممتلئات مثلها، خلفياتهن ثقيلة ويستخدمن كثيرًا من إيماءات الجسد للرد على أسئلة عادية، مثل “كيف الحال؟”، أو ما شابه. يلبسن ملابس كثيرة وغريبة مثلها، كانت الثياب التي تدثرهن تخفي ملامحهن ووجودهن، ملابس غريبة مختلطة بالألوان التشكيلية العرقية كأشكال المثلثات والمربعات، بألوان مبهجة حمراء وخضراء كأعلام دول انقرضت، وغرقت في محيط ما، وأنهن مبتسمات بلا سبب لإبداء امتنانهن، ويسحبن في أيديهن أطفالا كبروا وصاروا يتحدثون اللكنة الأمريكية، ولا يبحثون عن آبائهم الذين يعيشون أو يموتون في مكان ما. يجلسن وهن يغطين رؤوسهن في الغالب بتلك الإيشاربات الأوزبكية الخفيفة التي أتين بها معهن.
يجلس على كراسي الوكالة عدد كبير من الشباب صغير السن نسبيا، معظمهم من بورما وأفغانستان يتبادلون الثرثرة، حتى يأتي دورهم في تسلم المعونة. لا يتحدثون مجملا لأن كلاً منهم مشغول بحاله، ولا يتشاركون قصصهم القديمة؛ لأنهم يودون نسيانها أو محوها والتصديق بأنهم رعايا، وبعد سنوات سيصيرون مواطنين أمريكيين، يشبهون كل الذين يجولون في الشوارع، ولا يسألهم أحد: من أين جئتم؟
يقترب منها “عبدول” باسما، تبتسم أيضا غير راغبة في الحديث؛ لأن “عبدول” يصغرها بعشرين عاما، وهو أحمق وثرثار، يلهث بحثًا عن وظيفة، وامرأة تؤنسه. يسألها السؤال نفسه الذي رأته يسأله لغيرها، على سبيل جر الكلمات من الأفواه المغلقة:
- هل أنت من الوكالة أيضا؟
تبتسم وهي تهز رأسها. فيكمل:
- عربية؟
تهز رأسها موافقة.
- عراقية؟
تهز رأسها نافية.
- آه. فلسطينية، أليس كذلك؟
تهز رأسها نافية.
تجيبه بحذر من يريد أن ينهي حوارا قبل أن يبدأ:
- أنا مصرية.
- مسيحية، أليس كذلك؟
تصمت. تدخل في روحها أكثر نافية هويتها، بينما يستمر “عبدول” في طرح الأسئلة:
- تحضرين درس الإنجليزي؟
تهز رأسها موافقة.
- والتأهيل المهني؟
تهز رأسها نافية. تهز رأسها التي أتعبتها حركة الجزم والنفى، لكنه لا يغلق فمه. يظل يستعرض خبراته في الحياة الجديدة، باعتباره خبيرا في شؤون اللاجئين.
يقول “عبدول” إنه من أفغانستان. هي تعرف ذلك دون أن يقول، من عينيه الضيقتين البُنيتين مثل الثعالب الجبلية. يتطوع “عبدول” بشرح حكايته التي تعرف أنها ملفقة؛ لأن كل الذين يفتحون أفواههم هنا يكذبون، يدارون بالكذب أشياء لا يريدون أن يعرفها أحد، ويدفنون الحقيقة بعيدا أبعد من أن يراها مخلوق.
يقول لها إنه كان يعمل مع الجيش الأمريكي. يقول ذلك بفخر.
يخرج “عبدول” إلى الشرفة ليدخن سيجارته، تخرج خلفه لأنها تود أن تقترض منه سيجارة وأن تنفس دخان القلق بعيدا عن الجميع. المكتب جزء من المكتبة. مجرد حجرة صغيرة مطلة على “بارك أفنيو” الواسع النظيف. الشرفة مكدسة بالمقاعد الخشبية أيضا. يجلس على أحدها ويضع ساقه على الأخرى عالية، تكشف الشمس لون شعره الفاحم، وجسده الحربي، ولياقته الفاتنة. يعطيها السيجارة وهو يتكئ بظهره. تجلس على الطرف البعيد من المقعد وتدخن.
يبتسم “عبدول”، لأنه وجد من سيكمل معه رغبته في الحديث العابر.
- هل تصلين؟
تهز رأسها نافية، مؤكدة بذلك عدم رغبتها في استعمال الحروف؛ لأن الحروف لا معنى لها. فقط هزة الرأس الصماء تعني وجودا حرا من الأكاذيب.
يعود، فيسألها بشبق برغبة في الرثاء أو السخرية من وحدتها:
- أتحبين الفودكا؟
يقول ذلك كأنه عرض سخي، بخبث الثعالب المهتاجة، الباحثة عن عواء ليلي مشترك. تضحك؛ لأنها لم تتوقع أن يحاول إغواءها.
تقول بغنج:” أحب الفودكا، لكنني لا أحب الأطفال”.
وتنظر إليه. ثم تكمل أنها تفضل أن تشرب وحدها، لأنها تسكر بسهولة وتفقد وعيها بسهولة، وتبكي بحرقة في النهاية. وأن تلك الدراما لا يحبها الرجال عادة؛ لأنها تخيب كل توقعاتهم عن احتساء الكحول.
يهز رأسه هذه المرة بتسليم عارف، وبحكمة من عاد لرشده.
يعود إلى رغبته الاستكشافية في سؤالها:
- هل هناك جيش أمريكي في مصر، كنت تعملين معه؟
لا تحب الحديث عن حياتها التي لم تعد تعرف عنها الكثير.
يكمل هو، حين تصمت بلا رد:
أنا كنت أترجم للأمريكان.
يضحك وهو يفرك بقايا سيجارته تحت حذائه “أترجم، وأجلب لهم حشيشًا، وأخبارًا وأشياء أخرى من هنا وهناك.. أشاركهم شرب الفودكا الروسي والحشيش الأفغاني”.
يجذبها من شعرها، وهو يسأل:
هل تحبين الحشيش الأفغاني؟
تضحك لأنه طفل أكثر مما تصورت؛ لأنه يريد أن يبكي ويوشك أن يقول لها إنه يريد أن يرجع إلى وطنه، وإنه في الحقيقة لم يجد تلك الجنة التي يبحث عنها. لا تقول له إنها جربت الحشيش ، حين كانت تبحث عن علاقة الحشيش بالكتابة.
كانت تريد أن تكتب كأنها ستموت لو ظلت الأشياء بداخلها كما هي مريرة ومتراكمة، وأنها تريد أن تنهي نصها الأول والوحيد ” لا أشبه أحدا “. لكن الكتابة عصية مثل أنثي مجروحة، وأنها في الحقيقة لا تستطيع أن تتحرر من تلك الجروح. وأنها تبكي كثيرا، وتبحث حولها كالمجنونة عن تلك البنت الصغيرة التي كانت تسكنها. صارت فقط راغبة في التشرنق داخل هواجسها. وأنها تناولت الحشيش مرة واحدة فقط، ثم أمسكت الورقة والقلم ولم تكتب. كانت الرائحة نفاذة لكنها انخرطت في البكاء والقيء، ثم نامت طويلا. وعندما استيقظت كان طفلها الذي يحبو يضع جسده الصغير كله فوق وجهها ويبكي “مممامما..” وأنه كان مبللا ورائحة برازه تملأ أنفها، وجائعا، ومنفطرا من البكاء.
لم تقل ذلك لـ “عبدول”، لأنه لن يفهمها. كان يركز كل قدراته في اكتشاف مدى تأثير رجولته على احتياجها الجسدي. يضحك مثل طفل، ويقول “ربما تناولتِ شيئا آخر.. ربما حنة أو خلطة أعشاب. الحشيش الأفغاني لدن مرن”. يحرك أصابعه باستدارة جنسية تعرفها كمثال يحاول به تشكيل عُجُز امرأة تثيره. يقول ذلك بشبق، فترد بصلابة.
تعبر رائحة الحشيش الأفغاني من سيجارة “عبدول” الذي مازال يجلس على إفريز البالكون وينظر إليها. تذكّرها رائحة الحشيش بكل مدرّسي اللغة العربية. كانت دائما تقدس مدرسي اللغة العربية لأسباب مجهولة، وربما مرتبطة برائحة الحشيش أيضا، تحب كلاسيكيتهم الواثقة، ويبدون لها رجالا مفعمين بالسحر.
كان مدرس العربي يركز بصره على صدر صديقتها “حنان” بالضبط على صدرها، الذي نتأ بفصوص صغيرة محببة ستكبر يوما بعد يوم. كان حازما ومليئا بالغموض، ويقول أشياء دائما صعبة ومبهرة، مثل “وقبر حرب في مكان قفر.. وليس قرب قبر حرب قبر”! ويسألها أن ترددها بسرعة؛ فتخطئ “حنان” وتضحك؛ فينشرح قلبه.. ويهتز صدرها الصغير. مدرس العربي كان وجيها، رغم أن الجميع يعرف أنه الابن الوحيد للجدة “زينب” التي مازالت متخصصة في أعمال البيوت، ولكنها تؤكد أيضا أنها ليست خادمة. هي فقط “إيدها فيها البركة إذا عجنت، وإذا طبخت، وإذا فركت الفريكة، أو حلبت البهائم”. ويد الجدة “زينب هي التي ربّت مدرس العربي ، الذي يحتفظ بقمصانه نظيفة وأنيقة، ويهتم بشكل خاص بتسريحة شعره الذي يبدو أسود فاحما مصقولا لامعا، بروائح الصابون. وقد كان كما تعرف جميع الصفوف جادا ومحترما، ومدمنا لشرب السجائر التي يبيعها “محمود” البقال، ويكن إعزازا عميقا لصديقتها “حنان” ولأمها الخيّاطة “الست فتحية أحمد”. إذ كثيرا ما يشاهده الناس “خارج داخل” على بيت الست، وقد رأوها أيضا تغني له “أسمر.. أسمر طيّب ماله.. حتى سمارُه سر جَمَالُه”. يستند على طاولة تجلس إليها هي و”حنان”، ويبتسم لحضورها الأنثوي، ويحمرّ خداها الممتلئان، ويدرك أنها نسخة من أمها فقط بعد أن صار الفصل خاليا فجأة من البنات وظلت الرائحة المخدرة تنساب رغم أن “إميل” الناظر دخل أكثر من مرة إلى الفصل، وقال له:” يا أخي انتَ عايز تودّينا فْ داهية؟”. لكنه كان منشغلا بنمو “حنان” غير الافتراضي، وبتحولها من طفلة إلى أنثى. وكان مهتما بفصاحة “هند” التي صارت تقرأ وتصحح كراسات الفصل، وتكتب الأسماء على الطاولة، وتقوم بواجبات الدرس، بينما يكون هو متكئا على مقعده، يتبادل بعض الألعاب البريئة مع “حنان”.
عندما بدأت أم “حنان” تستعير بودرة التلك من الجيران، إمعانا في كشف بلوغ ابنتها المبكر، جلست “حنان” في البيت غير عابئة بخطابات مدرس العربي، الذي صار يرسل لها إنذارات بالفصل من المدرسة لعل وعسى تجد تلك الخطابت من يقرأها ، لكن حنان لم تعد تأتي وظل مدرس العربي قلقا، وشاردا ومضطرا للتركيز على هند التي صارت تجلس وحدها، فقد أدركت “هند” أنها صارت وجهًا لوجه مع مدرس اللغة العربية، عليها أن تجلس في مواجهة الرائحة النفاذة التي تعطر الفصل ، عليها أيضا أن تشرح القواعد والقراءة والتعبير، بينما يكون هو منشغلا بتفريغ سجائره من الدخان، بأنبوبة القلم الجاف، ليحفر نفقا في السجائر ويحشوها. وصار يحمل عصا رفيعة في يده ويغضب بلا سبب، ويقول للأولاد في الصف “يا بهائم”، لأنهم في رأيه يأتون إلى المدرسة دون أن ينظفوا أحذيتهم البلاستيكية من الروث، ولا يغسلون أياديهم الخشنة الملونة بالخضرة من حش البرسيم في الغيطان والحقول، وهم عادة ما يعتبرون الحصص المدرسية فواصل للراحة، أو النوم، من أعمال الحقل الشاقة، و يجلسون في الفصل ببلادة ويتعاركون بحنق، فيؤكد ذلك أن البلادة صفة نموذجية تلازم البهائم والتلاميذ في الفصل. وصار يضرب بالعصا كثيرا، يضعهم بالمقلوب على الكرسي الذي خُصص له، ويضرب على الساقين فتنفجر في الفصل روائح نتنة من الأحذية البلاستيكية والروث والبكاء. وينزل الأولاد من على كرسي المَدّ كاظمين أفواههم، يحاولون كظم دموعهم، ويتعب من الضرب فيخرج أوراق البفرة ويرص السجائر، بعد أن يؤكد أن البهائم لا يكلّون من الضرب.
سيكون دورها قد تحدد في القراءة المتواصلة، وبصوت عالٍ. وفي المرة التي قالت له : ” أنا تعبت من كتر القراءة .. هوه مافيش حد غيري “، جذبها من مريلتها البنية، وقال لها بصوته العالي الذي يخيفها:” انتِ فاكرة نفسك بنت الزير السالم.. ياللاّ على بيت أبوكِ ياللاّ .. عاملة روحها الجازية الشريفة، ما خلاص. بلا عرب بلا..”. خرجت “هند” تفكر من هو هذا “الزير سالم” وما علاقته بأبيها ، وكان الأستاذ “إميل” الناظر يركض وراءها، لكنها لم تقف. تركت مدرسة “مقاوي” الابتدائية خلفها، بعد أن عبَرت مَكنة الطحين والمجموعة، وبضعة مطارح تمر عليها كل يوم، وصار بطنها يوجعها كلما رأت مدرس العربي، وصارت حصة العربي طويلة بعد أن أصبحت لا تقعد ولا تجلس ولا تقرأ، ولا تشارك في شيء. فقط تجلس وتنظر في الحائط المجاور، وتنتظر بصبر خانق أن ينتهي الدرس. صار مدرس العربي يلبس طاقية بيضاء على رأسه، ويصلي كثيرا ،ويقود الصبيان إلى المسجد المدرسي لأداء صلاة الجماعة ، ثم ركب بعد عدة أشهر الباخرة وذهب إلى بلاد بعيدة اسمها “اليمن” كان كثير من المدرسين ، قد حملوا حقائبهم و سبقوه إليها.
بكت الجدة “زينب” كثيرا، وقالت:” ابن حرام يا ابن بطني. ابن حرام مثل أبوك، ده حتى لم يقل يا امّه أنا ماشي، ولا سلم على أمه اللي شقيِت عليه العمر. معلش الله يسهل له، ويجعل الريح في صفه، والبحر تحته ومراكبه عمرانه”. دعوة الجدة “زينب” مستجابة، كما أن إيدها فيها البركة؛ فقد عاد الأستاذ القادم من بلاد اليمن، وفي جبينه علامة الصلاة، وفي جيبه مسك مكيّ، وجلبابه أبيض. وصار يعمّر في “مسجد النور” أو “المسجد الكويتي” لصاحبه الذي لم يره أحد، وصار يخطب ويؤذّن ويؤم. ويسمع المصلون صوته الجهوري ويقول “يا رسول الله أُمّتك يتكالب عليها الذئاب..”، ويبكي الناس تأثرا.
أصبح مدرس العربي مشهورا ببلاغته الحماسية وكان أول من فتح محلا لبيع البلاستيك ومنتجاته، وسمّاه “البركة” ثم ثنّاه بآخر للسراميك والبلاط؛ ليلبي احتياج البيوت الحجرية الجديدة، وسمّاه “القدس”، ثم فتح عدة توكيلات أخرى لبيع السلع الكهربائية وسمّاه “الفرقان”.. ثم تغيرت “تلال فرعون” وصارت هند لا تعرف كيف تسير في أزقتها حين تتسند عليه أبيها بين العلواية والمضيفة.
يجذبها “عبدول” من شعرها ثانية، لتعود من ذكرياتها البعيدة، فتشعر بالأهانة وتقول له بحدة إنها “لا تحب الحشيش ولا مدرّسي العربية، ولا الأطفال، ولا الترجمة، ولا التجسس، ولا أي شيء عرفه هو في حياته”.. وأنها “لم تعد تؤمن بشيء”، وأنه “مجرد طفل غبي”.
يضحك “عبدول” للإهانة، وهو يسألها بمكر ثعلب:
أنت إذن سفيرة النوايا الحسنة، أعطوك الإقامة وكوبونات الطعام، والتعاطف مجانا، أو يمكن انتِ روح الأم تريزا جاءت من أعالي البحار لتعظني..”.
يجرحها “عبدول”، فهو لم يفهم لماذا هي هنا، وهي أيضا لا تعرف!
يجرحها، لأنها تظن أنها أشرف من ذلك وأرقى. إنه فقط لا يفهم.
تعطيه ظهرها، فيكمل موضحا :
“ثم إنِّك ممتلئة جدا من الخلف، وأنا لا أحب النساء اللواتي يملكن مؤخرة بحجم جبل أُحد”.
يضحك “عبدول” الذي يُظهِر معرفته بالثقافة الأمريكية و”البيج فات آس”، وقدرته على إهانة الآخرين ببرودة، وابتسامة، وبلا غضب. تكتشف أنه ثعلب جبلي صغير تربّى في أحضان فرقة كوماندوز أمريكي، وأنه ليس خبيرا بالفودكا والحشيش فقط، بل قادر على الاستشهاد بأماكن مقدسة، وحشرها في ألفاظ جنسية متلائمة؛ ليسخر من امرأة وحيدة، بائسة مثلها.
______________________
ميرال الطحاوي أستاذة الأدب بجامعة ابلاشن نورث كارولينا
miraleltahawy@yahoo.com
التعليق
فولتون ستريت
Fulton Street
يقع “فولتون ستريت” في قلب “بروكلين”، وفي أحد أزقته المطلة على الكنيسة، يقع مبني صغير أرضي، بحديقة خلفية ذات شرفة قريبة. يسمونه مبنى “وكالة غوث اللاجئين”. تجلس هناك كل أسبوع إلى جانب سيدات صغيرات، أو كبيرات مثلها، يأتين بحثا عن فرص للعمل وكوبونات للطعام، ومعاش أسبوعي شحيح. سيدات من بورما أو البوسنة، أو عراقيات في ملابس سوداء قاتمة وحزينة كُرديات بيضاوات.. كثيرات منهن أفغانيات بوجوه حمراء متّقدة.
تجلس دائما بجوار” نزاهات ” التي هربت منذ سنوات من البوسنة. تخرج من جيبها بطاقة تثبت أنها كانت تعمل طبيبة في “بوسنيا”، تلبس نظارة طبية لتبدو أكثر وقارا، وتتحدث بجدية طبيبة سابقة، في مدينة لم يسمع بها أحد، بكلمات إنجليزية قليلة ولكنة روسية ووجه أحمر صغير، لا تعرف هند كيف تتعاطف معه؛ “نزاهات” مطلوبة دائما لقدراتها المتعددة. يعرف مهارتها من لا يملكون غطاء صحيا، وهم كثيرون خصوصا في “وكالة غوث اللاجئين”، وفي أطراف “بروكلين” ومنطقة “كنارسي”، وهي من المناطق المليئة بالمهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين، خصوصا من الأسر اليمنية المسلمة المحافظة، الذين يتقاسمون بيوتا كبيرة يتشاركون فيها. مهارة “نزاهات “هي التي قادتها إلى عوالمهم؛ فهي خبيرة بالأوجاع والوصفات الطبية. كما أنها طبيبة تراقب الضغط والنبض والحرارة، وتتفحص النساء الحوامل والمرضعات، ويطلبونها في الحالات الحرجة. ويسمونها “الدكتوره”، ويثقون بها، ويرون أنها على أية حال مسلمة، ويصح لها أن تنكشف على عورات المسلمين. كانت أيضا تحمل معها ماكينة خياطة صغيرة، وتنتقل من بيت إلى آخر وهي تعدّل العباءات السوداء والمزركشة بالتطاريز، تلك الملابس التي يجلبها الحجاج والتجار بلا مقاس سابق، وتحتاج إلى تضييق وتحبيك؛ ليكون لها خصر وفتحة مقوّرة للصدر والأرداف. يد “نازاهات” مدربة على أشياء كثيرة، ومليئة بالعروق الدقيقة لكنها سريعة وصغيرة ، يد طبيبة تصنع بها المعجزات. لا تفهم “نزاهات” من كلماتهم العربية، غير “إن شاء الله. الحمد لله. وسّع. ضيّق”، وبعض المصطلحات التي تحتاجها للتواصل، خصوصا مع الجدة الكبيرة التي تدير كل هذه البيوت من على سجادة الصلاة، وهي تسبح وتحوقل. الصغيرات لا يشبهن الأمهات فهن يلبسن الماركات الشهيرة كافة، ويتحدثن بلكنة أمريكية أيضا. على الرغم من أنهن عادة لا يذهبن أبعد من المدرسة المتوسطة، حيث تدبر الجدة زيجات البنات من على فرشتها، وتكثر الحاجة إلى “نزاهات” في مواسم الأعراس، فهي التي تقص وتَحْرِد وتضيّق وتوسّع، وتجهز ماسكات الوجه، وتتابع حالات الالتهابات التناسلية، وتصف المراهم، وتقوم بدور البلاّنة، ومداوية الأوجاع في الوقت نفسه. تحبها الجدة التي تفترش الأرض، وتمضغ القات المنزرع في الحديقة الصغيرة خلف المنزل، وتشرب الماء، وتدهن يديها بمسك العود والزعفران، وتقول عنها “موحدة بالله”.
تقوم “نزاهات” بالتسوق للعرب من أصول يمنية، لأنهم لا يرسلون نساءهم إلى السوبر ماركت، وتقريبا لا يخرجن إلا مع أزواجهن، وينشغلن بعمل الوجبات المنزلية. وتعرف أن كثيرا من العائلات اليمنية التي حققت ثراء كبيرا، يملكون كثيرا من محلات “الدّلي” المنتشرة لبيع البقالة في كل مكان، وأنهم يملكون أيضا نصف مغاسل “بروكلين لاندري كلين”، أو التنظيف الجاف، وينافسون المكسيكيين في أعمال البناء، فهم يقومون بأعمال الهدم والبناء كمقاولين صغار، كبروا وأصبحوا أسرا ممتدة، يعرفون بعضهم ، ويتزوجون من بعضهم ، ويكوّنون “جيتو” يمتد من “كنارسي” حتى “الأفنيو” الخامس.
تجلس “نزاهات” على مقعد وكالة غوث اللاجئين إلى جوار البوسنيات الصغيرات اللاتي يتعثرن في ثيابهن الإسلامية الطويلة، وتحدثها عن ” عمر عزام”، تقول إنه غني جدا ويرسل إليهم وإلى عائلات مسلمة أخرى معونات شهرية كبيرة. تحثها على مقابلة زوجته “إريكا” فهي فتاة أمريكية مهتدية إلى الإسلام على يديه. تقول لها إن “إريكا” تتعاطف مع اللاجئين المسلمين. تقول لها إنه غني، أغنى مما يتصور أحد، أغنى من اليمنيين بل هو يشارك بعض اليمنين محالهم وشركات الهدم والبناء. تدير هند وجهها إلى النافذة، كما اعتادت كلما أرادت الهروب من حديث لا يعجبها. وقالت لـ”نزهات”:” أنا لا تجوز عليَّ الصدّقة. أنا لا أعرف شيئا عن هذا الرب الذي تتحدثون عنه. أحاول نسيانه على الأقل الآن”. فتدير “نزاهات” ظهرها إليها، ولا تنطق.
النساء اللاتي اتخذن جانبا، بعيدا عن حلقة الرجال، واتضح لها كم يشبهنها الآن، خصوصا إذا كانت أوراقهن مزيّنة بتلك العبارة “انتهاك بدني ونفسي.. لجوء إنساني” ممتلئات مثلها، خلفياتهن ثقيلة ويستخدمن كثيرًا من إيماءات الجسد للرد على أسئلة عادية، مثل “كيف الحال؟”، أو ما شابه. يلبسن ملابس كثيرة وغريبة مثلها، كانت الثياب التي تدثرهن تخفي ملامحهن ووجودهن، ملابس غريبة مختلطة بالألوان التشكيلية العرقية كأشكال المثلثات والمربعات، بألوان مبهجة حمراء وخضراء كأعلام دول انقرضت، وغرقت في محيط ما، وأنهن مبتسمات بلا سبب لإبداء امتنانهن، ويسحبن في أيديهن أطفالا كبروا وصاروا يتحدثون اللكنة الأمريكية، ولا يبحثون عن آبائهم الذين يعيشون أو يموتون في مكان ما. يجلسن وهن يغطين رؤوسهن في الغالب بتلك الإيشاربات الأوزبكية الخفيفة التي أتين بها معهن.
يجلس على كراسي الوكالة عدد كبير من الشباب صغير السن نسبيا، معظمهم من بورما وأفغانستان يتبادلون الثرثرة، حتى يأتي دورهم في تسلم المعونة. لا يتحدثون مجملا لأن كلاً منهم مشغول بحاله، ولا يتشاركون قصصهم القديمة؛ لأنهم يودون نسيانها أو محوها والتصديق بأنهم رعايا، وبعد سنوات سيصيرون مواطنين أمريكيين، يشبهون كل الذين يجولون في الشوارع، ولا يسألهم أحد: من أين جئتم؟
يقترب منها “عبدول” باسما، تبتسم أيضا غير راغبة في الحديث؛ لأن “عبدول” يصغرها بعشرين عاما، وهو أحمق وثرثار، يلهث بحثًا عن وظيفة، وامرأة تؤنسه. يسألها السؤال نفسه الذي رأته يسأله لغيرها، على سبيل جر الكلمات من الأفواه المغلقة:
- هل أنت من الوكالة أيضا؟
تبتسم وهي تهز رأسها. فيكمل:
- عربية؟
تهز رأسها موافقة.
- عراقية؟
تهز رأسها نافية.
- آه. فلسطينية، أليس كذلك؟
تهز رأسها نافية.
تجيبه بحذر من يريد أن ينهي حوارا قبل أن يبدأ:
- أنا مصرية.
- مسيحية، أليس كذلك؟
تصمت. تدخل في روحها أكثر نافية هويتها، بينما يستمر “عبدول” في طرح الأسئلة:
- تحضرين درس الإنجليزي؟
تهز رأسها موافقة.
- والتأهيل المهني؟
تهز رأسها نافية. تهز رأسها التي أتعبتها حركة الجزم والنفى، لكنه لا يغلق فمه. يظل يستعرض خبراته في الحياة الجديدة، باعتباره خبيرا في شؤون اللاجئين.
يقول “عبدول” إنه من أفغانستان. هي تعرف ذلك دون أن يقول، من عينيه الضيقتين البُنيتين مثل الثعالب الجبلية. يتطوع “عبدول” بشرح حكايته التي تعرف أنها ملفقة؛ لأن كل الذين يفتحون أفواههم هنا يكذبون، يدارون بالكذب أشياء لا يريدون أن يعرفها أحد، ويدفنون الحقيقة بعيدا أبعد من أن يراها مخلوق.
يقول لها إنه كان يعمل مع الجيش الأمريكي. يقول ذلك بفخر.
يخرج “عبدول” إلى الشرفة ليدخن سيجارته، تخرج خلفه لأنها تود أن تقترض منه سيجارة وأن تنفس دخان القلق بعيدا عن الجميع. المكتب جزء من المكتبة. مجرد حجرة صغيرة مطلة على “بارك أفنيو” الواسع النظيف. الشرفة مكدسة بالمقاعد الخشبية أيضا. يجلس على أحدها ويضع ساقه على الأخرى عالية، تكشف الشمس لون شعره الفاحم، وجسده الحربي، ولياقته الفاتنة. يعطيها السيجارة وهو يتكئ بظهره. تجلس على الطرف البعيد من المقعد وتدخن.
يبتسم “عبدول”، لأنه وجد من سيكمل معه رغبته في الحديث العابر.
- هل تصلين؟
تهز رأسها نافية، مؤكدة بذلك عدم رغبتها في استعمال الحروف؛ لأن الحروف لا معنى لها. فقط هزة الرأس الصماء تعني وجودا حرا من الأكاذيب.
يعود، فيسألها بشبق برغبة في الرثاء أو السخرية من وحدتها:
- أتحبين الفودكا؟
يقول ذلك كأنه عرض سخي، بخبث الثعالب المهتاجة، الباحثة عن عواء ليلي مشترك. تضحك؛ لأنها لم تتوقع أن يحاول إغواءها.
تقول بغنج:” أحب الفودكا، لكنني لا أحب الأطفال”.
وتنظر إليه. ثم تكمل أنها تفضل أن تشرب وحدها، لأنها تسكر بسهولة وتفقد وعيها بسهولة، وتبكي بحرقة في النهاية. وأن تلك الدراما لا يحبها الرجال عادة؛ لأنها تخيب كل توقعاتهم عن احتساء الكحول.
يهز رأسه هذه المرة بتسليم عارف، وبحكمة من عاد لرشده.
يعود إلى رغبته الاستكشافية في سؤالها:
- هل هناك جيش أمريكي في مصر، كنت تعملين معه؟
لا تحب الحديث عن حياتها التي لم تعد تعرف عنها الكثير.
يكمل هو، حين تصمت بلا رد:
أنا كنت أترجم للأمريكان.
يضحك وهو يفرك بقايا سيجارته تحت حذائه “أترجم، وأجلب لهم حشيشًا، وأخبارًا وأشياء أخرى من هنا وهناك.. أشاركهم شرب الفودكا الروسي والحشيش الأفغاني”.
يجذبها من شعرها، وهو يسأل:
هل تحبين الحشيش الأفغاني؟
تضحك لأنه طفل أكثر مما تصورت؛ لأنه يريد أن يبكي ويوشك أن يقول لها إنه يريد أن يرجع إلى وطنه، وإنه في الحقيقة لم يجد تلك الجنة التي يبحث عنها. لا تقول له إنها جربت الحشيش ، حين كانت تبحث عن علاقة الحشيش بالكتابة.
كانت تريد أن تكتب كأنها ستموت لو ظلت الأشياء بداخلها كما هي مريرة ومتراكمة، وأنها تريد أن تنهي نصها الأول والوحيد ” لا أشبه أحدا “. لكن الكتابة عصية مثل أنثي مجروحة، وأنها في الحقيقة لا تستطيع أن تتحرر من تلك الجروح. وأنها تبكي كثيرا، وتبحث حولها كالمجنونة عن تلك البنت الصغيرة التي كانت تسكنها. صارت فقط راغبة في التشرنق داخل هواجسها. وأنها تناولت الحشيش مرة واحدة فقط، ثم أمسكت الورقة والقلم ولم تكتب. كانت الرائحة نفاذة لكنها انخرطت في البكاء والقيء، ثم نامت طويلا. وعندما استيقظت كان طفلها الذي يحبو يضع جسده الصغير كله فوق وجهها ويبكي “مممامما..” وأنه كان مبللا ورائحة برازه تملأ أنفها، وجائعا، ومنفطرا من البكاء.
لم تقل ذلك لـ “عبدول”، لأنه لن يفهمها. كان يركز كل قدراته في اكتشاف مدى تأثير رجولته على احتياجها الجسدي. يضحك مثل طفل، ويقول “ربما تناولتِ شيئا آخر.. ربما حنة أو خلطة أعشاب. الحشيش الأفغاني لدن مرن”. يحرك أصابعه باستدارة جنسية تعرفها كمثال يحاول به تشكيل عُجُز امرأة تثيره. يقول ذلك بشبق، فترد بصلابة.
تعبر رائحة الحشيش الأفغاني من سيجارة “عبدول” الذي مازال يجلس على إفريز البالكون وينظر إليها. تذكّرها رائحة الحشيش بكل مدرّسي اللغة العربية. كانت دائما تقدس مدرسي اللغة العربية لأسباب مجهولة، وربما مرتبطة برائحة الحشيش أيضا، تحب كلاسيكيتهم الواثقة، ويبدون لها رجالا مفعمين بالسحر.
كان مدرس العربي يركز بصره على صدر صديقتها “حنان” بالضبط على صدرها، الذي نتأ بفصوص صغيرة محببة ستكبر يوما بعد يوم. كان حازما ومليئا بالغموض، ويقول أشياء دائما صعبة ومبهرة، مثل “وقبر حرب في مكان قفر.. وليس قرب قبر حرب قبر”! ويسألها أن ترددها بسرعة؛ فتخطئ “حنان” وتضحك؛ فينشرح قلبه.. ويهتز صدرها الصغير. مدرس العربي كان وجيها، رغم أن الجميع يعرف أنه الابن الوحيد للجدة “زينب” التي مازالت متخصصة في أعمال البيوت، ولكنها تؤكد أيضا أنها ليست خادمة. هي فقط “إيدها فيها البركة إذا عجنت، وإذا طبخت، وإذا فركت الفريكة، أو حلبت البهائم”. ويد الجدة “زينب هي التي ربّت مدرس العربي ، الذي يحتفظ بقمصانه نظيفة وأنيقة، ويهتم بشكل خاص بتسريحة شعره الذي يبدو أسود فاحما مصقولا لامعا، بروائح الصابون. وقد كان كما تعرف جميع الصفوف جادا ومحترما، ومدمنا لشرب السجائر التي يبيعها “محمود” البقال، ويكن إعزازا عميقا لصديقتها “حنان” ولأمها الخيّاطة “الست فتحية أحمد”. إذ كثيرا ما يشاهده الناس “خارج داخل” على بيت الست، وقد رأوها أيضا تغني له “أسمر.. أسمر طيّب ماله.. حتى سمارُه سر جَمَالُه”. يستند على طاولة تجلس إليها هي و”حنان”، ويبتسم لحضورها الأنثوي، ويحمرّ خداها الممتلئان، ويدرك أنها نسخة من أمها فقط بعد أن صار الفصل خاليا فجأة من البنات وظلت الرائحة المخدرة تنساب رغم أن “إميل” الناظر دخل أكثر من مرة إلى الفصل، وقال له:” يا أخي انتَ عايز تودّينا فْ داهية؟”. لكنه كان منشغلا بنمو “حنان” غير الافتراضي، وبتحولها من طفلة إلى أنثى. وكان مهتما بفصاحة “هند” التي صارت تقرأ وتصحح كراسات الفصل، وتكتب الأسماء على الطاولة، وتقوم بواجبات الدرس، بينما يكون هو متكئا على مقعده، يتبادل بعض الألعاب البريئة مع “حنان”.
عندما بدأت أم “حنان” تستعير بودرة التلك من الجيران، إمعانا في كشف بلوغ ابنتها المبكر، جلست “حنان” في البيت غير عابئة بخطابات مدرس العربي، الذي صار يرسل لها إنذارات بالفصل من المدرسة لعل وعسى تجد تلك الخطابت من يقرأها ، لكن حنان لم تعد تأتي وظل مدرس العربي قلقا، وشاردا ومضطرا للتركيز على هند التي صارت تجلس وحدها، فقد أدركت “هند” أنها صارت وجهًا لوجه مع مدرس اللغة العربية، عليها أن تجلس في مواجهة الرائحة النفاذة التي تعطر الفصل ، عليها أيضا أن تشرح القواعد والقراءة والتعبير، بينما يكون هو منشغلا بتفريغ سجائره من الدخان، بأنبوبة القلم الجاف، ليحفر نفقا في السجائر ويحشوها. وصار يحمل عصا رفيعة في يده ويغضب بلا سبب، ويقول للأولاد في الصف “يا بهائم”، لأنهم في رأيه يأتون إلى المدرسة دون أن ينظفوا أحذيتهم البلاستيكية من الروث، ولا يغسلون أياديهم الخشنة الملونة بالخضرة من حش البرسيم في الغيطان والحقول، وهم عادة ما يعتبرون الحصص المدرسية فواصل للراحة، أو النوم، من أعمال الحقل الشاقة، و يجلسون في الفصل ببلادة ويتعاركون بحنق، فيؤكد ذلك أن البلادة صفة نموذجية تلازم البهائم والتلاميذ في الفصل. وصار يضرب بالعصا كثيرا، يضعهم بالمقلوب على الكرسي الذي خُصص له، ويضرب على الساقين فتنفجر في الفصل روائح نتنة من الأحذية البلاستيكية والروث والبكاء. وينزل الأولاد من على كرسي المَدّ كاظمين أفواههم، يحاولون كظم دموعهم، ويتعب من الضرب فيخرج أوراق البفرة ويرص السجائر، بعد أن يؤكد أن البهائم لا يكلّون من الضرب.
سيكون دورها قد تحدد في القراءة المتواصلة، وبصوت عالٍ. وفي المرة التي قالت له : ” أنا تعبت من كتر القراءة .. هوه مافيش حد غيري “، جذبها من مريلتها البنية، وقال لها بصوته العالي الذي يخيفها:” انتِ فاكرة نفسك بنت الزير السالم.. ياللاّ على بيت أبوكِ ياللاّ .. عاملة روحها الجازية الشريفة، ما خلاص. بلا عرب بلا..”. خرجت “هند” تفكر من هو هذا “الزير سالم” وما علاقته بأبيها ، وكان الأستاذ “إميل” الناظر يركض وراءها، لكنها لم تقف. تركت مدرسة “مقاوي” الابتدائية خلفها، بعد أن عبَرت مَكنة الطحين والمجموعة، وبضعة مطارح تمر عليها كل يوم، وصار بطنها يوجعها كلما رأت مدرس العربي، وصارت حصة العربي طويلة بعد أن أصبحت لا تقعد ولا تجلس ولا تقرأ، ولا تشارك في شيء. فقط تجلس وتنظر في الحائط المجاور، وتنتظر بصبر خانق أن ينتهي الدرس. صار مدرس العربي يلبس طاقية بيضاء على رأسه، ويصلي كثيرا ،ويقود الصبيان إلى المسجد المدرسي لأداء صلاة الجماعة ، ثم ركب بعد عدة أشهر الباخرة وذهب إلى بلاد بعيدة اسمها “اليمن” كان كثير من المدرسين ، قد حملوا حقائبهم و سبقوه إليها.
بكت الجدة “زينب” كثيرا، وقالت:” ابن حرام يا ابن بطني. ابن حرام مثل أبوك، ده حتى لم يقل يا امّه أنا ماشي، ولا سلم على أمه اللي شقيِت عليه العمر. معلش الله يسهل له، ويجعل الريح في صفه، والبحر تحته ومراكبه عمرانه”. دعوة الجدة “زينب” مستجابة، كما أن إيدها فيها البركة؛ فقد عاد الأستاذ القادم من بلاد اليمن، وفي جبينه علامة الصلاة، وفي جيبه مسك مكيّ، وجلبابه أبيض. وصار يعمّر في “مسجد النور” أو “المسجد الكويتي” لصاحبه الذي لم يره أحد، وصار يخطب ويؤذّن ويؤم. ويسمع المصلون صوته الجهوري ويقول “يا رسول الله أُمّتك يتكالب عليها الذئاب..”، ويبكي الناس تأثرا.
أصبح مدرس العربي مشهورا ببلاغته الحماسية وكان أول من فتح محلا لبيع البلاستيك ومنتجاته، وسمّاه “البركة” ثم ثنّاه بآخر للسراميك والبلاط؛ ليلبي احتياج البيوت الحجرية الجديدة، وسمّاه “القدس”، ثم فتح عدة توكيلات أخرى لبيع السلع الكهربائية وسمّاه “الفرقان”.. ثم تغيرت “تلال فرعون” وصارت هند لا تعرف كيف تسير في أزقتها حين تتسند عليه أبيها بين العلواية والمضيفة.
يجذبها “عبدول” من شعرها ثانية، لتعود من ذكرياتها البعيدة، فتشعر بالأهانة وتقول له بحدة إنها “لا تحب الحشيش ولا مدرّسي العربية، ولا الأطفال، ولا الترجمة، ولا التجسس، ولا أي شيء عرفه هو في حياته”.. وأنها “لم تعد تؤمن بشيء”، وأنه “مجرد طفل غبي”.
يضحك “عبدول” للإهانة، وهو يسألها بمكر ثعلب:
أنت إذن سفيرة النوايا الحسنة، أعطوك الإقامة وكوبونات الطعام، والتعاطف مجانا، أو يمكن انتِ روح الأم تريزا جاءت من أعالي البحار لتعظني..”.
يجرحها “عبدول”، فهو لم يفهم لماذا هي هنا، وهي أيضا لا تعرف!
يجرحها، لأنها تظن أنها أشرف من ذلك وأرقى. إنه فقط لا يفهم.
تعطيه ظهرها، فيكمل موضحا :
“ثم إنِّك ممتلئة جدا من الخلف، وأنا لا أحب النساء اللواتي يملكن مؤخرة بحجم جبل أُحد”.
يضحك “عبدول” الذي يُظهِر معرفته بالثقافة الأمريكية و”البيج فات آس”، وقدرته على إهانة الآخرين ببرودة، وابتسامة، وبلا غضب. تكتشف أنه ثعلب جبلي صغير تربّى في أحضان فرقة كوماندوز أمريكي، وأنه ليس خبيرا بالفودكا والحشيش فقط، بل قادر على الاستشهاد بأماكن مقدسة، وحشرها في ألفاظ جنسية متلائمة؛ ليسخر من امرأة وحيدة، بائسة مثلها.
______________________
ميرال الطحاوي أستاذة الأدب بجامعة ابلاشن نورث كارولينا
miraleltahawy@yahoo.com
التعليق
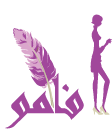

 من نحن
من نحن أشواك الورد
أشواك الورد قصاصات.كوم
قصاصات.كوم متابعات
متابعات فضاء للبوح
فضاء للبوح سرديات
سرديات قصائد
قصائد آراء حرة
آراء حرة في المرآة
في المرآة الأسوأ
الأسوأ دليل فامو
دليل فامو Boutique FaMoh
Boutique FaMoh Café FaMoh
Café FaMoh إتصل بنا
إتصل بنا