سرديات عودة
شارع أخير (الأربعاء 22 شباط 2012)
* لنا عبد الرحمن
----------------------
تمنت مارغريت لو كانت متسولة غير مشغولة سوى بالبحث عن معيش يومها، أو غجرية غير مطلوب منها تذكر الأمكنة والوجوه والأسماء. أكثر ما يعذبها هو ذاكرتها الهرمة المثقلة بتفاصيل لا يمكن التخلص منها. منذ سنوات حين تدعو أصدقاءها من باريس إلى أمسية عشاء في منزلها، تظن أنها ستهرب من ثقل العزلة الكثيفة، لكن حين يحضرون، بعد أن يبدأ الصخب يطفو في المكان، وينتشر الأصدقاء في المطبخ والصالون، متنقلين بين البيت والحديقة، تجد نفسها أكثر عزلة، تجلس في مقعدها ذي الغطاء البيج المشجر بألوان من البني والكريم، تتكئ على هذا المقعد وفي يدها كأس من الويسكي المثلج، هي وكأسها، منذ سنوات معاً.
يان.... يان أندريا، "يا له من شاب ذي عينين مشعتين ووجه فيه براءة شاحبة". تردد هذه العبارة في داخلها وهي تلمحه يتحرك بين الضيوف، ويبتسم لها من بعد وهو يدير جهاز التسجيل على موسيقى تحبها، ثم يتجه نحوها ليمسكها من يدها ليرقصا معاً. كان ثلاثة من الأصدقاء يناقشون سياسة ميتران، بينما صديقتها، إيرما الصحافية التي بلغت الخمسين قبل شهر، تشاركهم الحديث بحماسة شديدة عن السياسة الجديدة لحزب العمال. تطوف نظرات مارغريت بينهم فيما يد يان تحيط بخصرها، تحس كم هي بعيدة عنهم، ليس هناك ما يدفع الحماس بداخلها لأي مشاركة في الكلام، تود الاستماع بصمت، تود الرقص أيضاً بين ذراعي يان.
هي وهو يشكلان لوحة غريبة، لوحة عبثية مجنونة، تكسر كل الأفكار الثابتة عن خطوات الحب، والسن، والزمن. في العلاقة مع يان، كما في العلاقة مع جسدها، لا تنتظر سوى عطاء آنياً، آنياً فقط. بينها وبين يان لا يوجد سوى "الآن" بل "الآن فقط". ماذا تريد أكثر من ذلك؟ لو حدثت معجزة استمرار "الآن"، سيحصل الكثير من الفرح، لكن هذا لن يحدث لأن الزمن يمضي، لأن الأصدقاء سيذهبون، وهي مع مرور كل يوم ستكبر يوماً. ويان أندريا أيضاً سيزداد توهجاً قبل أن يبدأ بالأفول، هو أيضاً سيكبر مثلها، هو أيضاً سيرتكب جسده نحوه خيانات مختلفة. إنها معادلة الزمن الأبدية؛ نتقدم كي نصل، نتوهج كي ننطفئ، نكبر كي نموت، نحن محاصرون بهذا الرعب رغماً عنا، ولا نملك أمامه أي سبيل للنجاة. لو منحها جسدها بعض الصمود، الوقوف عند حد معين من الخسارة، يمكنها أن تستمر أكثر، وأن تكتب أكثر. الكلمات لا يصيبها الهرم، لديها الكثير لتقوله، كتابتها ما تزال فتية وقادرة على الحياة بنشاط وسط هذا الركام. الكتابة هي الشيء الوحيد الذي ظل معها طوال الوقت... طوال الوقت، وفي كل أنواع الأحزان والمسرات.
تذكرت عبارة دانيال حين كان يقول لها: "إن ميزة الحياة في قدرتك على رؤيتها من أكثر من وجه، وإيجاد أسباب دائمة للفرح". كانت تقاطعه لتقول: "وأسباب للحزن أيضاً". يتمم عبارته المبتورة قائلاً: "فرح وجودك في الحياة، ثم فرح استمرارك بها كل يوم شيء عظيم".
* * *
حين فتحت زينب زجاج النافذة صباحاً، كانت تراقب استمرار الحياة عن كثب. أبصرت خيام النازحين، وقطعاً من ثيابهم معلقة على أغصان الشجر، امرأة تطبخ على بابور الكاز، وبنت صغيرة تبكي لأنها صارت ترى العالم بعين واحدة، ولا تقدر على لمسه لأن الحروق تملأ يديها.
هي أيضا تنتمي إليهم لأنها مهجرة، لكنها أكثر حظاً، هي تسكن في بيت وإن كان مستعاراً، بيت فيه جدران، وسقف، وباب مغلق. هكذا لا تكون مضطرة للبحث عن ماء للشرب، أو للمبيت في خيمة، والاستحمام سراً.
لما نزلت من البيت سارت من "الصنايع" نحو "شارع الحمرا". كانت تنظر إلى واجهات المحلات المغلقة، وتفتقد زحمة السير المألوفة. الشوارع شبه خالية، وهي ستذهب لرؤية ساندرا التي تسكن في أحد الشوارع الفرعية من شارع "الحمرا". شعرت بالحر وقطرات عرقها تتسرب من صدغيها لتبلل حجابها الأبيض. لم تكن تضع على وجهها أي نوع من مساحيق التجميل، حتى شفتيها كانتا جافتين من أثر الحرارة.
بدت لها الطرقات موحشة جداً، تعبق فيها رائحة البارود، الشمس ساطعة، لكن هناك غيم ثقيل أسود يسيطر في حضوره على فضاء بيروت. "شارع الحمرا" الرئيسي شبه فارغ، في ما عدا أشخاص مثلها، مدفوعين للمضي حتى في أيام الحرب، باحثين عن شيء ما. لكن هي عم تبحث؟ لماذا ترغب في السير طويلاً بلا هدف؟
صوت القذائف، غير البعيدة، يدوي بقوة، تاركاً اهتزازاً في الشارع، على الجدران، على الأرض، وفي الهواء الجامد. وجوه العابرين تنقبض، تسيل ألوانها لثوان عدة، كما لو أنها في لوحة رسام قرر فجأة تبديل السكون بالعاصفة.
في الشارع الفرعي عند مطعم "بربر" لم يكن هناك أحد أمام واجهة المحل الذي يكون مكتظاً عادة بالسيارات والمارة، الآن لا يوجد فيه سوى عدد قليل من العمال، يبدو أنهم متواجدون إما للضرورة، أو للفرار من حصار الحرب الممل. وحدها القطط تتحرك بحرية، وبلا خوف أمام القمامة الملقاة على الرصيف. وبينما هي تعبر الشارع سمعت صوتاً رجولياً تميزه جيداً ينادي باسمها، حين التفتت إلى الخلف رأت د. عبدالله يقف قرب الرصيف، ويستعد لعبور الشارع. اقترب وصافحها وهو يشد على يدها، ويلامس ذراعها بيده الأخرى، في حركة حاول أن يحملها كثيراً من المودة، أو ما يشبه الاعتذار. كانت تنظر إلى قامته الطويلة بشيء من الدهشة لرؤيته في مثل هذا اليوم، وفي هذا المكان، أحست في عينيه انكساراً لم تفهمه، لكن حين أخبرها أن البناية التي تقع فيها شقته قد سقطت بالكامل، لم تحس نحوه بأي تعاطف، غلب عليها إحساس مبهم لم تتمكن من تفسيره، ربما لأن تلك الشقة التي تعرفها جيداً قد زالت الآن عن سطح الأرض، ولم يعد لها وجود. ليس هناك باب شاهد على أنها كانت تجلس على عتبته، وهي تعرف أن صاحب الشقة في الداخل، لكنه يتركه موصداً في وجهها حتى يروق له أن يفتحه، وأحياناً لا يفعل لأن امرأة أخرى تكون برفقته. الآن لم يعد هناك جدران تشهد على الاهانات التي تلقتها يوماً لسببٍ ما لا تجد له اسماً، كما لم يعد هناك سرير غريب يحتوى جسدها إلى جانب جسد رجل كانت تحس أنها تتلاشى تماماً في وجوده. ما بقي الآن هو رجل مهزوم، يشكو لها وحدته، وتهدم شقته، ويقترح عليها رفقته من جديد.
كلام، كلام، تسمعه، وتفكر بكل ما تعنيه له تلك الشقة التي تشبه متحفاً للأصنام، للكتب، للّوحات، للتحف، لا للحياة. تذكرت كيف كان يمنعها من قراءة الكتب الموجودة في المكتبة، خشيةَ أن تغير ترتيب الكتب، وكيف اكتشفت أن كتبه عذراء تماماً، كتب وضعها في مكتبة كبيرة لأنها جزء من الشكل الاجتماعي الذي ينبغي أن يكون عليه. تذكرت اللوم والصراخ الذي انهال به عليها يوم سقطت من يدها تحفة تمثل امرأة إفريقية. كان التمثال الصغير لتلك المرأة أعز عليه منها هي بكل ما تحس به من وله أحمق نحوه.
وهي تنظر إلى عينيه الزرقاوتين، وشعره الرمادي، هالها كم تختلف المشاعر مع مرور الوقت، فكرت أنها في وقت ما كانت ترتجف من لمسة يديه، تتلقى خيانته وإهاناته من دون أي ردة فعل سوى الاستسلام، كانت تخاف أن يطردها من جنته لو اعترضت على تصرف يقوم به. لقد عاشت عامين مريضة بوهم الحب الكبير، وهم أستاذها الجامعي الذي تحلم به كل الطالبات، فيما هي الوحيدة التي حظيت بشرف زيارته، والمبيت في سريره. عامان من عمرها انقضيا وهي تنتظر اتصالاته المرتهنة لرغباته فقط، قد تحصل كل يومين، أو كل أسبوعين، أو كل شهر، فيما هي تنتظر. كانت مريضة به إلى الحد الذي يمنعها من الاعتراض.
الهواء محمل بسخونة ثقيلة عالقة بين الأرض والفضاء المفتوح، اللون الأزرق البعيد للسماء بدا بريئاً جداً، ونقياً، لا علاقة له ببارود القذائف، ولا بحكايات الوله الحاد مثل سكين باردة، مرورها على الجلد لا بد أن يسبب جرحاً. عيناها السوداوتان مثل عيون السناجب، تختزلان التفاصيل الصغيرة، لكن زينب تمضي في سماع كلمات لا تمتّ للزمن الحاضر، كلمات تعود لوقت العاصفة الشديدة التي هبت عليها ذات وقت.
الحوار الذي تبادلاه، كان عن الحرب أيضاً، حكى لها أنه يسكن في شارع "الجامعة العربية"، في شقة استأجرها منذ يومين، دعاها لزيارته بحرارة وهو يصف لها العنوان، ثم راح يسألها عن أحوالها، وعن مكان إقامتها الحالي. ردت على أسئلته ببساطتها المعتادة في التعامل معه، وفي التعامل مع الحياة، من دون أن تتطرق لجزئية الزيارة الموعودة.
بعد أن عبرا الشارع معاً، سار كل منهما في شارع فرعي، كانت تبكي وهي تسير نحو بيت "ساندرا"، خيالات تلك العلاقة تعبر أمام ذاكرتها التي لم تشْفَ تماماً من ندوب تلك الجراحات. تذكرت مازن أيضاً، كيف ساعدها على الخروج من شقة الأصنام التي دخلت في متاهتها، وتذكرت كيف سببت له ألماً كبيراً في عدم اتخاذها موقفاً واضحاً نحوه. مسحت دموعها بطرف بلوزتها الطويلة، وهي تتخيل أنها ربما تكون تسببت لمازن بالألم نفسه الذي سببه لها د. عبدالله. لكن حكايتها مع مازن كانت مختلفة تماماً. لقد أحبها مازن بأسلوب مغاير. أحب روحها المضطربة، واحتواها بكل ما فيها من جراح وحروق.
تلمع أمام عينيها الطريق الرئيسية المرصوفة بحجارة مربعة. في عينيها دموع متجمدة، وفي صدرها شهقة كبيرة مكبوتة. تتابع سيرها بخطوات سريعة، لم تلتقِ سوى رجلٍ عجوز يأكل منقوشة في الشارع، وشبّان بدا أنهم من سكان المنطقة، أو أنهم وافدون مثلها. أصوات القذائف التي تسقط على الضاحية الجنوبية تهز سكون الشارع المقفر تقريباً، فيما عدا مقهى إنترنت عند زاوية شارع "جاندارك" مزدحم بشبان وفتيات يضعون السماعات حول آذانهم، ويُجْرون محادثات عن الحرب والحب، عن المدينة التي اشتعلت بين ليلة وضحاها. كانت محلات الورد مغلقة في شارع "جاندارك". سكون ضبابي يغلف المكان بطبقة غير مرئية، في الحروب لا يفكر الناس بالورود. صعدت زينب ثلاثة طوابق نحو بيت ساندرا، كانت الكهرباء مقطوعة. استقبلتها مدام تريز بابتسامتها المعتادة التي تشبه نقشاً على قلادة. كانت زينب تتعجب من قدرتها على الابتسام في أسوأ الظروف. ربما هذا ما يعنيه الإيمان الحقيقي، أن تقْدر على منح الحب بالمطلق، من دون تأثر بالأحوال الخارجية للعالم. عندما جلست زينب على الكنبة وسألت عن ساندرا، عرفت أنها غير موجودة، وأنها ذهبت مع مجموعة من الصحفيين إلى "الضاحية الجنوبية"، كي تلتقط صوراً لما فعلته الحرب بالمكان. أحست بقشعريرة باردة، واجتاحتها رغبة بالبكاء لم تقاومها، لكنها قاومت رغبتها بالتدخين. كانت تتكلم مع مدام تريز عن الصور المتلاحقة في ذهنها، عن البيت الذي تركوه، عن أبيها الذي يلوح لها مبتسماً من مكان بعيد، عن د. عبدالله الذي التقت به في الشارع منذ قليل، وعن أمها التي تنتظر عودتها كي تحضر معها أغراض البيت. حكت أشياء كثيرة، ثم استمعت لمدام تريز تحكي لها بهدوء حكاية الراهب البوذي الذي كان معتقلاً عند الصينين، ثم بعد خروجه من السجن سأله راهب آخر: "ما أسوأ ما تعرضت له في سجنك؟"، فأجاب: "أن أفقد تعاطفي مع جلادي".
وهي تسير عائدة إلى البيت كانت تفكر بعبارة الراهب وبالقدرة على التسامح، فكرت في أنها ما تزال عاجزة عن نسيان الندوب المؤلمة. لو كانت قادرة على هذا، ربما ستتعامل مع أمها بطريقة أفضل، ستنسى التفاصيل الماضية التي تقوم بينهما مثل جدار عازل.
------------------------------
* فصل من رواية "أغنية لمارغريت" للكاتبة اللبنانية لنا عبد الرحمن الصادرة عن الدار العربية للعلوم 2011
* لنا عبد الرحمن
----------------------
تمنت مارغريت لو كانت متسولة غير مشغولة سوى بالبحث عن معيش يومها، أو غجرية غير مطلوب منها تذكر الأمكنة والوجوه والأسماء. أكثر ما يعذبها هو ذاكرتها الهرمة المثقلة بتفاصيل لا يمكن التخلص منها. منذ سنوات حين تدعو أصدقاءها من باريس إلى أمسية عشاء في منزلها، تظن أنها ستهرب من ثقل العزلة الكثيفة، لكن حين يحضرون، بعد أن يبدأ الصخب يطفو في المكان، وينتشر الأصدقاء في المطبخ والصالون، متنقلين بين البيت والحديقة، تجد نفسها أكثر عزلة، تجلس في مقعدها ذي الغطاء البيج المشجر بألوان من البني والكريم، تتكئ على هذا المقعد وفي يدها كأس من الويسكي المثلج، هي وكأسها، منذ سنوات معاً.
يان.... يان أندريا، "يا له من شاب ذي عينين مشعتين ووجه فيه براءة شاحبة". تردد هذه العبارة في داخلها وهي تلمحه يتحرك بين الضيوف، ويبتسم لها من بعد وهو يدير جهاز التسجيل على موسيقى تحبها، ثم يتجه نحوها ليمسكها من يدها ليرقصا معاً. كان ثلاثة من الأصدقاء يناقشون سياسة ميتران، بينما صديقتها، إيرما الصحافية التي بلغت الخمسين قبل شهر، تشاركهم الحديث بحماسة شديدة عن السياسة الجديدة لحزب العمال. تطوف نظرات مارغريت بينهم فيما يد يان تحيط بخصرها، تحس كم هي بعيدة عنهم، ليس هناك ما يدفع الحماس بداخلها لأي مشاركة في الكلام، تود الاستماع بصمت، تود الرقص أيضاً بين ذراعي يان.
هي وهو يشكلان لوحة غريبة، لوحة عبثية مجنونة، تكسر كل الأفكار الثابتة عن خطوات الحب، والسن، والزمن. في العلاقة مع يان، كما في العلاقة مع جسدها، لا تنتظر سوى عطاء آنياً، آنياً فقط. بينها وبين يان لا يوجد سوى "الآن" بل "الآن فقط". ماذا تريد أكثر من ذلك؟ لو حدثت معجزة استمرار "الآن"، سيحصل الكثير من الفرح، لكن هذا لن يحدث لأن الزمن يمضي، لأن الأصدقاء سيذهبون، وهي مع مرور كل يوم ستكبر يوماً. ويان أندريا أيضاً سيزداد توهجاً قبل أن يبدأ بالأفول، هو أيضاً سيكبر مثلها، هو أيضاً سيرتكب جسده نحوه خيانات مختلفة. إنها معادلة الزمن الأبدية؛ نتقدم كي نصل، نتوهج كي ننطفئ، نكبر كي نموت، نحن محاصرون بهذا الرعب رغماً عنا، ولا نملك أمامه أي سبيل للنجاة. لو منحها جسدها بعض الصمود، الوقوف عند حد معين من الخسارة، يمكنها أن تستمر أكثر، وأن تكتب أكثر. الكلمات لا يصيبها الهرم، لديها الكثير لتقوله، كتابتها ما تزال فتية وقادرة على الحياة بنشاط وسط هذا الركام. الكتابة هي الشيء الوحيد الذي ظل معها طوال الوقت... طوال الوقت، وفي كل أنواع الأحزان والمسرات.
تذكرت عبارة دانيال حين كان يقول لها: "إن ميزة الحياة في قدرتك على رؤيتها من أكثر من وجه، وإيجاد أسباب دائمة للفرح". كانت تقاطعه لتقول: "وأسباب للحزن أيضاً". يتمم عبارته المبتورة قائلاً: "فرح وجودك في الحياة، ثم فرح استمرارك بها كل يوم شيء عظيم".
* * *
حين فتحت زينب زجاج النافذة صباحاً، كانت تراقب استمرار الحياة عن كثب. أبصرت خيام النازحين، وقطعاً من ثيابهم معلقة على أغصان الشجر، امرأة تطبخ على بابور الكاز، وبنت صغيرة تبكي لأنها صارت ترى العالم بعين واحدة، ولا تقدر على لمسه لأن الحروق تملأ يديها.
هي أيضا تنتمي إليهم لأنها مهجرة، لكنها أكثر حظاً، هي تسكن في بيت وإن كان مستعاراً، بيت فيه جدران، وسقف، وباب مغلق. هكذا لا تكون مضطرة للبحث عن ماء للشرب، أو للمبيت في خيمة، والاستحمام سراً.
لما نزلت من البيت سارت من "الصنايع" نحو "شارع الحمرا". كانت تنظر إلى واجهات المحلات المغلقة، وتفتقد زحمة السير المألوفة. الشوارع شبه خالية، وهي ستذهب لرؤية ساندرا التي تسكن في أحد الشوارع الفرعية من شارع "الحمرا". شعرت بالحر وقطرات عرقها تتسرب من صدغيها لتبلل حجابها الأبيض. لم تكن تضع على وجهها أي نوع من مساحيق التجميل، حتى شفتيها كانتا جافتين من أثر الحرارة.
بدت لها الطرقات موحشة جداً، تعبق فيها رائحة البارود، الشمس ساطعة، لكن هناك غيم ثقيل أسود يسيطر في حضوره على فضاء بيروت. "شارع الحمرا" الرئيسي شبه فارغ، في ما عدا أشخاص مثلها، مدفوعين للمضي حتى في أيام الحرب، باحثين عن شيء ما. لكن هي عم تبحث؟ لماذا ترغب في السير طويلاً بلا هدف؟
صوت القذائف، غير البعيدة، يدوي بقوة، تاركاً اهتزازاً في الشارع، على الجدران، على الأرض، وفي الهواء الجامد. وجوه العابرين تنقبض، تسيل ألوانها لثوان عدة، كما لو أنها في لوحة رسام قرر فجأة تبديل السكون بالعاصفة.
في الشارع الفرعي عند مطعم "بربر" لم يكن هناك أحد أمام واجهة المحل الذي يكون مكتظاً عادة بالسيارات والمارة، الآن لا يوجد فيه سوى عدد قليل من العمال، يبدو أنهم متواجدون إما للضرورة، أو للفرار من حصار الحرب الممل. وحدها القطط تتحرك بحرية، وبلا خوف أمام القمامة الملقاة على الرصيف. وبينما هي تعبر الشارع سمعت صوتاً رجولياً تميزه جيداً ينادي باسمها، حين التفتت إلى الخلف رأت د. عبدالله يقف قرب الرصيف، ويستعد لعبور الشارع. اقترب وصافحها وهو يشد على يدها، ويلامس ذراعها بيده الأخرى، في حركة حاول أن يحملها كثيراً من المودة، أو ما يشبه الاعتذار. كانت تنظر إلى قامته الطويلة بشيء من الدهشة لرؤيته في مثل هذا اليوم، وفي هذا المكان، أحست في عينيه انكساراً لم تفهمه، لكن حين أخبرها أن البناية التي تقع فيها شقته قد سقطت بالكامل، لم تحس نحوه بأي تعاطف، غلب عليها إحساس مبهم لم تتمكن من تفسيره، ربما لأن تلك الشقة التي تعرفها جيداً قد زالت الآن عن سطح الأرض، ولم يعد لها وجود. ليس هناك باب شاهد على أنها كانت تجلس على عتبته، وهي تعرف أن صاحب الشقة في الداخل، لكنه يتركه موصداً في وجهها حتى يروق له أن يفتحه، وأحياناً لا يفعل لأن امرأة أخرى تكون برفقته. الآن لم يعد هناك جدران تشهد على الاهانات التي تلقتها يوماً لسببٍ ما لا تجد له اسماً، كما لم يعد هناك سرير غريب يحتوى جسدها إلى جانب جسد رجل كانت تحس أنها تتلاشى تماماً في وجوده. ما بقي الآن هو رجل مهزوم، يشكو لها وحدته، وتهدم شقته، ويقترح عليها رفقته من جديد.
كلام، كلام، تسمعه، وتفكر بكل ما تعنيه له تلك الشقة التي تشبه متحفاً للأصنام، للكتب، للّوحات، للتحف، لا للحياة. تذكرت كيف كان يمنعها من قراءة الكتب الموجودة في المكتبة، خشيةَ أن تغير ترتيب الكتب، وكيف اكتشفت أن كتبه عذراء تماماً، كتب وضعها في مكتبة كبيرة لأنها جزء من الشكل الاجتماعي الذي ينبغي أن يكون عليه. تذكرت اللوم والصراخ الذي انهال به عليها يوم سقطت من يدها تحفة تمثل امرأة إفريقية. كان التمثال الصغير لتلك المرأة أعز عليه منها هي بكل ما تحس به من وله أحمق نحوه.
وهي تنظر إلى عينيه الزرقاوتين، وشعره الرمادي، هالها كم تختلف المشاعر مع مرور الوقت، فكرت أنها في وقت ما كانت ترتجف من لمسة يديه، تتلقى خيانته وإهاناته من دون أي ردة فعل سوى الاستسلام، كانت تخاف أن يطردها من جنته لو اعترضت على تصرف يقوم به. لقد عاشت عامين مريضة بوهم الحب الكبير، وهم أستاذها الجامعي الذي تحلم به كل الطالبات، فيما هي الوحيدة التي حظيت بشرف زيارته، والمبيت في سريره. عامان من عمرها انقضيا وهي تنتظر اتصالاته المرتهنة لرغباته فقط، قد تحصل كل يومين، أو كل أسبوعين، أو كل شهر، فيما هي تنتظر. كانت مريضة به إلى الحد الذي يمنعها من الاعتراض.
الهواء محمل بسخونة ثقيلة عالقة بين الأرض والفضاء المفتوح، اللون الأزرق البعيد للسماء بدا بريئاً جداً، ونقياً، لا علاقة له ببارود القذائف، ولا بحكايات الوله الحاد مثل سكين باردة، مرورها على الجلد لا بد أن يسبب جرحاً. عيناها السوداوتان مثل عيون السناجب، تختزلان التفاصيل الصغيرة، لكن زينب تمضي في سماع كلمات لا تمتّ للزمن الحاضر، كلمات تعود لوقت العاصفة الشديدة التي هبت عليها ذات وقت.
الحوار الذي تبادلاه، كان عن الحرب أيضاً، حكى لها أنه يسكن في شارع "الجامعة العربية"، في شقة استأجرها منذ يومين، دعاها لزيارته بحرارة وهو يصف لها العنوان، ثم راح يسألها عن أحوالها، وعن مكان إقامتها الحالي. ردت على أسئلته ببساطتها المعتادة في التعامل معه، وفي التعامل مع الحياة، من دون أن تتطرق لجزئية الزيارة الموعودة.
بعد أن عبرا الشارع معاً، سار كل منهما في شارع فرعي، كانت تبكي وهي تسير نحو بيت "ساندرا"، خيالات تلك العلاقة تعبر أمام ذاكرتها التي لم تشْفَ تماماً من ندوب تلك الجراحات. تذكرت مازن أيضاً، كيف ساعدها على الخروج من شقة الأصنام التي دخلت في متاهتها، وتذكرت كيف سببت له ألماً كبيراً في عدم اتخاذها موقفاً واضحاً نحوه. مسحت دموعها بطرف بلوزتها الطويلة، وهي تتخيل أنها ربما تكون تسببت لمازن بالألم نفسه الذي سببه لها د. عبدالله. لكن حكايتها مع مازن كانت مختلفة تماماً. لقد أحبها مازن بأسلوب مغاير. أحب روحها المضطربة، واحتواها بكل ما فيها من جراح وحروق.
تلمع أمام عينيها الطريق الرئيسية المرصوفة بحجارة مربعة. في عينيها دموع متجمدة، وفي صدرها شهقة كبيرة مكبوتة. تتابع سيرها بخطوات سريعة، لم تلتقِ سوى رجلٍ عجوز يأكل منقوشة في الشارع، وشبّان بدا أنهم من سكان المنطقة، أو أنهم وافدون مثلها. أصوات القذائف التي تسقط على الضاحية الجنوبية تهز سكون الشارع المقفر تقريباً، فيما عدا مقهى إنترنت عند زاوية شارع "جاندارك" مزدحم بشبان وفتيات يضعون السماعات حول آذانهم، ويُجْرون محادثات عن الحرب والحب، عن المدينة التي اشتعلت بين ليلة وضحاها. كانت محلات الورد مغلقة في شارع "جاندارك". سكون ضبابي يغلف المكان بطبقة غير مرئية، في الحروب لا يفكر الناس بالورود. صعدت زينب ثلاثة طوابق نحو بيت ساندرا، كانت الكهرباء مقطوعة. استقبلتها مدام تريز بابتسامتها المعتادة التي تشبه نقشاً على قلادة. كانت زينب تتعجب من قدرتها على الابتسام في أسوأ الظروف. ربما هذا ما يعنيه الإيمان الحقيقي، أن تقْدر على منح الحب بالمطلق، من دون تأثر بالأحوال الخارجية للعالم. عندما جلست زينب على الكنبة وسألت عن ساندرا، عرفت أنها غير موجودة، وأنها ذهبت مع مجموعة من الصحفيين إلى "الضاحية الجنوبية"، كي تلتقط صوراً لما فعلته الحرب بالمكان. أحست بقشعريرة باردة، واجتاحتها رغبة بالبكاء لم تقاومها، لكنها قاومت رغبتها بالتدخين. كانت تتكلم مع مدام تريز عن الصور المتلاحقة في ذهنها، عن البيت الذي تركوه، عن أبيها الذي يلوح لها مبتسماً من مكان بعيد، عن د. عبدالله الذي التقت به في الشارع منذ قليل، وعن أمها التي تنتظر عودتها كي تحضر معها أغراض البيت. حكت أشياء كثيرة، ثم استمعت لمدام تريز تحكي لها بهدوء حكاية الراهب البوذي الذي كان معتقلاً عند الصينين، ثم بعد خروجه من السجن سأله راهب آخر: "ما أسوأ ما تعرضت له في سجنك؟"، فأجاب: "أن أفقد تعاطفي مع جلادي".
وهي تسير عائدة إلى البيت كانت تفكر بعبارة الراهب وبالقدرة على التسامح، فكرت في أنها ما تزال عاجزة عن نسيان الندوب المؤلمة. لو كانت قادرة على هذا، ربما ستتعامل مع أمها بطريقة أفضل، ستنسى التفاصيل الماضية التي تقوم بينهما مثل جدار عازل.
------------------------------
* فصل من رواية "أغنية لمارغريت" للكاتبة اللبنانية لنا عبد الرحمن الصادرة عن الدار العربية للعلوم 2011
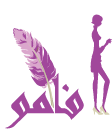

 من نحن
من نحن أشواك الورد
أشواك الورد قصاصات.كوم
قصاصات.كوم متابعات
متابعات فضاء للبوح
فضاء للبوح سرديات
سرديات قصائد
قصائد آراء حرة
آراء حرة في المرآة
في المرآة الأسوأ
الأسوأ دليل فامو
دليل فامو Boutique FaMoh
Boutique FaMoh Café FaMoh
Café FaMoh إتصل بنا
إتصل بنا