سرديات عودة
أحمر قانٍ (الخميس 2 شباط 2012)
* مها حسن
-------------------------------------------
حين وصل إبراهيم، تنفّست القرية الصعداء.
كان من المحال فصل المولودة عن جسد المقتولة.
اقتنع الجميع، بأن إبراهيم فقط، من يمكنه فعل هذا. كان الجسد الميت يحتضن الجسد الحيّ بقوة، وكأنه ملتصق به، كأنهما جسد واحد.
أنين الميتة لم يتوقف. لا أحد يعرف من أين يخرج هذا الصوت، فهو لا يصدر عن صدرها المتوقف عن التنفس. أنين موجع مؤلم. كلما أنّ الصوت، أنّت الأجراس معه. جوقة أنين تسبب الذعر والتوتر والخوف، كأنه عقاب متواصل.
اقترب إبراهيم من جسد سلطانة. وضع يده الحانية على جبينها، فسمع تنهداتها. تنهدات مختلطة من ألم الافتقاد والفرح معاً. سمع جميع سكان القرية ذلك الصوت.. تنهيدة عميقة، تشبه آه الارتياح المعجونة بالحزن. ارتياح الميت وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة، متخلصاً من عذاب طلوع الروح، خائفاً في الوقت ذاته، من مفارقة الحياة. ذلك الألم المرعب الذي نادراً ما يستطيع العالقون بين الحياة والموت وصفه، لسرعته، فهو حالة طفيفة، شفافة..ألم يسبح صاحبه في داخله، ألم شفاف، كأن" الطالعة روحه" محبوس داخل كتلة هواء كثيفة، أو مستلقٍ فوق سحابة ماء ..جسده خفيف، أو ميت ، وقد توقفت أنفاسه عن التحرك. إلا أن روحه تطوف حول جسده، حول المكان الذي يحبه، حول أصدقائه وأحبائه وأهله.. روح تتألم وترغب بالتصديق، بأنها غادرت جسدها، وانتهت مهمتها الحياتية. أن عليها الابتعاد عن الجسد وتركه يغوص تحت التربة.
أنّت سلطانة وكادت دموعها الناشفة تطفر من عينيها الميتتين، من شدة التأثر، إلا أن الموت، حرم عينيها لذة الدمع الأخير، دمع الفرح بالخلاص،خلاص عذاب الجسد.
" تألمتُ كثيرا يا إبراهيم. رأيتهم يذبحونني. جزّوا عنقي وكأنني خروف. أتذكَّر يا إبراهيم، حين كنت أرى الكبار يذبحون الخراف أو الدجاج أو الأرانب، كنتُ أُصاب بالغثيان. لم أكن أتحمّل منظر الدم. لكنهم ذبحوني يا إبراهيم. تألمتُ كثيراً، تألمتُ على مراحل. تألمتُ خوفا حين أخذوا عنقي ورموني والسكين تلتمع تحت عينيّ.. تقيأتُ من الخوف، صعدت معدتي إلى رأسي. كان جسدي يرتجف كأنه ورقة خفيفة أمام الإعصار، لم أتمكن من الوقوف على قدميّ.. لقد قرأتُ قليلا عن أحكام الإعدام. عن القتل، ولكنني لم أقرأ أبدا عن الذبح، لم أقرأ عن أوجاع المذبوح. لو أنهم رموني من أعلى جبل، أو خنقوني، أو أحرقوني.. آه ه ه ه ... آه أخرى ندّت عن سلطانة.. لا ، الحرق أيضاً صعب، والخنق صعب، الموت صعب، الموت مقتولاً صعب.. نعم، خفتُ.. خفتُ على مراحل، تألمتُ على مراحل. تألمتُ خوفا. ثم تألمتُ ألماً حقيقيا، ألم الذبح..حين راحت السكين تمشي على عنقي..كأنها منشار تحزّ لوح خشب لا روح فيه ولا إحساس..
قبل أن يذبحوني ،توجعت خوفاً من الموت.
توجعت وهم يذبحونني.
توجعت وأنا أرى رأسي يسقط عن جسدي..
لا يمكنني أن أصف لك مراحل الوجع، كل مرحلة صعبة، ما من واحدة أصعب أو أقل صعوبة.. لكل مرحلة عذاباتها. أيحدثوننا عن عذاب القبر؟ أظنني تذوقت كل أنواع التعذيب.
ذبحوني، ورأيت رأسي يتدحرج. لا ، لأكن أكثر دقة، فأنت لن تسمع هذا الكلام مني مرة أخرى. لم أرَ رأسي يتدحرج، بل رأيت العالم يتحرج، شعرت برأسي يتدحرج، ورأيت جسمي..رأيته أمامي، دوني، دون رأسي. وشعرت مجددا بالغثيان، ولكن كيف أغثي؟ معدتي منفصلة عن رأسي، وأمعائي ظلت هناك، مع جسمي.
علّقوا رأسي على البوابة، كنت أحسّ بدمائي تتقاطر مني، كما لو أنني قبعة مغسولة، لم أُعْصَرْ جيداً.. مبللة بالكثير من الدم..أنقّط ،أنا لا القبعة، بل الرأس.
لكنه الحب يا إبراهيم.. الحب المباغت الذي شعرت به بقوة كبيرة وأنا أنظر إلى طفلتي، كومة لحم مرمية قبالتي..أعادتني إلى جسدي. إنها معجزة يا إبراهيم..عاد رأسي وركب فوق جسدي. لقد متُّ وعدت ثانية..لا تدفنني يا إبراهيم ..لا أريد الذهاب بعيداً، لا أريد النزول إلى عتمة القبر، إلى الرطوبة. كيف تحرمني من الشمس؟ تعرف كم أنا متعلقة بالشمس ، بالبريّة، بالياسمينة، بالخبيزة والنرجس والشقشقيق.. كيف تضعني في العتمة، وتطمرني بالتراب.. لتأكل الديدان جسدي، وتعبث الجرذان بشعري وعظامي ودمي.. أخاف من الجرذان يا إبراهيم، أخاف من العتمة، أخاف من البرد، أخاف من الموت يا إبراهيم..أنا خائفة .
آههههههههه طويلة، هزت ذبذباتها القوية القرية وكأنها مسّت السماء.
ـ إلا أنك ميتة سلطانة..لقد متِّ، يجب عليك تقبل الأمر. أجابها إبراهيم.
ـ إذا كنت ميتة، فكيف أتحدث إليك وتسمعني؟
ـ إنها روحك سلطانة، الروح التي لا تموت أبداً.
ـ روحي حية إذن؟
ـ الروح خالدة يا حبيبتي.
ـ ولكنني أريد البقاء هنا، معك ومع ابنتي،لا أريد الذهاب بعيدا عنكما،أخاف على الصغيرة.
ـ أفهمك حبيبتي، ولو كنت أستطيع فعل أي شيء لبقائك هنا لفعلت، ولكن الأمر قضي..لا يستطيع الموتى مشاركة الأحياء حياتهم.اذهبي أيتها الغالية، وأنا أعدك بالاعتناء بالصغيرة.
ـ كما لو أنني هنا؟
ـ نعم.
ـ ستحدثها عني؟
ـ طبعا.
ـ وإن وقعتْ في الحب ذات يوم، فستحميها، تحمي حبها وحياتها. عدني بهذا، لا يجب ألا يقتلوا ابنتي كما قتلوني، لا يمكن أن أموت مرتين.
ـ أعدك.. سأحمي حبها وحياتها.. هذا وعد سلطانة، وعد من إبراهيم الذي أحبك وحدك وسيحبك حتى مماته.
ـ سوف تعلمها الحب، وتحكي لها عن حبنا.
ـ نعم، سأفعل، ارتاحي أنت واعتمدي علي..أعدك.
ـ وحين ذات يوم، تبلغ، وتغادر عذريتها، كفراشة تخرج من الشرنقة، سوف تروي الزيزفونة بدماء عذريتها، أتفعل؟
ـ نعم، سأفعل.
ـ هذا عهد بيننا إبراهيم.
ـ هذا عهد سلطانة..أعطِني الصغيرة الآن، وارحلي بهدوء.
ـ خذها.. إنها أمانة بين يديك، أنا لا أثق في غيرك، وليس لها غيرك.
ـ أعدك بحمايتها، لن يمسها سوء، وستعيش سعيدة.. سعيدة كما تشتهين لها.
انحنى بلطف نحوها وأخذ الصغيرة من بين ذراعيها.
دفن إبراهيم جسد حبيبته سلطانة تحت شجرة الزيزفون، كما طلبتْ منه. ما أن توقفت الصغيرة عن البكاء، حتى توقف على الفور ضجيج أجراس الورود السحرية، أو الورود" الجرسية".
أخذ إبراهيم صغيرته، حامياً إياها من كل آثام وجرائم العالم، والتجأ بها، منعزلا عن كل الآخرين، في البرية، حيث ولدت قصة حبه الكبيرة، تلك التي خلقت طفلته هذه.
لم يجد إبراهيم لابنته مكانا أكثر أمناً من كوخ تميمة ذاته. كما لو أنه حل محلها. سكن في كوخها وتقاسم أغراضها مع صغيرته.
تحول إبراهيم إلى رجل زاهد. تخلى عن الحياة وبهجتها، ولم يعد يهمه العيش إلا لمتابعة عيش الصغيرة. رسالته الباقية، التي سمح من أجلها لأنفاسه بالصعود والهبوط داخل صدره، هو الحفاظ على هذه النبتة التي تركتها سلطانة أمانة لديه. لم يتمكن من تقبل الحياة الكريهة الظالمة، ولكن، من أجل هذه الصغيرة، ترك جسده يحيا، بينما هامت روحه مندسة تحت شجرة الزيزفون، متجولة من هناك، في حديقة المنزل، إلى هنا، في البرية، متنقلة بين سلطانة الراقدة تحت شجرة الزيزفون، وصغيرتهما، التي راحت تمصّ إصبعها تعويضا عن حلمة أمها الراحلة. كان عليه أن يحيا ليرقب أمنهما، أمن المستلقية في الحديقة،بروحها ترقب صغيرتها، وأمن الصغيرة التي صار وحده مسؤولاً عنها.
لتمضية الزمن الممل، الحياة الواقعية، الشروق والغروب، الليل والنهار.. للتخلص من وطأة الزمن الكريه،استعان إبراهيم بالشعر. كان يكتب الشعر ويغنيه، لتحمل ثقل العيش الذي أُجبر على متابعته، إخلاصا لعهد قطعه لحبيبته.
راجت سمعة قصائده وطارت كلماتها في أرجاء المعمورة. صار الصغار والكبار يرددون كلمات تلك الأغاني التي تقطّع القلب، وتخلق سعادة غامضة، سعادة تتسببّ ببكاء مبهم،لذيذ،ممتع.. سعادة مصحوبة بأناقة عالية، أناقة الحب المقتول، المدفون..وخاصة أغنيته المذهلة " تحت شجرة الزيزفون ترقد حبيبتي لتحيك شال الصوف الأخضر"، أصبحت بمثابة أغنية متكررة يستعملها العشاق للتدليل على الفقدان، وبقاء الحبيبة رغم الموت.
الصوفي الأشهر، في تلك الحقبة كان "الشيخ إبراهيم". لا يعرف أحد من أين أتاه لقب الشيخ، وهو لا يصلي ولا يعرف الأديان. حتى أن أحداً لم يرَه، بل تخيلوه فقط، إذ أنه أصرّ دوما على الاحتجاب والعيش داخل ظلمة الكوخ، لا يخرج إلا في الليل، أو حين يتأكد من خلو البرية، تماما كوحش يخاف البشر، يخافه البشر ويهابونه. صار إبراهيم أكثر قداسة وغرابة وامتلك هيبة تجاوزت تميمة ذاتها، كأن حلوله في كوخها، وصورة المرأة الراقدة تحت شجرة الزيزفون تحيك الشال الأخضر لصغيرتها، صنعا من إبراهيم أيقونة مختلفة للوفاء والحب والطاقات الخارقة لرؤية البشر والحياة.. الحكمة التي يبحث عنها كل نهم للمعرفة، لمعرفة ذاته ومستقبله. صار إبراهيم رمزا للحب الخارق، الحب الذي يجعل الكثيرين يقسم بأنه سمع تنهيدات راضية مستمتعة تأتي من تحت شجرة الزيزفون.
كثرت الأقاويل عن إبراهيم، وأضافت عليها مخيلة الناس تفاصيل غير واقعية. لا ننكر أنه تحوّل إلى وحش يعيش في تلك الفلاة، حيث لم يحلق لحيته منذ رحيل حبيبته ونزولها للاستلقاء تحت شجرة الزيزفون.
صار منظره أشبه بوحوش الغابات، وصار الناس بمرور الأيام يخافون الذهاب إلى البرية، حتى كاد يصبح المالك الوحيد لذلك القفر الواسع. صار يخرج في بعض النهارات، متأكداً من أن لا أحد يجرؤ على وضع قدمه في مملكته.
كان بعض الصبية الجسورين، يتسللون إلى البرية، ويتلصصون من خلف أشجار التوت والصنوبر والجوز.. قابعين ساعات وساعات بانتظار خروج أيقونة البرية.. حين كان أحدهم، وبعد ساعات، وربما أيام من السكون هناك، يلمح ذلك الرجل الضخم، خارجاً من الكوخ الخشبي، حاملا "طنبوره"، جالساً تحت أشعة الشمس، مغنياً قصائده التي لا بد أن يرد فيها ذكر سلطانة.. فإن تلك اللحظات الاستثنائية تكون بمثابة الحج، إذ يمكن لذلك الرائي، المختبئ خلف الشجرة، أن يطلب من السماء ما يشتهي ويتمنى، فيتحقق حلمه، وتستجيب السماء لذلك الدعاء.
هكذا راحت الصغيرة تكبر وحيدة في تلك البرية، لا تعرف عن الحياة سوى هذا الامتداد الشاسع، وهذا الرجل الضخم، ذو اللحية الطويلة، وحيوانات وأشجار وعناصر البرية.. كانت وإبراهيم، الكائنين الوحيدين، البشريين، في تلك الفلاة الواسعة المنزوية، البعيدة.
--------------------------
فصل من رواية "بنات البراري" للروائية السورية مها حسن الصادرة عن دار رياض الريس 2011
* مها حسن
-------------------------------------------
حين وصل إبراهيم، تنفّست القرية الصعداء.
كان من المحال فصل المولودة عن جسد المقتولة.
اقتنع الجميع، بأن إبراهيم فقط، من يمكنه فعل هذا. كان الجسد الميت يحتضن الجسد الحيّ بقوة، وكأنه ملتصق به، كأنهما جسد واحد.
أنين الميتة لم يتوقف. لا أحد يعرف من أين يخرج هذا الصوت، فهو لا يصدر عن صدرها المتوقف عن التنفس. أنين موجع مؤلم. كلما أنّ الصوت، أنّت الأجراس معه. جوقة أنين تسبب الذعر والتوتر والخوف، كأنه عقاب متواصل.
اقترب إبراهيم من جسد سلطانة. وضع يده الحانية على جبينها، فسمع تنهداتها. تنهدات مختلطة من ألم الافتقاد والفرح معاً. سمع جميع سكان القرية ذلك الصوت.. تنهيدة عميقة، تشبه آه الارتياح المعجونة بالحزن. ارتياح الميت وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة، متخلصاً من عذاب طلوع الروح، خائفاً في الوقت ذاته، من مفارقة الحياة. ذلك الألم المرعب الذي نادراً ما يستطيع العالقون بين الحياة والموت وصفه، لسرعته، فهو حالة طفيفة، شفافة..ألم يسبح صاحبه في داخله، ألم شفاف، كأن" الطالعة روحه" محبوس داخل كتلة هواء كثيفة، أو مستلقٍ فوق سحابة ماء ..جسده خفيف، أو ميت ، وقد توقفت أنفاسه عن التحرك. إلا أن روحه تطوف حول جسده، حول المكان الذي يحبه، حول أصدقائه وأحبائه وأهله.. روح تتألم وترغب بالتصديق، بأنها غادرت جسدها، وانتهت مهمتها الحياتية. أن عليها الابتعاد عن الجسد وتركه يغوص تحت التربة.
أنّت سلطانة وكادت دموعها الناشفة تطفر من عينيها الميتتين، من شدة التأثر، إلا أن الموت، حرم عينيها لذة الدمع الأخير، دمع الفرح بالخلاص،خلاص عذاب الجسد.
" تألمتُ كثيرا يا إبراهيم. رأيتهم يذبحونني. جزّوا عنقي وكأنني خروف. أتذكَّر يا إبراهيم، حين كنت أرى الكبار يذبحون الخراف أو الدجاج أو الأرانب، كنتُ أُصاب بالغثيان. لم أكن أتحمّل منظر الدم. لكنهم ذبحوني يا إبراهيم. تألمتُ كثيراً، تألمتُ على مراحل. تألمتُ خوفا حين أخذوا عنقي ورموني والسكين تلتمع تحت عينيّ.. تقيأتُ من الخوف، صعدت معدتي إلى رأسي. كان جسدي يرتجف كأنه ورقة خفيفة أمام الإعصار، لم أتمكن من الوقوف على قدميّ.. لقد قرأتُ قليلا عن أحكام الإعدام. عن القتل، ولكنني لم أقرأ أبدا عن الذبح، لم أقرأ عن أوجاع المذبوح. لو أنهم رموني من أعلى جبل، أو خنقوني، أو أحرقوني.. آه ه ه ه ... آه أخرى ندّت عن سلطانة.. لا ، الحرق أيضاً صعب، والخنق صعب، الموت صعب، الموت مقتولاً صعب.. نعم، خفتُ.. خفتُ على مراحل، تألمتُ على مراحل. تألمتُ خوفا. ثم تألمتُ ألماً حقيقيا، ألم الذبح..حين راحت السكين تمشي على عنقي..كأنها منشار تحزّ لوح خشب لا روح فيه ولا إحساس..
قبل أن يذبحوني ،توجعت خوفاً من الموت.
توجعت وهم يذبحونني.
توجعت وأنا أرى رأسي يسقط عن جسدي..
لا يمكنني أن أصف لك مراحل الوجع، كل مرحلة صعبة، ما من واحدة أصعب أو أقل صعوبة.. لكل مرحلة عذاباتها. أيحدثوننا عن عذاب القبر؟ أظنني تذوقت كل أنواع التعذيب.
ذبحوني، ورأيت رأسي يتدحرج. لا ، لأكن أكثر دقة، فأنت لن تسمع هذا الكلام مني مرة أخرى. لم أرَ رأسي يتدحرج، بل رأيت العالم يتحرج، شعرت برأسي يتدحرج، ورأيت جسمي..رأيته أمامي، دوني، دون رأسي. وشعرت مجددا بالغثيان، ولكن كيف أغثي؟ معدتي منفصلة عن رأسي، وأمعائي ظلت هناك، مع جسمي.
علّقوا رأسي على البوابة، كنت أحسّ بدمائي تتقاطر مني، كما لو أنني قبعة مغسولة، لم أُعْصَرْ جيداً.. مبللة بالكثير من الدم..أنقّط ،أنا لا القبعة، بل الرأس.
لكنه الحب يا إبراهيم.. الحب المباغت الذي شعرت به بقوة كبيرة وأنا أنظر إلى طفلتي، كومة لحم مرمية قبالتي..أعادتني إلى جسدي. إنها معجزة يا إبراهيم..عاد رأسي وركب فوق جسدي. لقد متُّ وعدت ثانية..لا تدفنني يا إبراهيم ..لا أريد الذهاب بعيداً، لا أريد النزول إلى عتمة القبر، إلى الرطوبة. كيف تحرمني من الشمس؟ تعرف كم أنا متعلقة بالشمس ، بالبريّة، بالياسمينة، بالخبيزة والنرجس والشقشقيق.. كيف تضعني في العتمة، وتطمرني بالتراب.. لتأكل الديدان جسدي، وتعبث الجرذان بشعري وعظامي ودمي.. أخاف من الجرذان يا إبراهيم، أخاف من العتمة، أخاف من البرد، أخاف من الموت يا إبراهيم..أنا خائفة .
آههههههههه طويلة، هزت ذبذباتها القوية القرية وكأنها مسّت السماء.
ـ إلا أنك ميتة سلطانة..لقد متِّ، يجب عليك تقبل الأمر. أجابها إبراهيم.
ـ إذا كنت ميتة، فكيف أتحدث إليك وتسمعني؟
ـ إنها روحك سلطانة، الروح التي لا تموت أبداً.
ـ روحي حية إذن؟
ـ الروح خالدة يا حبيبتي.
ـ ولكنني أريد البقاء هنا، معك ومع ابنتي،لا أريد الذهاب بعيدا عنكما،أخاف على الصغيرة.
ـ أفهمك حبيبتي، ولو كنت أستطيع فعل أي شيء لبقائك هنا لفعلت، ولكن الأمر قضي..لا يستطيع الموتى مشاركة الأحياء حياتهم.اذهبي أيتها الغالية، وأنا أعدك بالاعتناء بالصغيرة.
ـ كما لو أنني هنا؟
ـ نعم.
ـ ستحدثها عني؟
ـ طبعا.
ـ وإن وقعتْ في الحب ذات يوم، فستحميها، تحمي حبها وحياتها. عدني بهذا، لا يجب ألا يقتلوا ابنتي كما قتلوني، لا يمكن أن أموت مرتين.
ـ أعدك.. سأحمي حبها وحياتها.. هذا وعد سلطانة، وعد من إبراهيم الذي أحبك وحدك وسيحبك حتى مماته.
ـ سوف تعلمها الحب، وتحكي لها عن حبنا.
ـ نعم، سأفعل، ارتاحي أنت واعتمدي علي..أعدك.
ـ وحين ذات يوم، تبلغ، وتغادر عذريتها، كفراشة تخرج من الشرنقة، سوف تروي الزيزفونة بدماء عذريتها، أتفعل؟
ـ نعم، سأفعل.
ـ هذا عهد بيننا إبراهيم.
ـ هذا عهد سلطانة..أعطِني الصغيرة الآن، وارحلي بهدوء.
ـ خذها.. إنها أمانة بين يديك، أنا لا أثق في غيرك، وليس لها غيرك.
ـ أعدك بحمايتها، لن يمسها سوء، وستعيش سعيدة.. سعيدة كما تشتهين لها.
انحنى بلطف نحوها وأخذ الصغيرة من بين ذراعيها.
دفن إبراهيم جسد حبيبته سلطانة تحت شجرة الزيزفون، كما طلبتْ منه. ما أن توقفت الصغيرة عن البكاء، حتى توقف على الفور ضجيج أجراس الورود السحرية، أو الورود" الجرسية".
أخذ إبراهيم صغيرته، حامياً إياها من كل آثام وجرائم العالم، والتجأ بها، منعزلا عن كل الآخرين، في البرية، حيث ولدت قصة حبه الكبيرة، تلك التي خلقت طفلته هذه.
لم يجد إبراهيم لابنته مكانا أكثر أمناً من كوخ تميمة ذاته. كما لو أنه حل محلها. سكن في كوخها وتقاسم أغراضها مع صغيرته.
تحول إبراهيم إلى رجل زاهد. تخلى عن الحياة وبهجتها، ولم يعد يهمه العيش إلا لمتابعة عيش الصغيرة. رسالته الباقية، التي سمح من أجلها لأنفاسه بالصعود والهبوط داخل صدره، هو الحفاظ على هذه النبتة التي تركتها سلطانة أمانة لديه. لم يتمكن من تقبل الحياة الكريهة الظالمة، ولكن، من أجل هذه الصغيرة، ترك جسده يحيا، بينما هامت روحه مندسة تحت شجرة الزيزفون، متجولة من هناك، في حديقة المنزل، إلى هنا، في البرية، متنقلة بين سلطانة الراقدة تحت شجرة الزيزفون، وصغيرتهما، التي راحت تمصّ إصبعها تعويضا عن حلمة أمها الراحلة. كان عليه أن يحيا ليرقب أمنهما، أمن المستلقية في الحديقة،بروحها ترقب صغيرتها، وأمن الصغيرة التي صار وحده مسؤولاً عنها.
لتمضية الزمن الممل، الحياة الواقعية، الشروق والغروب، الليل والنهار.. للتخلص من وطأة الزمن الكريه،استعان إبراهيم بالشعر. كان يكتب الشعر ويغنيه، لتحمل ثقل العيش الذي أُجبر على متابعته، إخلاصا لعهد قطعه لحبيبته.
راجت سمعة قصائده وطارت كلماتها في أرجاء المعمورة. صار الصغار والكبار يرددون كلمات تلك الأغاني التي تقطّع القلب، وتخلق سعادة غامضة، سعادة تتسببّ ببكاء مبهم،لذيذ،ممتع.. سعادة مصحوبة بأناقة عالية، أناقة الحب المقتول، المدفون..وخاصة أغنيته المذهلة " تحت شجرة الزيزفون ترقد حبيبتي لتحيك شال الصوف الأخضر"، أصبحت بمثابة أغنية متكررة يستعملها العشاق للتدليل على الفقدان، وبقاء الحبيبة رغم الموت.
الصوفي الأشهر، في تلك الحقبة كان "الشيخ إبراهيم". لا يعرف أحد من أين أتاه لقب الشيخ، وهو لا يصلي ولا يعرف الأديان. حتى أن أحداً لم يرَه، بل تخيلوه فقط، إذ أنه أصرّ دوما على الاحتجاب والعيش داخل ظلمة الكوخ، لا يخرج إلا في الليل، أو حين يتأكد من خلو البرية، تماما كوحش يخاف البشر، يخافه البشر ويهابونه. صار إبراهيم أكثر قداسة وغرابة وامتلك هيبة تجاوزت تميمة ذاتها، كأن حلوله في كوخها، وصورة المرأة الراقدة تحت شجرة الزيزفون تحيك الشال الأخضر لصغيرتها، صنعا من إبراهيم أيقونة مختلفة للوفاء والحب والطاقات الخارقة لرؤية البشر والحياة.. الحكمة التي يبحث عنها كل نهم للمعرفة، لمعرفة ذاته ومستقبله. صار إبراهيم رمزا للحب الخارق، الحب الذي يجعل الكثيرين يقسم بأنه سمع تنهيدات راضية مستمتعة تأتي من تحت شجرة الزيزفون.
كثرت الأقاويل عن إبراهيم، وأضافت عليها مخيلة الناس تفاصيل غير واقعية. لا ننكر أنه تحوّل إلى وحش يعيش في تلك الفلاة، حيث لم يحلق لحيته منذ رحيل حبيبته ونزولها للاستلقاء تحت شجرة الزيزفون.
صار منظره أشبه بوحوش الغابات، وصار الناس بمرور الأيام يخافون الذهاب إلى البرية، حتى كاد يصبح المالك الوحيد لذلك القفر الواسع. صار يخرج في بعض النهارات، متأكداً من أن لا أحد يجرؤ على وضع قدمه في مملكته.
كان بعض الصبية الجسورين، يتسللون إلى البرية، ويتلصصون من خلف أشجار التوت والصنوبر والجوز.. قابعين ساعات وساعات بانتظار خروج أيقونة البرية.. حين كان أحدهم، وبعد ساعات، وربما أيام من السكون هناك، يلمح ذلك الرجل الضخم، خارجاً من الكوخ الخشبي، حاملا "طنبوره"، جالساً تحت أشعة الشمس، مغنياً قصائده التي لا بد أن يرد فيها ذكر سلطانة.. فإن تلك اللحظات الاستثنائية تكون بمثابة الحج، إذ يمكن لذلك الرائي، المختبئ خلف الشجرة، أن يطلب من السماء ما يشتهي ويتمنى، فيتحقق حلمه، وتستجيب السماء لذلك الدعاء.
هكذا راحت الصغيرة تكبر وحيدة في تلك البرية، لا تعرف عن الحياة سوى هذا الامتداد الشاسع، وهذا الرجل الضخم، ذو اللحية الطويلة، وحيوانات وأشجار وعناصر البرية.. كانت وإبراهيم، الكائنين الوحيدين، البشريين، في تلك الفلاة الواسعة المنزوية، البعيدة.
--------------------------
فصل من رواية "بنات البراري" للروائية السورية مها حسن الصادرة عن دار رياض الريس 2011
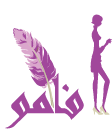

 من نحن
من نحن أشواك الورد
أشواك الورد قصاصات.كوم
قصاصات.كوم متابعات
متابعات فضاء للبوح
فضاء للبوح سرديات
سرديات قصائد
قصائد آراء حرة
آراء حرة في المرآة
في المرآة الأسوأ
الأسوأ دليل فامو
دليل فامو Boutique FaMoh
Boutique FaMoh Café FaMoh
Café FaMoh إتصل بنا
إتصل بنا