سرديات عودة
فصل من رواية توابل المدينة لحميد عبد القادر (الخميس 9 حزيران 2016)
حميد عبد القادر
كانت المسافة بين حانوت عمي إبراهيم الميزابي، وبيت السيدة جنات بعمارة البُرجوازيين، بحي سَانْ كْلُو، طويلة، ومتعرجة، لكني قطعتها خلال ذلك المساء الفظيع الذي شهد مقتلها، كأنها بضعة أمتار. فعلت ذلك سريع الخطوة، حتى أتعجل وصولي إليها. قفزت على البرك المائية المتناثرة، وانعطفت في المنعرجات بنفس السرعة تقريبا. لم تكن برودة الطقس هي التي كانت تدفعني للجري، ولا المطر المنهمر غزيرا، وهو يبلل جسدي النحيف. كُنت أجري للعودة مسرعا إلى بيت السيدة. كانت السعادة تغمرني، وفي يدي شموع عيد ميلادها الخمسين، وقد لفها عمي إبراهيم الرجل الطيب بعناية في ورق الجرائد.
مررت على مقهى ملاكوف عند شارع العُلج علي. شممت رائحة الشاي بالنعناع، وقهوة الحَب وهي تُحمص. وصلني حديث رواده المرتفع، الذي يصل إلى الخارج، بلكناته المحتدمة التي يسميها قدماء الحي هدرة الهوزية.عرجت على حوانيت باعة التوابل. تلك التي كانت في ما مضى ملكا لتجار يهود غادروا المدينة مع الأقدام السوداء. نزح بعضهم إلى إسرائيل، واستقر آخرين في مدن ساحلية بجنوب فرنسا، بين نيس وأونتيب، فاشتراها منهم محاربين غنموا في الحرب أموالا، احتفظوا بها بعد أن احتاروا لمن يسلموها من الجماعات المتناحرة في ذلك الصيف القائظ، الذي شهد صراعا دمويا على السلطة. كلما مررت بالقرب من حوانيت التوابل، إلا وأبطأت السير، وأخذت أشم روائح الكمون، والزعفران، والفلفل الأسود، والعكري، وهي تدغدغ أنفي، فأعطس أحيانا وأمر سالما معافى أحيانا أخرى. ثم انعطفت جهة اليسار. سرت في شارع الثورة المتروك لحاله، مُهملا، وذات الأشجار الوارفة الظليلة، والخالي من المارة، إلا من بعض الشيوخ الجالسين بمقهى النجم، المعتمرين شاشيات أسطمبول حمراء اللون، تتدلى خيوطها الحريرية السوداء إلى الوراء، مرتدين بذل أنيقة، يستعيدون ذكرياتهم الماضية، ويتحسرون عليها. سمعت الحاج إسماعيل يصيح. توقفت، فوصلني كلامه:”قلت لكم إن الخراب يزحف على المدينة”. لم أفهم شيئا من كلامه. جريت مجددا. استمعت لصخب مطرقة مسعود الكوردونيي الذي حارب في الجبل سبع سنوات، ثم انضم لزمرة انهزمت خلال الحرب الأهلية، فوجد نفسه مرقعا للأحذية في مكان منزو قرب مقهى النجم، يعمل فيه طوال فصول السنة، وهو مطاطأ الرأس، صامتا لا يفصح ولا يبوح بشيء. مشيت رأسا إلى حي سان كلو عبر شارع بن مهيدي، الذي كان يسمى في ما مضى شارع الماريشال سانت أرنو. اصطدمت برجل غريب طويل القامة، قوي البنية، لم يسبق لي وأن شاهدته في الحي. سقط من جيب معطفه سكينا موضوعا في غمد جلدي. التقطه بسرعة، وأعاده إلى جيبه. اعتذرت له، رمقني بنظرة عنيفة، واستأنفت الجري من غير أن ألتفت ورائي.
ولجت مدخل العمارة، وغصت وسط العتمة. صعدت السلالم جريا ومثنى، من غير أن أتعثر. غير آبه بالصاعد ولا بالنازل. بلغت الطابق الثالث بسرعة. أخذت أدق على الباب. أنفاسي كانت تتسارع. لم تفتح لي السيدة جنات. أثرت الانتظار حتى أستعيد أنفاسي. قفزت قليلا. وضعت أصبعي على زر الجرس الصغير العالي. لم تفتح لي كذلك. وضعت يدي على المقبض الدائري. دفعت الباب. وجدته مفتوحا. فتحتهُ. استمعت لعزف موسيقي كلاسيكي، ينبعث من غرامون السيدة. دخلتُ. سرتُ في الردهة المظلمة قليلا، بخطى وئيدة، على بساط أحمر طويل. تقدمت إلى الصالون. أبصرت في تلك اللحظة المُقدرة، والطويلة، والمفجعة، السيدة جنات وهي ملقاة على الأرض، ورجلا غريبا (هو ذلك الرجل الذي اصطدمت به للتو في شارع بن مهيدي) يغرس سكينا في أحشائها بلا رحمة، ثم وضعه على قلبها، وغرسه بالحقد ذاته. فنقلها إلى العالم الأخر جثة هامدة.
شعرت أن براءتي تحطمت وانكسرت على صخرة الحماقة، بعد أن شاهدت تلك الجريمة المروعة. اكتشف فجأة أن الجنة وجهنم متقاربتان. لا يفصل بينهما سوى خيط رفيع. كان الحدث بمثابة لحظة مروعة قضت على براءتي، ووضعتني، دون ارادة مني، هكذا عنوة، عند الجانب الأخر من الحياة، ذلك الجانب الفظيع الذي يحفر أثارا عميقة، ويدفع الإنسان للسؤال عن جدوى مجيئه إلى الكون لكي يشقى، ويتعذب، ويتحمل المصائب، ويشاهد حماقات المجبولين على الإيذاء والشر ماثلة أمام أعينه.
ما زلت أستعيد تفاصيل ما جرى كأنها وقعت بالأمس. أستعيد نظرة السيدة وهي تتوسل إلي. تمد يدها اليمنى نحوي بحثا عن نجدة قد تجعلها باقية على قيد الحياة. وأنا بالكاد أقوى على الحركة. ثابت في سكوني غير قادر على فعل أي شيء. أنظر إليها برأفة، وأستمع للعزف الموسيقي المنبعث من غرامون وُضعَ على طاولة صغيرة من الأكاجو، كانت تدور عليه أسطوانة كبيرة. أدركت أنه عزف كلاسيكي لموزار طالما حدثتني عنه السيدة. إني أراها الآن مجددا. في لحظة النفس الأخير. أو لحظة المأساة. كانت تفارق الحياة، وأنا واقف مشدوها أستمع لأوبيرا دون جيوفاني بحزنها، ولحظة القلق التي تنبعث منها، بينما تسقط السيدة في الأخير جثة هامدة مليئة بالدم. يرتطم كامل جسدهاعلى أرضية الصالون ذي الأرضية الخشبية. شاهدت عيناها تدمعان وهي تفارق الحياة، ووجهها ترتسم عليه علامات الألم، مشيرة بأصبعها إلى خزانة من الخشب الأحمر التي تضع فيها أشياء في غاية الأهمية، أخبرتني عنها ذات يوم، وأرتني المكان الذي تضع فيه مفتاح الخزانة.
احتفظ المجرم بسكينه في يده، لما شعر بوجودي. أخرجه من قلبها. رأيته مليئا بدم السيدة. راح يسيل إلى غاية مرفقه. انفتحت نافذة الصالون فجاة، بفعل هبوب رياح قوية، وحملت إلى غاية السقف ستائرها البيضاء، ثم بعثرتها يمينا وشمالا. رمقني القاتل بنظرة قاسية، فظة، طاغية، ووحشية. فعل ذلك بعينيه السوداويين الصغيرتين الشبيهتان بحبات زيتون بري، واللتان ينبعث منهما حقدا مخيفا. أشعرتني تلك النظرة بارتعاش في كامل جسدي، وملئتني ذعرا. صرت كأني فقدت دربي، وسرت في ظلام دامس، فإرتجت الأرض تحت قدامي. سقطت شموع عيد ميلاد السيدة من يدي. تبعثرت على الأرضية الخشبية. ساورتني رغبة في الاختفاء. ملئني مزيدا من الخوف. سحقني. أبكاني. جعلني أفقد القدرة على التحرك. تسمرت. تحجرت. شاهدت الشر المطلق مجسدا في ذلك المجرم، واكتشفت الجانب الخفي من الحياة. ذلك الجانب الشرير والفظيع، الذي لم يكن لطفل في سني ليكتشفه لولا درجة الشر التي ملئت قاتل السيدة. وبقي ذلك الاكتشاف منغرسا في ذاكرتي يرفض أن يبرح تلابيبها. أستعيده على شكل كوابيس تقض مضجعي، وتحرمني من النوم لساعات طويلة على مدى عدة سنوات.
بقي اللحن الأوبيرالي يدوي في أرجاء الصالون. تتصاعد وتيرة حزنه، وتشتد، وأنا أشاهد المجرم متوجها نحوي بقامته الطويلة، ووجهه المخيف، طويلا كأنه عملاق، وفي صورة وحش يريد أن يفترسني. حاولت الفرار، لكن بدون جدوى. لأن الخوف أفقدني القدرة على التحرك. كنت أرتعد إلى حد جعلني أفقد القدرة على أي وثبة قد تبعدني من الفاجعة التي كانت ماثلة أمامي. بلغ المجرم مرحلة الحنق والتذمر. انبعث العنف من عينيه، كشرر متطاير. كان يرتدي ملابس رثة. سترة سوداء، وسروال بني. تقدم نحوي. شممت رائحة العرق وهي تنبعث منه. مسكني من قفاي. ألمني. كانت يده غليظة. صلبة. أضافره طويلة، مليئة بالأوساخ. هددني، قائلا:”أسكت”. بدا صوته كأنه يشبه خوار فظيع يملأ المكان، ويضفي عليه حالة من التيه والضياع. جعلني أتخيل الكون من حولي سائرا على غير هُدى. أصبحت بلا قوة. كل شيء في جسدي غدا ثقيلا. سكتت. لم أقو على الكلام، وأنا جاثم في مكاني. لم أخالف ما كان يريده مني. كدت أتبول في سروالي. بينما يده ما تزال تمسكني من قفاي بنفس القسوة. بدأت أتنفس بصعوبة. بكيت. قرر إخلاء سبيلي فجأة. نزع يده. تنفست هواء مثقلا بدم السيدة التي هوت يدها اليمنى في هذه اللحظة. لقد ماتت. برزت عيناها. بقيتا معلقتان على السقف، وأصبع يدها اليمنى موجهة نحو الخزانة المصنوعة من الخشب الأحمر.
في تلك الأثناء، شهدت نانا فاطمة، زوجة سيد علي الميصاليست جارنا. كانت قادمة من بيتها الواقع مقابل بيت السيدة. لم تكن ترتدي سوى لباسا خفيفا. بقيت بدورها ساكنة في مكانها من شدة هول ما مثل أمامها. فزعت. لم تعد تملك أي قدرة على خطو خطوات أخرى، ولا حتى العودة إلى بيتها، وإقفال الباب. صاحت بكل القوة التي استجمعتها. دوي صياحها في أرجاء العمارة. خرج باقي الجيران مسرعين. تجمعوا. فر المجرم. قفز كوحش مفترس. صعدت مسرعا إلى بيتنا في الطابق الأعلى. أمي التي كانت تهم بالخروج، بعد أن سمعت الصياح، فتحت لي الباب. لاحظت الخوف الذي كان مرتسما على وجهي الممتقع. طلبت مني أن أخبرها بما جرى لي. عجزتُ عن الكلام. دخلتُ غرفتي. نزلت هي لمعرفة ما كان يحدث. لما عادت، كانت تبكي. دخلت غرفتي. وجدتني في فراشي، وفرائصي ما تزال ترتعد. خافت علي من أن يصيبني مكروه، فضمتني إلى صدرها. وبكيت معها.
لزمت غرفتي أسبوعا كاملا. لا أرى الخارج سوى من النافذة. فقدت القدرة على النطق. حالتي جعلت أمي وأبي يظنان أنني مريض. بدا متأثرين جدا لمقتل السيدة. سمعت والدي يردد بنبرة حزينة، ومُكدرة، اثر عودته من المقبرة في اليوم الموالي أن السيدة جنات كانت إنسانة رفيعة، وسخية. وأنهم دفنوها تحت ظلال شجرة صفصاف، في مكان عال يطل على البحر. شاهدته يمسح ماء المطر المتصبب من شعره، ويقول متأثرا… “إن الإله سيخصص للسيدة مكانا في الجنة”… و”إن المجرم الذي قتلها بتلك الطريقة الشنيعة، والفظيعة سينال عقابه”. ثم سمعته يدعو بالنكبة على المجرم، ويدعو الإله بأن يسلط عليه أشد العقاب.
2
لازمني مشهد مقتل السيدة جنات طيلة حياتي. انغرس كواقعة ضارية، سيئة، وعنيدة. صورة المجرم لم تبرح ذاكرتي أبدا. ترسخ حضورها نهائيا وبشكل دائم. انغرست في نفسي، وملئتني بعذابات مؤلمة، يصعب تحملها. تختفي أحيانا، وتعاود الظهور أحيانا أخرى على مر السنين. كانت تبرز على شكل كوابيس تقض مضجعي. تؤرقني. وتنغص حياتي، مستحوذة على مساحات الصفاء والهدوء. وما زاد من عذابي بعد رحيلها، ومن شدة حزني لفراقها، أنني لم أعد أستمع لموسيقى ذلك المؤلف الشهير الذي يدعى فولفغانغ أمادييوس موزار، وهي تنبعث عذبة، سلسة من شقتها لتتغلغل في أرجاء العمارة، وتتسرب إلى شقتنا، وقد عبرت الجدران، لتستقر في كياني، وتسكن روحي، وتنزل عليه سكونا وهدوءا، وتغمره إحساسا باكتشاف لحظة ممتعة، عامرة بالسعادة، محفوفة بالمتعة، ولها وقع مختلف في حياتي. شعرت كما لو أن كل شيء من حولي ضئيل أمام روعة ذلك اللحن النقي الذي مدني بحيوية غير مرئية، غير ملموسة، صامتة كأنها تنزل من السماء، وهي ليست بالسماوية، بل هي جزء من الجانب الإلهي على الأرض.
كنت ماكثا في غرفتي، أنتظر عودة والدي، لما استمعت أول مرة للحن أوبيرالي، يصل مسامعي. كان قادما من حيث لم أكن أدري حينها. كنت حزينا وخائفا على والدي. خرج منذ الصباح الباكر، ولم يعد. كانت الساعة الثامنة ليلا، لما بدأت أمي ترتبك، وتفقد صبرها. اتصلت بالجيران. أخبرتهم باختفاء زوجها. بحثوا عنه في مقهى ملاكوف أين يقضي النهار بطوله، وتلك كانت عادة دأب عليها منذ انتهاء الحرب، بعد أن أحالوه على التقاعد وهو برتبة رائد. بحثوا عنه في كل مكان، فلم يعثروا عليه. قيل إنهم لم يشاهدوه طيلة اليوم. لم يجدوا له أثرا. خافت أمي. ارتبكت. بكت كثيرا، وهي تنتظر. تصورت أمورا مخيفة، فظيعة، ومفجعة تكون قد ألمت بوالدي، فقد وقعت حوادث مؤلمة لم يكن يتصوها أحد آنذاك بعد رحيل الرومي. ورغم ذلك جرت، ووقعت أمورا فظيعة بسبب ممارسات الشرطة السياسية التي كانت تتلقى أوامر من قبل السيد الرئيس بإلقاء القبض على كل المحاربين القدامى الذين عارضوا حكمه، والزج بهم في سجون الصحراء القاسية، والقصية، والفظيعة، دون إخبار عائلاتهم، ولا زوجاتهم بمكان تواجدهم. كان يتركهم في حيرة من أمرهم أياما طويلة. يتعذبون. يبكون. يناشدون المقربين منه لاطلاق سراح أبنائهم. قيل إنه يفعل ذلك حتى يصنع لنفسه هالة وسط الناس، ويبدو كحاكم مخيف، وينقل معارضيه إلى حالة من الرعب بمجرد ذكر اسمه. اعتقدنا أن والدي لقي نفس المصير.
والحق أن كثير من رموز الحرب ضد الرومي، لم يسلموا من هذه الممارسات التي نقلها السيد الرئيس إلى البلاد، ليقضي على فرحة التخلص من الأقدام السوداء، ويخطف نشوة الانتصار من محاربين قضوا سبع سنوات ونصف، وهم يحاربون بلا هوادة. كان رجلا طيبا مع الفقراء، لكنه لم يرحم خصومه السياسيين.
نساء العمارة جئن لمواساة والدتي، والتخفيف من شدة هلعها. جلسن معها في الصالون، بينما دخلتُ غرفتي، وجلستُ أمام النافذة المشرعة، ورحت أنتظر رؤية والدي عائدا إلى البيت سالما معافى. اندهشت، وأنا أشاهد جنودا، ودبابات مركونة عند مدخل الحي، وأناس يهرولون في كل الاتجاهات، وعلامات الخوف مرتسمة على وجوههم. بينما كنت على ذلك الوضع من القلق والاضطراب وصلني ذلك اللحن الزاخر بالعذوبة، والمليء بالتناقضات، يتخذ لحظات مختلفة، متباينة، تارة يصعد إلى فضاء سام، وراق كالجنة، وتارة أخرى ينزل إلى ما يشبه جهنم، في لحظة فاصلة قصيرة، ثم يتناوب بين الفرح والحزن. وكنت أتخيل مشاهد غريبة، أستوحيها من ذلك اللحن، على شكل تخيلات أرى فيها صراعا بين الخير والشر. الشر يتربص بالخير، ويريد الإنقضاض عليه ومحو أثره. وكانت السيمفونية تجري وفق مستويات مختلفة. ينتصر الشر أحيانا، ويستعيد الخير مكانته أحيانا أخرى.
نسيت همومي للحظة بدت لي مختلفة، وأنا أتابع تلك النوتات الموسيقية، التي يليها غناء السوبرانو وهو ينشد ألحانا عذبة، راقية ورومانسية. وفجأة، عند اقتراب الغروب، لمحت والدي عائدا. شاهدته يمشي بتثاقل. انتزعتني عودته من تخيلاتي. انطلقت بسرعة نحو الصالون. أخبرت أمي بعودته. قلت لها والدي في الطريق. لم تصدق. بقيت تبحلق في. ولما أكدتُ لها ما شاهدته، غادرت مكانها، وقد تغيرت ملامح وجهها. اندفعت نحو الباب. فتحته بسرعة. ألقت نظرة إلى الأسفل، ثم التفتت إلينا. وضعت يديها على صدرها، فاستراحت. عادت إلى الصالون بدون الاضطراب الذي ارتسم على محياها. في هذه الأثناء خرجت النسوة اللواتي جئن لمواساتها. دخل أبي متعبا. جلس على الأريكة إلى جانب أمي. سألته عن سبب تأخره. طلب منها أن تصبر. شاهدته وهو يلمح لها بأن تنتظر حتى أنام ليطلعها عن كل شيء.
كان اللحن الأوبيرالي المنبعث من شقة السيدة جنات قد توقف. خيم الصمت. لم أعد أنظر إلى السماء، وإلى كل الكون من حولي، بتلك النظرة المغايرة التي كانت ترافق المعزوفة الموسيقية. بدا لي كل شيء عاديا وطبيعيا. السماء مكفهرة خالية من الغيوم. نسمات البحر القادمة من جهة الغرب باردة، وشارع بن مهيدي أمامي كان خاليا من المارة، ولم يبق فيه سوى العسكر، الذين راحوا يدخنون، ويتبادلون أطراف الحديث، وهم متكئون على الدبابات، ورشاشاتهم تتدلى على أكتافهم.
في صباح اليوم الموالي، قبل أن ينهض والدي، أخبرتني أمي، وأنا جالس معها في الصالون، أن انقلابا عسكريا وقع أمس، فألقوا القبض على كل اليساريين المتعاطفين مع الرئيس بن. ب. ولما سألتها إن كان والدي متعاطفا معه، أجابت:”لا، أبدا. لقد اعتقلوه خطأ، فأطلقوا سراحه بسرعة”.
انتظرت سماع اللحن الموسيقي مجددا. وبينما كنت أنتظر، دخل والدي الصالون، فسمعت أمي تقول له:
_ هل ضربوك؟
فرد قائلا:
_ لا. لم يضربن أحد. كلموني بخشونة في البداية. ولما اكتشفوا أن الكوميسير حمادوش كان معي في الجبل خلال الحرب، وحارب إلى جانبي في نفس الكتيبة، عاملوني بشكل مغاير. حتى أن أحدهم اعتذر لي، بعد أن انتهى من استجوابي، ولم يقدر حتى على رفع رأسه.
ثم سألته والدتي مجددا:
_ وهل طالبت مقابلة الكوميسير.
رد والدي:
_ لا، رفضت.
فسألت أمي مرة أخرى:
_ لماذا؟
صمت والدي هذه المرة، وتأخر رده، وبعد لحظات قضاها ساهيا، زائغ العينين، قال:
_ لأنه لم يعد رفيقي. الظروف فرقت بيننا. ناضلنا سويا. حاربنا في الجبل جنبا لجنب، ثم افترقنا. تحمل هو مشاهدة التجاوزات التي وقعت، وأصبح طرفا في الانحراف، بينما لم أقدر أنا على اقتراف مثل هذا الجرم. تحطمت رومانسيته، وانكسرت، وتحول إلى رجل قادر على إيذاء إخوانه، من أجل أفكار يعتقد أنها صائبة، وغير قابلة للنقاش. والحق أن مثل هذا السلوك تعلمناه في الجبل. لم يكن يحق لنا مناقشة أي أوامر يصدرها القائد. ننفذ التعليمات في صمت وخنوع مطلق، ليس للشخص بل للقيم الثورية التي يجسدها القائد. وتلك مسألة يمكن تفهمها. ظروف الحرب والحياة السرية لم تكن تسمح بالنقاش. لأن حياتنا كانت قاسية. والعيش في السرية لم يعطينا هامشا مريحا للمناقشة. لكن بعد انتهاء الحرب، ما كان يجب ترك الأمور على هذا المنوال. كان يجب توفير مناخا مقبولا للنقاش، وذلك ما لم يحدث. كنت أتصور أن الحرب تعني الثورة، وتعني لحظة تجعلنا نتخلى عن الشياطين التي تغلغلت إلينا، بينما تصرف هو كأنها مجرد حرب بدون ثورة، ولا قيم ثورية. مجرد معركة لإخراج الأقدام السوداء. هنا يكمن الاختلاف بيننا، وهو اختلاف في الجوهر جعلنا نفترق. كنت أفكر في الثورة. وكان هو يريد الحاق الهزيمة بالفرنسيين وطردهم. افترقنا بعد ان كنا صديقين حميمين، لن نلتقي مجددا، ولن تعود المياه إلى مجراها، إلا إذا أعاد النظر في مواقفه. لهذا رفضت طلب مقابلته، وتركتهم يحققون معي كما يريدون.
لم تسأله أمي مجددا، فهي تعرف اللحظة التي يجب أن تتوقف فيها حتى لا تقلب مواجعه، وتزيد من شدة حزنه وآلامه. كانت تعرف أنه رجلا تائها، ضل وجهته، فخابت أماله، جراء الانحراف الذي وقع بعد انتهاء الحرب.
والحق، أن أوضاع والدي تأزمت، وقاربت الانهيار، وسارت إلى حيث لم يكن يتصور أبدا، بعد مشاركته في الحرب الأهلية الثانية، التي قادها أحد رفقاء السيد الرئيس سابقا. أخرج بذلته العسكرية من الخزانة ذات ليلة باردة. ودع والدتي، وأخبرها أنه قرر الصعود إلى الجبل ثانية. ارتبكت، وبدت علامات الخوف على وجهها، فسألته:
_ لماذا؟
ربت على كتفها، فقال:
_ سنخوض حربا من أجل إزاحة الديكتاتور.
صعد والدي إلى الجبل ثانية، ليخوض حربا مريرة ضد قوات السيد الرئيس. وانضم إلى معارض اشتراكي يدعى حسين مرابط.
في الصباح الباكر، لما نهضت من النوم، سألت والدتي:
_ أنيذاث بابا ؟(أين والدي؟).
فردت أمي:
_ يروح أرثمورث أديلقظ أزمور (سافر إلى البلد لجني الزيتون).
انتظرت طويلا، ولم يعد والدي بسرعة كعادته. افتقدته، وحزنت كثيرا. سألت أمي مجددا:
_ أيوقث أراديوغال بابا؟ (متى يرجع والدي؟).
فأجابت:
_ قريب.
انتهت الحرب الأهلية بسرعة، وعاد والدي محطما مكسورا، وبلا قفة الزيتون. دخل البيت كأنه شخص أخر. نحف جسمه كثيرا، وكاد يسقط أرضا وهو يستقبلني بين ذراعيه. حدق في أمي مليا، وقال لها، وهو يضمني اليه:
_ انتهت الحرب، وانتصر الديكتاتور.
وبينما أنا بين ذراعيه، سألت نفسي:
_ لماذا ينهزم والدي دائما، رغم أنه رجل طيب؟
3
المدينة تخاف من الغرباء. ترتجف إن ساروا على أرضيتها بأحذية خشنة، ودكوها دكا.
المدينة امرأة رقيقة، تحب من يداعبها.
لما وطأت قدما قاتل السيدة جنات المدينة لأول مرة، مساء يوم خريفي، كانت الشمس تغيب. اختفت السحب الممطرة التي ملأت السماء قبل أن ينزل من سيارة الأجرة. أبعدتها الرياح جهة الغرب. كان يرتدي قشابية بنية من الوبر. انتعل حذاءا أسود من الكاوتشو، واعتمر بونيه أسود مثقوب، لفه بشاش أبيض غطى شعره المتموج. راح يسير كالغريب بقامته الطويلة، ومنكبيه العريضين. أخذ يحدق، ويمعن النظر في المدينة البيضاء التي يراها لأول مرة بعينيه الصغيرتين السوداويتين، وكأنه يتربص بها، كما يتربص الصقر بفريسته. كان ينظر إليها بضراوة، واستعد لها بشراهة الجائع.
لا أحد كان في انتظاره. لم يكن يعرف أحدا في المدينة. سائق سيارة الأجرة الذي نقله من محطة القطار، رفقة ثلاثة ركاب آخرين، كتب له عنوان نزل من الدرجة الثالثة على ورق علبة سجائر البسطوس. كتبه بالعربية. سلمه لزبونه. وضعه هو في جيب سرواله، ولم يعط لنفسه عناء قراءة ما كتب على ورقة السجائر.
قرر أن لا يتكل سوى على غريزته. راح يمشي بخطى مسرعة. بدا متلهفا. أراد أن يتحرر حتى من حقيبته السوداء التي وضع فيها أغراضه، حتى يسرع الخطى، ويصل إلى قلب المدينة ليكتشفها لأول مرة.
زحف عليها مثل من يتحرش بها. صعد إليها كأنه خرج من قاع الأرض، بينما ارتسمت خيوط الليل الأولى. كان واثقا من نفسه، رغم غرابته عن المكان. صعد من الميناء حيث تركه سائق الأجرة، إلى وسط المدينة دون أن يلتفت ورائه، ويمعن النظر في البحر الهادئ، ولا في غروب الشمس. ترك البحر ومنظر الغروب ورائه، وراح يصعد السلالم الإسمنتية النظيفة بدون عناء، حتى أنه أخذ يجري بينما باقي المارة يصعدون بروية. كان متعطشا للوصول. كأنه أراد أن يغزو المدينة في الحال.
توقف بمجرد أن انتهى من الصعود، وبلغ ساحة واسعة تحيطها أشجار وارفة. كان يتصبب عرقا، وأحس بهيجان في داخله، لأنه أجبر على التوقف لتأمل المكان الذي لم تطأه قدماه أبدا. تناهت إلى مسامعه الآن صفارة باخرة تستعد للإبحار، وعلى متنها أناس فضلوا الرحيل إلى مدن الغرب الباردة، تاركين ورائهم مدينة ولدوا بها لغرباء جاؤوها بحثا عن ثمرات الثورة. رفع رأسه، وأخذ يحدق في المدينة العتيقة المعلقة على هضبة جعلتها تطل على البحر. عبرت أنفه نسمات البحر، ولم يبال بها. نسمة الجو الوحيدة التي يعرفها هي نسمات المناطق الجرداء الحارة.
مشى وسط مارة كانوا يسيرون ببطء. قرر أن يُسرع خطوه. رائحة عطر الفتيات اليافعات أثارت غريزته الجنسية. تمنى لو يسحق جسد احدهن، ويبدأ صعوده إلى القمة على جسد امرأة يروي بها عطشه الجنسي دون أن يتزوجها، بل يجعلها عشيقة يعبث بها ويلهو متى شاء. كان يعتقد أن المدينة هي بؤرة للفساد، يكثر فيه الانحلال، ويسهل على الرجال التمتع بمضاجعة النساء، وقت ما يشاء. فلماذا لا يتمتع بدوره بكل المتع التي طالما سمع عنها.
ظل يمشي، ولا أحد اهتم به. الناس في المدينة تعودوا على زحف غرباء مثله. أصبح ذلك جزءا من حياتهم، ومنظرا ألفوه. منذ أن رحل الكولون مطأطئ الرؤوس. خانعين. مقهورين. مهزومين. دخل أزقتها وشوارعها آلاف الأشخاص مثله يذرعون الشوارع النقية بحثا عن عمل، أو يجلسون في مقاهي ما تزال تحتفظ برونقها وبهائها، فيضفون عليها مظاهر الانحطاط بسلوكياتهم الفظة والقاسية.
في الليلة الباردة، التي أخبر فيها أهله بأنه يستعد لمغادرة الشعبة والنزوح إلى المدينة، كان جالسا معهم في البطحة بمحاذاة مسجد لم يكتمل بنائه. تجمعوا مثلما تعودوا بعد الغروب، وانزووا في برانسهم الوبرية، لاتقاء البرد. قال له عمه، الشيخ أحمر الخد، محاولا أن يثنيه عن قراره:
– إنهم أناس متكبرون يا بَرهُوم. متعجرفون. سيكرهونك حال وصولك إلى هناك. بمجرد أن تطأ قدماك المدينة يرمقونك بنظرات عدائية. أعرف جيدا هؤلاء البشر، إنهم من طينة مختلفة تماما، وهم ورثة طبائع الكولون لعنهم الرب.
وقال له والده:
-عمك يقول كلاما صائبا. إن تكبر هؤلاء، وعجرفتهم، لا مثيل له. عاشوا مع الكولون وأصبحوا مثلهم. ويقال إنهم لا يصمون رمضان والعياذ بالله. ولا يصلي عندهم سوى الشيوخ. أما الشبان فيقضون أوقاتهم في الحانات التي تركها لهم الرومي. مساجدهم فارغة. ونسائهم يدخنن السجائر، ويتخذن لهن عشاقا مثل الروميات.
لا أحد تمكن من ثنيه عن قراره. سيذهب إلى المدينة، ويعيش هناك. لم يبد أي تردد، ولا خوف. تصلب وجهه، وقال:
-أعرف كيف أروضهم، لا تقلقوا.
صمت برهة، وأضاف:
– لن أذهب إلى هناك لكي أخدمهم. وأنحني برأسي أمامهم. سأذهب إلى المدينة لكسب المال، وأتمتع بفضائل الاستقلال مثلهم. تلك الخيرات ليست حكرا عليهم لوحدهم. أنا ذاهب لكي أصبح سيدا عليهم، وليس خادما عندهم.
صمت برهة، ثم واصل كلامه، وهو يضرب الأرضية الترابية برجله اليمنى
الرواية صادرة عن منشورات الحكمة في الجزائر 2014م.
التعليق
حميد عبد القادر
كانت المسافة بين حانوت عمي إبراهيم الميزابي، وبيت السيدة جنات بعمارة البُرجوازيين، بحي سَانْ كْلُو، طويلة، ومتعرجة، لكني قطعتها خلال ذلك المساء الفظيع الذي شهد مقتلها، كأنها بضعة أمتار. فعلت ذلك سريع الخطوة، حتى أتعجل وصولي إليها. قفزت على البرك المائية المتناثرة، وانعطفت في المنعرجات بنفس السرعة تقريبا. لم تكن برودة الطقس هي التي كانت تدفعني للجري، ولا المطر المنهمر غزيرا، وهو يبلل جسدي النحيف. كُنت أجري للعودة مسرعا إلى بيت السيدة. كانت السعادة تغمرني، وفي يدي شموع عيد ميلادها الخمسين، وقد لفها عمي إبراهيم الرجل الطيب بعناية في ورق الجرائد.
مررت على مقهى ملاكوف عند شارع العُلج علي. شممت رائحة الشاي بالنعناع، وقهوة الحَب وهي تُحمص. وصلني حديث رواده المرتفع، الذي يصل إلى الخارج، بلكناته المحتدمة التي يسميها قدماء الحي هدرة الهوزية.عرجت على حوانيت باعة التوابل. تلك التي كانت في ما مضى ملكا لتجار يهود غادروا المدينة مع الأقدام السوداء. نزح بعضهم إلى إسرائيل، واستقر آخرين في مدن ساحلية بجنوب فرنسا، بين نيس وأونتيب، فاشتراها منهم محاربين غنموا في الحرب أموالا، احتفظوا بها بعد أن احتاروا لمن يسلموها من الجماعات المتناحرة في ذلك الصيف القائظ، الذي شهد صراعا دمويا على السلطة. كلما مررت بالقرب من حوانيت التوابل، إلا وأبطأت السير، وأخذت أشم روائح الكمون، والزعفران، والفلفل الأسود، والعكري، وهي تدغدغ أنفي، فأعطس أحيانا وأمر سالما معافى أحيانا أخرى. ثم انعطفت جهة اليسار. سرت في شارع الثورة المتروك لحاله، مُهملا، وذات الأشجار الوارفة الظليلة، والخالي من المارة، إلا من بعض الشيوخ الجالسين بمقهى النجم، المعتمرين شاشيات أسطمبول حمراء اللون، تتدلى خيوطها الحريرية السوداء إلى الوراء، مرتدين بذل أنيقة، يستعيدون ذكرياتهم الماضية، ويتحسرون عليها. سمعت الحاج إسماعيل يصيح. توقفت، فوصلني كلامه:”قلت لكم إن الخراب يزحف على المدينة”. لم أفهم شيئا من كلامه. جريت مجددا. استمعت لصخب مطرقة مسعود الكوردونيي الذي حارب في الجبل سبع سنوات، ثم انضم لزمرة انهزمت خلال الحرب الأهلية، فوجد نفسه مرقعا للأحذية في مكان منزو قرب مقهى النجم، يعمل فيه طوال فصول السنة، وهو مطاطأ الرأس، صامتا لا يفصح ولا يبوح بشيء. مشيت رأسا إلى حي سان كلو عبر شارع بن مهيدي، الذي كان يسمى في ما مضى شارع الماريشال سانت أرنو. اصطدمت برجل غريب طويل القامة، قوي البنية، لم يسبق لي وأن شاهدته في الحي. سقط من جيب معطفه سكينا موضوعا في غمد جلدي. التقطه بسرعة، وأعاده إلى جيبه. اعتذرت له، رمقني بنظرة عنيفة، واستأنفت الجري من غير أن ألتفت ورائي.
ولجت مدخل العمارة، وغصت وسط العتمة. صعدت السلالم جريا ومثنى، من غير أن أتعثر. غير آبه بالصاعد ولا بالنازل. بلغت الطابق الثالث بسرعة. أخذت أدق على الباب. أنفاسي كانت تتسارع. لم تفتح لي السيدة جنات. أثرت الانتظار حتى أستعيد أنفاسي. قفزت قليلا. وضعت أصبعي على زر الجرس الصغير العالي. لم تفتح لي كذلك. وضعت يدي على المقبض الدائري. دفعت الباب. وجدته مفتوحا. فتحتهُ. استمعت لعزف موسيقي كلاسيكي، ينبعث من غرامون السيدة. دخلتُ. سرتُ في الردهة المظلمة قليلا، بخطى وئيدة، على بساط أحمر طويل. تقدمت إلى الصالون. أبصرت في تلك اللحظة المُقدرة، والطويلة، والمفجعة، السيدة جنات وهي ملقاة على الأرض، ورجلا غريبا (هو ذلك الرجل الذي اصطدمت به للتو في شارع بن مهيدي) يغرس سكينا في أحشائها بلا رحمة، ثم وضعه على قلبها، وغرسه بالحقد ذاته. فنقلها إلى العالم الأخر جثة هامدة.
شعرت أن براءتي تحطمت وانكسرت على صخرة الحماقة، بعد أن شاهدت تلك الجريمة المروعة. اكتشف فجأة أن الجنة وجهنم متقاربتان. لا يفصل بينهما سوى خيط رفيع. كان الحدث بمثابة لحظة مروعة قضت على براءتي، ووضعتني، دون ارادة مني، هكذا عنوة، عند الجانب الأخر من الحياة، ذلك الجانب الفظيع الذي يحفر أثارا عميقة، ويدفع الإنسان للسؤال عن جدوى مجيئه إلى الكون لكي يشقى، ويتعذب، ويتحمل المصائب، ويشاهد حماقات المجبولين على الإيذاء والشر ماثلة أمام أعينه.
ما زلت أستعيد تفاصيل ما جرى كأنها وقعت بالأمس. أستعيد نظرة السيدة وهي تتوسل إلي. تمد يدها اليمنى نحوي بحثا عن نجدة قد تجعلها باقية على قيد الحياة. وأنا بالكاد أقوى على الحركة. ثابت في سكوني غير قادر على فعل أي شيء. أنظر إليها برأفة، وأستمع للعزف الموسيقي المنبعث من غرامون وُضعَ على طاولة صغيرة من الأكاجو، كانت تدور عليه أسطوانة كبيرة. أدركت أنه عزف كلاسيكي لموزار طالما حدثتني عنه السيدة. إني أراها الآن مجددا. في لحظة النفس الأخير. أو لحظة المأساة. كانت تفارق الحياة، وأنا واقف مشدوها أستمع لأوبيرا دون جيوفاني بحزنها، ولحظة القلق التي تنبعث منها، بينما تسقط السيدة في الأخير جثة هامدة مليئة بالدم. يرتطم كامل جسدهاعلى أرضية الصالون ذي الأرضية الخشبية. شاهدت عيناها تدمعان وهي تفارق الحياة، ووجهها ترتسم عليه علامات الألم، مشيرة بأصبعها إلى خزانة من الخشب الأحمر التي تضع فيها أشياء في غاية الأهمية، أخبرتني عنها ذات يوم، وأرتني المكان الذي تضع فيه مفتاح الخزانة.
احتفظ المجرم بسكينه في يده، لما شعر بوجودي. أخرجه من قلبها. رأيته مليئا بدم السيدة. راح يسيل إلى غاية مرفقه. انفتحت نافذة الصالون فجاة، بفعل هبوب رياح قوية، وحملت إلى غاية السقف ستائرها البيضاء، ثم بعثرتها يمينا وشمالا. رمقني القاتل بنظرة قاسية، فظة، طاغية، ووحشية. فعل ذلك بعينيه السوداويين الصغيرتين الشبيهتان بحبات زيتون بري، واللتان ينبعث منهما حقدا مخيفا. أشعرتني تلك النظرة بارتعاش في كامل جسدي، وملئتني ذعرا. صرت كأني فقدت دربي، وسرت في ظلام دامس، فإرتجت الأرض تحت قدامي. سقطت شموع عيد ميلاد السيدة من يدي. تبعثرت على الأرضية الخشبية. ساورتني رغبة في الاختفاء. ملئني مزيدا من الخوف. سحقني. أبكاني. جعلني أفقد القدرة على التحرك. تسمرت. تحجرت. شاهدت الشر المطلق مجسدا في ذلك المجرم، واكتشفت الجانب الخفي من الحياة. ذلك الجانب الشرير والفظيع، الذي لم يكن لطفل في سني ليكتشفه لولا درجة الشر التي ملئت قاتل السيدة. وبقي ذلك الاكتشاف منغرسا في ذاكرتي يرفض أن يبرح تلابيبها. أستعيده على شكل كوابيس تقض مضجعي، وتحرمني من النوم لساعات طويلة على مدى عدة سنوات.
بقي اللحن الأوبيرالي يدوي في أرجاء الصالون. تتصاعد وتيرة حزنه، وتشتد، وأنا أشاهد المجرم متوجها نحوي بقامته الطويلة، ووجهه المخيف، طويلا كأنه عملاق، وفي صورة وحش يريد أن يفترسني. حاولت الفرار، لكن بدون جدوى. لأن الخوف أفقدني القدرة على التحرك. كنت أرتعد إلى حد جعلني أفقد القدرة على أي وثبة قد تبعدني من الفاجعة التي كانت ماثلة أمامي. بلغ المجرم مرحلة الحنق والتذمر. انبعث العنف من عينيه، كشرر متطاير. كان يرتدي ملابس رثة. سترة سوداء، وسروال بني. تقدم نحوي. شممت رائحة العرق وهي تنبعث منه. مسكني من قفاي. ألمني. كانت يده غليظة. صلبة. أضافره طويلة، مليئة بالأوساخ. هددني، قائلا:”أسكت”. بدا صوته كأنه يشبه خوار فظيع يملأ المكان، ويضفي عليه حالة من التيه والضياع. جعلني أتخيل الكون من حولي سائرا على غير هُدى. أصبحت بلا قوة. كل شيء في جسدي غدا ثقيلا. سكتت. لم أقو على الكلام، وأنا جاثم في مكاني. لم أخالف ما كان يريده مني. كدت أتبول في سروالي. بينما يده ما تزال تمسكني من قفاي بنفس القسوة. بدأت أتنفس بصعوبة. بكيت. قرر إخلاء سبيلي فجأة. نزع يده. تنفست هواء مثقلا بدم السيدة التي هوت يدها اليمنى في هذه اللحظة. لقد ماتت. برزت عيناها. بقيتا معلقتان على السقف، وأصبع يدها اليمنى موجهة نحو الخزانة المصنوعة من الخشب الأحمر.
في تلك الأثناء، شهدت نانا فاطمة، زوجة سيد علي الميصاليست جارنا. كانت قادمة من بيتها الواقع مقابل بيت السيدة. لم تكن ترتدي سوى لباسا خفيفا. بقيت بدورها ساكنة في مكانها من شدة هول ما مثل أمامها. فزعت. لم تعد تملك أي قدرة على خطو خطوات أخرى، ولا حتى العودة إلى بيتها، وإقفال الباب. صاحت بكل القوة التي استجمعتها. دوي صياحها في أرجاء العمارة. خرج باقي الجيران مسرعين. تجمعوا. فر المجرم. قفز كوحش مفترس. صعدت مسرعا إلى بيتنا في الطابق الأعلى. أمي التي كانت تهم بالخروج، بعد أن سمعت الصياح، فتحت لي الباب. لاحظت الخوف الذي كان مرتسما على وجهي الممتقع. طلبت مني أن أخبرها بما جرى لي. عجزتُ عن الكلام. دخلتُ غرفتي. نزلت هي لمعرفة ما كان يحدث. لما عادت، كانت تبكي. دخلت غرفتي. وجدتني في فراشي، وفرائصي ما تزال ترتعد. خافت علي من أن يصيبني مكروه، فضمتني إلى صدرها. وبكيت معها.
لزمت غرفتي أسبوعا كاملا. لا أرى الخارج سوى من النافذة. فقدت القدرة على النطق. حالتي جعلت أمي وأبي يظنان أنني مريض. بدا متأثرين جدا لمقتل السيدة. سمعت والدي يردد بنبرة حزينة، ومُكدرة، اثر عودته من المقبرة في اليوم الموالي أن السيدة جنات كانت إنسانة رفيعة، وسخية. وأنهم دفنوها تحت ظلال شجرة صفصاف، في مكان عال يطل على البحر. شاهدته يمسح ماء المطر المتصبب من شعره، ويقول متأثرا… “إن الإله سيخصص للسيدة مكانا في الجنة”… و”إن المجرم الذي قتلها بتلك الطريقة الشنيعة، والفظيعة سينال عقابه”. ثم سمعته يدعو بالنكبة على المجرم، ويدعو الإله بأن يسلط عليه أشد العقاب.
2
لازمني مشهد مقتل السيدة جنات طيلة حياتي. انغرس كواقعة ضارية، سيئة، وعنيدة. صورة المجرم لم تبرح ذاكرتي أبدا. ترسخ حضورها نهائيا وبشكل دائم. انغرست في نفسي، وملئتني بعذابات مؤلمة، يصعب تحملها. تختفي أحيانا، وتعاود الظهور أحيانا أخرى على مر السنين. كانت تبرز على شكل كوابيس تقض مضجعي. تؤرقني. وتنغص حياتي، مستحوذة على مساحات الصفاء والهدوء. وما زاد من عذابي بعد رحيلها، ومن شدة حزني لفراقها، أنني لم أعد أستمع لموسيقى ذلك المؤلف الشهير الذي يدعى فولفغانغ أمادييوس موزار، وهي تنبعث عذبة، سلسة من شقتها لتتغلغل في أرجاء العمارة، وتتسرب إلى شقتنا، وقد عبرت الجدران، لتستقر في كياني، وتسكن روحي، وتنزل عليه سكونا وهدوءا، وتغمره إحساسا باكتشاف لحظة ممتعة، عامرة بالسعادة، محفوفة بالمتعة، ولها وقع مختلف في حياتي. شعرت كما لو أن كل شيء من حولي ضئيل أمام روعة ذلك اللحن النقي الذي مدني بحيوية غير مرئية، غير ملموسة، صامتة كأنها تنزل من السماء، وهي ليست بالسماوية، بل هي جزء من الجانب الإلهي على الأرض.
كنت ماكثا في غرفتي، أنتظر عودة والدي، لما استمعت أول مرة للحن أوبيرالي، يصل مسامعي. كان قادما من حيث لم أكن أدري حينها. كنت حزينا وخائفا على والدي. خرج منذ الصباح الباكر، ولم يعد. كانت الساعة الثامنة ليلا، لما بدأت أمي ترتبك، وتفقد صبرها. اتصلت بالجيران. أخبرتهم باختفاء زوجها. بحثوا عنه في مقهى ملاكوف أين يقضي النهار بطوله، وتلك كانت عادة دأب عليها منذ انتهاء الحرب، بعد أن أحالوه على التقاعد وهو برتبة رائد. بحثوا عنه في كل مكان، فلم يعثروا عليه. قيل إنهم لم يشاهدوه طيلة اليوم. لم يجدوا له أثرا. خافت أمي. ارتبكت. بكت كثيرا، وهي تنتظر. تصورت أمورا مخيفة، فظيعة، ومفجعة تكون قد ألمت بوالدي، فقد وقعت حوادث مؤلمة لم يكن يتصوها أحد آنذاك بعد رحيل الرومي. ورغم ذلك جرت، ووقعت أمورا فظيعة بسبب ممارسات الشرطة السياسية التي كانت تتلقى أوامر من قبل السيد الرئيس بإلقاء القبض على كل المحاربين القدامى الذين عارضوا حكمه، والزج بهم في سجون الصحراء القاسية، والقصية، والفظيعة، دون إخبار عائلاتهم، ولا زوجاتهم بمكان تواجدهم. كان يتركهم في حيرة من أمرهم أياما طويلة. يتعذبون. يبكون. يناشدون المقربين منه لاطلاق سراح أبنائهم. قيل إنه يفعل ذلك حتى يصنع لنفسه هالة وسط الناس، ويبدو كحاكم مخيف، وينقل معارضيه إلى حالة من الرعب بمجرد ذكر اسمه. اعتقدنا أن والدي لقي نفس المصير.
والحق أن كثير من رموز الحرب ضد الرومي، لم يسلموا من هذه الممارسات التي نقلها السيد الرئيس إلى البلاد، ليقضي على فرحة التخلص من الأقدام السوداء، ويخطف نشوة الانتصار من محاربين قضوا سبع سنوات ونصف، وهم يحاربون بلا هوادة. كان رجلا طيبا مع الفقراء، لكنه لم يرحم خصومه السياسيين.
نساء العمارة جئن لمواساة والدتي، والتخفيف من شدة هلعها. جلسن معها في الصالون، بينما دخلتُ غرفتي، وجلستُ أمام النافذة المشرعة، ورحت أنتظر رؤية والدي عائدا إلى البيت سالما معافى. اندهشت، وأنا أشاهد جنودا، ودبابات مركونة عند مدخل الحي، وأناس يهرولون في كل الاتجاهات، وعلامات الخوف مرتسمة على وجوههم. بينما كنت على ذلك الوضع من القلق والاضطراب وصلني ذلك اللحن الزاخر بالعذوبة، والمليء بالتناقضات، يتخذ لحظات مختلفة، متباينة، تارة يصعد إلى فضاء سام، وراق كالجنة، وتارة أخرى ينزل إلى ما يشبه جهنم، في لحظة فاصلة قصيرة، ثم يتناوب بين الفرح والحزن. وكنت أتخيل مشاهد غريبة، أستوحيها من ذلك اللحن، على شكل تخيلات أرى فيها صراعا بين الخير والشر. الشر يتربص بالخير، ويريد الإنقضاض عليه ومحو أثره. وكانت السيمفونية تجري وفق مستويات مختلفة. ينتصر الشر أحيانا، ويستعيد الخير مكانته أحيانا أخرى.
نسيت همومي للحظة بدت لي مختلفة، وأنا أتابع تلك النوتات الموسيقية، التي يليها غناء السوبرانو وهو ينشد ألحانا عذبة، راقية ورومانسية. وفجأة، عند اقتراب الغروب، لمحت والدي عائدا. شاهدته يمشي بتثاقل. انتزعتني عودته من تخيلاتي. انطلقت بسرعة نحو الصالون. أخبرت أمي بعودته. قلت لها والدي في الطريق. لم تصدق. بقيت تبحلق في. ولما أكدتُ لها ما شاهدته، غادرت مكانها، وقد تغيرت ملامح وجهها. اندفعت نحو الباب. فتحته بسرعة. ألقت نظرة إلى الأسفل، ثم التفتت إلينا. وضعت يديها على صدرها، فاستراحت. عادت إلى الصالون بدون الاضطراب الذي ارتسم على محياها. في هذه الأثناء خرجت النسوة اللواتي جئن لمواساتها. دخل أبي متعبا. جلس على الأريكة إلى جانب أمي. سألته عن سبب تأخره. طلب منها أن تصبر. شاهدته وهو يلمح لها بأن تنتظر حتى أنام ليطلعها عن كل شيء.
كان اللحن الأوبيرالي المنبعث من شقة السيدة جنات قد توقف. خيم الصمت. لم أعد أنظر إلى السماء، وإلى كل الكون من حولي، بتلك النظرة المغايرة التي كانت ترافق المعزوفة الموسيقية. بدا لي كل شيء عاديا وطبيعيا. السماء مكفهرة خالية من الغيوم. نسمات البحر القادمة من جهة الغرب باردة، وشارع بن مهيدي أمامي كان خاليا من المارة، ولم يبق فيه سوى العسكر، الذين راحوا يدخنون، ويتبادلون أطراف الحديث، وهم متكئون على الدبابات، ورشاشاتهم تتدلى على أكتافهم.
في صباح اليوم الموالي، قبل أن ينهض والدي، أخبرتني أمي، وأنا جالس معها في الصالون، أن انقلابا عسكريا وقع أمس، فألقوا القبض على كل اليساريين المتعاطفين مع الرئيس بن. ب. ولما سألتها إن كان والدي متعاطفا معه، أجابت:”لا، أبدا. لقد اعتقلوه خطأ، فأطلقوا سراحه بسرعة”.
انتظرت سماع اللحن الموسيقي مجددا. وبينما كنت أنتظر، دخل والدي الصالون، فسمعت أمي تقول له:
_ هل ضربوك؟
فرد قائلا:
_ لا. لم يضربن أحد. كلموني بخشونة في البداية. ولما اكتشفوا أن الكوميسير حمادوش كان معي في الجبل خلال الحرب، وحارب إلى جانبي في نفس الكتيبة، عاملوني بشكل مغاير. حتى أن أحدهم اعتذر لي، بعد أن انتهى من استجوابي، ولم يقدر حتى على رفع رأسه.
ثم سألته والدتي مجددا:
_ وهل طالبت مقابلة الكوميسير.
رد والدي:
_ لا، رفضت.
فسألت أمي مرة أخرى:
_ لماذا؟
صمت والدي هذه المرة، وتأخر رده، وبعد لحظات قضاها ساهيا، زائغ العينين، قال:
_ لأنه لم يعد رفيقي. الظروف فرقت بيننا. ناضلنا سويا. حاربنا في الجبل جنبا لجنب، ثم افترقنا. تحمل هو مشاهدة التجاوزات التي وقعت، وأصبح طرفا في الانحراف، بينما لم أقدر أنا على اقتراف مثل هذا الجرم. تحطمت رومانسيته، وانكسرت، وتحول إلى رجل قادر على إيذاء إخوانه، من أجل أفكار يعتقد أنها صائبة، وغير قابلة للنقاش. والحق أن مثل هذا السلوك تعلمناه في الجبل. لم يكن يحق لنا مناقشة أي أوامر يصدرها القائد. ننفذ التعليمات في صمت وخنوع مطلق، ليس للشخص بل للقيم الثورية التي يجسدها القائد. وتلك مسألة يمكن تفهمها. ظروف الحرب والحياة السرية لم تكن تسمح بالنقاش. لأن حياتنا كانت قاسية. والعيش في السرية لم يعطينا هامشا مريحا للمناقشة. لكن بعد انتهاء الحرب، ما كان يجب ترك الأمور على هذا المنوال. كان يجب توفير مناخا مقبولا للنقاش، وذلك ما لم يحدث. كنت أتصور أن الحرب تعني الثورة، وتعني لحظة تجعلنا نتخلى عن الشياطين التي تغلغلت إلينا، بينما تصرف هو كأنها مجرد حرب بدون ثورة، ولا قيم ثورية. مجرد معركة لإخراج الأقدام السوداء. هنا يكمن الاختلاف بيننا، وهو اختلاف في الجوهر جعلنا نفترق. كنت أفكر في الثورة. وكان هو يريد الحاق الهزيمة بالفرنسيين وطردهم. افترقنا بعد ان كنا صديقين حميمين، لن نلتقي مجددا، ولن تعود المياه إلى مجراها، إلا إذا أعاد النظر في مواقفه. لهذا رفضت طلب مقابلته، وتركتهم يحققون معي كما يريدون.
لم تسأله أمي مجددا، فهي تعرف اللحظة التي يجب أن تتوقف فيها حتى لا تقلب مواجعه، وتزيد من شدة حزنه وآلامه. كانت تعرف أنه رجلا تائها، ضل وجهته، فخابت أماله، جراء الانحراف الذي وقع بعد انتهاء الحرب.
والحق، أن أوضاع والدي تأزمت، وقاربت الانهيار، وسارت إلى حيث لم يكن يتصور أبدا، بعد مشاركته في الحرب الأهلية الثانية، التي قادها أحد رفقاء السيد الرئيس سابقا. أخرج بذلته العسكرية من الخزانة ذات ليلة باردة. ودع والدتي، وأخبرها أنه قرر الصعود إلى الجبل ثانية. ارتبكت، وبدت علامات الخوف على وجهها، فسألته:
_ لماذا؟
ربت على كتفها، فقال:
_ سنخوض حربا من أجل إزاحة الديكتاتور.
صعد والدي إلى الجبل ثانية، ليخوض حربا مريرة ضد قوات السيد الرئيس. وانضم إلى معارض اشتراكي يدعى حسين مرابط.
في الصباح الباكر، لما نهضت من النوم، سألت والدتي:
_ أنيذاث بابا ؟(أين والدي؟).
فردت أمي:
_ يروح أرثمورث أديلقظ أزمور (سافر إلى البلد لجني الزيتون).
انتظرت طويلا، ولم يعد والدي بسرعة كعادته. افتقدته، وحزنت كثيرا. سألت أمي مجددا:
_ أيوقث أراديوغال بابا؟ (متى يرجع والدي؟).
فأجابت:
_ قريب.
انتهت الحرب الأهلية بسرعة، وعاد والدي محطما مكسورا، وبلا قفة الزيتون. دخل البيت كأنه شخص أخر. نحف جسمه كثيرا، وكاد يسقط أرضا وهو يستقبلني بين ذراعيه. حدق في أمي مليا، وقال لها، وهو يضمني اليه:
_ انتهت الحرب، وانتصر الديكتاتور.
وبينما أنا بين ذراعيه، سألت نفسي:
_ لماذا ينهزم والدي دائما، رغم أنه رجل طيب؟
3
المدينة تخاف من الغرباء. ترتجف إن ساروا على أرضيتها بأحذية خشنة، ودكوها دكا.
المدينة امرأة رقيقة، تحب من يداعبها.
لما وطأت قدما قاتل السيدة جنات المدينة لأول مرة، مساء يوم خريفي، كانت الشمس تغيب. اختفت السحب الممطرة التي ملأت السماء قبل أن ينزل من سيارة الأجرة. أبعدتها الرياح جهة الغرب. كان يرتدي قشابية بنية من الوبر. انتعل حذاءا أسود من الكاوتشو، واعتمر بونيه أسود مثقوب، لفه بشاش أبيض غطى شعره المتموج. راح يسير كالغريب بقامته الطويلة، ومنكبيه العريضين. أخذ يحدق، ويمعن النظر في المدينة البيضاء التي يراها لأول مرة بعينيه الصغيرتين السوداويتين، وكأنه يتربص بها، كما يتربص الصقر بفريسته. كان ينظر إليها بضراوة، واستعد لها بشراهة الجائع.
لا أحد كان في انتظاره. لم يكن يعرف أحدا في المدينة. سائق سيارة الأجرة الذي نقله من محطة القطار، رفقة ثلاثة ركاب آخرين، كتب له عنوان نزل من الدرجة الثالثة على ورق علبة سجائر البسطوس. كتبه بالعربية. سلمه لزبونه. وضعه هو في جيب سرواله، ولم يعط لنفسه عناء قراءة ما كتب على ورقة السجائر.
قرر أن لا يتكل سوى على غريزته. راح يمشي بخطى مسرعة. بدا متلهفا. أراد أن يتحرر حتى من حقيبته السوداء التي وضع فيها أغراضه، حتى يسرع الخطى، ويصل إلى قلب المدينة ليكتشفها لأول مرة.
زحف عليها مثل من يتحرش بها. صعد إليها كأنه خرج من قاع الأرض، بينما ارتسمت خيوط الليل الأولى. كان واثقا من نفسه، رغم غرابته عن المكان. صعد من الميناء حيث تركه سائق الأجرة، إلى وسط المدينة دون أن يلتفت ورائه، ويمعن النظر في البحر الهادئ، ولا في غروب الشمس. ترك البحر ومنظر الغروب ورائه، وراح يصعد السلالم الإسمنتية النظيفة بدون عناء، حتى أنه أخذ يجري بينما باقي المارة يصعدون بروية. كان متعطشا للوصول. كأنه أراد أن يغزو المدينة في الحال.
توقف بمجرد أن انتهى من الصعود، وبلغ ساحة واسعة تحيطها أشجار وارفة. كان يتصبب عرقا، وأحس بهيجان في داخله، لأنه أجبر على التوقف لتأمل المكان الذي لم تطأه قدماه أبدا. تناهت إلى مسامعه الآن صفارة باخرة تستعد للإبحار، وعلى متنها أناس فضلوا الرحيل إلى مدن الغرب الباردة، تاركين ورائهم مدينة ولدوا بها لغرباء جاؤوها بحثا عن ثمرات الثورة. رفع رأسه، وأخذ يحدق في المدينة العتيقة المعلقة على هضبة جعلتها تطل على البحر. عبرت أنفه نسمات البحر، ولم يبال بها. نسمة الجو الوحيدة التي يعرفها هي نسمات المناطق الجرداء الحارة.
مشى وسط مارة كانوا يسيرون ببطء. قرر أن يُسرع خطوه. رائحة عطر الفتيات اليافعات أثارت غريزته الجنسية. تمنى لو يسحق جسد احدهن، ويبدأ صعوده إلى القمة على جسد امرأة يروي بها عطشه الجنسي دون أن يتزوجها، بل يجعلها عشيقة يعبث بها ويلهو متى شاء. كان يعتقد أن المدينة هي بؤرة للفساد، يكثر فيه الانحلال، ويسهل على الرجال التمتع بمضاجعة النساء، وقت ما يشاء. فلماذا لا يتمتع بدوره بكل المتع التي طالما سمع عنها.
ظل يمشي، ولا أحد اهتم به. الناس في المدينة تعودوا على زحف غرباء مثله. أصبح ذلك جزءا من حياتهم، ومنظرا ألفوه. منذ أن رحل الكولون مطأطئ الرؤوس. خانعين. مقهورين. مهزومين. دخل أزقتها وشوارعها آلاف الأشخاص مثله يذرعون الشوارع النقية بحثا عن عمل، أو يجلسون في مقاهي ما تزال تحتفظ برونقها وبهائها، فيضفون عليها مظاهر الانحطاط بسلوكياتهم الفظة والقاسية.
في الليلة الباردة، التي أخبر فيها أهله بأنه يستعد لمغادرة الشعبة والنزوح إلى المدينة، كان جالسا معهم في البطحة بمحاذاة مسجد لم يكتمل بنائه. تجمعوا مثلما تعودوا بعد الغروب، وانزووا في برانسهم الوبرية، لاتقاء البرد. قال له عمه، الشيخ أحمر الخد، محاولا أن يثنيه عن قراره:
– إنهم أناس متكبرون يا بَرهُوم. متعجرفون. سيكرهونك حال وصولك إلى هناك. بمجرد أن تطأ قدماك المدينة يرمقونك بنظرات عدائية. أعرف جيدا هؤلاء البشر، إنهم من طينة مختلفة تماما، وهم ورثة طبائع الكولون لعنهم الرب.
وقال له والده:
-عمك يقول كلاما صائبا. إن تكبر هؤلاء، وعجرفتهم، لا مثيل له. عاشوا مع الكولون وأصبحوا مثلهم. ويقال إنهم لا يصمون رمضان والعياذ بالله. ولا يصلي عندهم سوى الشيوخ. أما الشبان فيقضون أوقاتهم في الحانات التي تركها لهم الرومي. مساجدهم فارغة. ونسائهم يدخنن السجائر، ويتخذن لهن عشاقا مثل الروميات.
لا أحد تمكن من ثنيه عن قراره. سيذهب إلى المدينة، ويعيش هناك. لم يبد أي تردد، ولا خوف. تصلب وجهه، وقال:
-أعرف كيف أروضهم، لا تقلقوا.
صمت برهة، وأضاف:
– لن أذهب إلى هناك لكي أخدمهم. وأنحني برأسي أمامهم. سأذهب إلى المدينة لكسب المال، وأتمتع بفضائل الاستقلال مثلهم. تلك الخيرات ليست حكرا عليهم لوحدهم. أنا ذاهب لكي أصبح سيدا عليهم، وليس خادما عندهم.
صمت برهة، ثم واصل كلامه، وهو يضرب الأرضية الترابية برجله اليمنى
الرواية صادرة عن منشورات الحكمة في الجزائر 2014م.
التعليق
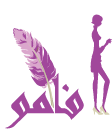

 من نحن
من نحن أشواك الورد
أشواك الورد قصاصات.كوم
قصاصات.كوم متابعات
متابعات فضاء للبوح
فضاء للبوح سرديات
سرديات قصائد
قصائد آراء حرة
آراء حرة في المرآة
في المرآة الأسوأ
الأسوأ دليل فامو
دليل فامو Boutique FaMoh
Boutique FaMoh Café FaMoh
Café FaMoh إتصل بنا
إتصل بنا