سرديات عودة
فصل من رواية "غريقة بحيرة موريه" لأنطوان الدويهي (الأربعاء 21 ت1 2015)
فصل من رواية - الغريقة
أنطوان الدويهي
إنّها ليلة الأربعاء في الثاني والعشرين من حزيران. أكتبُ ما يأتي: "كنت أحبّ حبّاً جمّاً بيت الدكتور مارتي الذي ورثه عن أجداده. كان البيت، الذي يعود بناؤه إلى أوائل القرن التاسع عشر، يقع على مقربة من مدينة أورليان ومن نهر اللواريه الصغير، أحد روافد اللوار. وهو مؤلّف من طبقتين يعلوهما قرميد رمادي غامق، وترتسم في واجهتهما نوافذ كبيرة بيضاء، وسط حديقة فسيحة يزنّرها سور حجري، وتضمّ أشجاراً مسنّة من الحور والبلوط والزان والصفصاف، إضافة إلى بضع أرزات باسقات يفوق عمرها الثلاثمئة عام. تسكن الحديقة ليلَ نهار طيورٌ بريّة من مختلف الأنواع. ويحوي المنزل أثاثاً عريقاً وأنيقاً، ينمّ عن ذوق مرهف وثقافة متوارثة منذ أجيال، تزيّنه لوحات زيتية قيّمة. كان المنزل لا يبعد كثيراً عن بحيرة موريه داخل الغابة التي تحمل الإسم نفسه، الغنية بالبرك والمستنقعات. ويمكن الوصول إلى البحيرة عبر درب ترابية ضيّقة تنساب بين العوسج والزعفران وأجمام الأزاهير، في هدأة عميقة لا تقطعها إلا أصوات الغابة. ويلج البحيرة جسر خشبي يقود إلى مقصورة عائمة، آسيوية الطراز، يسودها جوّ ساحر.كانت تربطني بالدكتور هنري مارتي، رفيقي على مقاعد السوربون، صداقة وطيدة. وغالباً ما كنت أتردّد على منزله في عطل نهاية الأسبوع، حين أكون وحيداً، أو في حال فراق مع لورا. غير أنّ ما شغل فكري ولا يزال في تلك الأنحاء، هو حادثة "عشيقَي كليري"، نسبةً إلى اسم قريتهما المجاورة، أو "عشيقَي البحيرة"، اللذين قضيا غرقاً قبل سنوات، ووُجِد جسداهما الهامدان طافيين على سطح الماء ذات مساء ربيعي من العام 1992، وكان ذلك قبل يومين من موعد زفافهما. فهذان العاشقان الغريقان لا يبارحان مخيّلتي، وأنا أشعر كأنّهما مقيمان على الدوام في هذا المكان، كلما أتيت اليه. ولم يُعرَف قطّ حتى الآن ما إذا كانا انتحرا معاً عشية قرانهما، أم أنّ أحداً دفع بهما عمداً إلى لجّة البحيرة، أم أنّ حادثاً غريباً ما قد أودى بهما. ومن غير السهل كشف الحقيقة في هذه الأراضي الداخلية التي يتّسم أهلها بالحذر والكتمان وتذهب معهم أسرارهم إلى مثواهم الأخير.لكنّي، وإن لم أبح بذلك لأحد، شبه متيقّن في قرارتي أنّ "عشيقَي البحيرة" انتحرا غرقاً قبيل زفافهما. فلا بدّ أنّهما وصلا في لحظة ما، إلى ذروة قصوى من التواصل الجسدي والروحي ومن الامتلاء والسعادة التامّين، بحيث تمنّيا في تلك اللحظة الموت، فجذبتهما البحيرة إليها. أعتقد أنّهما لو كانا في تلك اللحظة في مكان آخر، في بيت ما، أو في أحد الحقول، بعيداً عن المقصورة العائمة، لما انتقلا من الرغبة إلى الفعل. إنّ غرقهما مزيج من السعادة القصوى ومن جاذب الماء. أنا أدرك ذلك تماماً. أذكر أحد أيّام الخريف، حين أمضينا، لورا وأنا، فترة بعد الظهر معاً في غرفة فندق أرل، كيف امتلكتني آخر النهار هذه الرغبة نفسها، فقلت في سرّي: "كم أودّ أن أموت الآن". يمكن أن يتكرّر ذلك. أمّا جاذب الماء فأعرفه هو أيضاً، أيّما معرفة.كانت لورا هي حديقتي السريّة. حتى اليوم لم يعرف بأمرها أحد، على رغم انقضاء كلّ هذا الزمن على علاقتي بها. حين تعرّف أحدنا الى الآخر، كانت لورا في الحادية والعشرين وكنت أنا تجاوزتُ الثلاثين قليلاً. لم تكن علاقتنا في بداياتها علاقة وله كما أضحت عليه. كان يغلب عليها الطابع الجسدي خلال لقاءاتنا الأولى في شقّة حيّ مونج التي كنت تسلّمتها قبل حين وكانت خالية من الأثاث.لا شكّ في أنّ تلك الفترة الأولى، المحرَّرة من الوله، كانت هي الأسعد في علاقتي الطويلة بلورا. كانت لذّة اللقاء في شقّة مونج لا تبدأ لحظة تدّق لورا دقّتها الخفيفة الخاصّة على الباب، التي تنطوي دوماً على مسحة من التردّد والخجل، بل قبل ذلك، طوال وقت الانتظار، على رغم الخشية التي تنتابني في كلّ مرّة من عدم حضورها. لكنّها لم تتخلّف ولا مرّة عن المجيء. غالباً ما كنت أسترق النظر من وراء النافذة في الطبقة الرابعة، إلى الباحة والحديقة الصغيرة، فأتأمّل بشغف صعود لورا الدرج الخارجي، بقامتها الطويلة الهيفاء، الأنيقة اللباس على بساطة، ومشيتها الرشيقة والحالمة في آن واحد، فأتخيّل أنّي سأضمّها بعد قليل إلى صدري، وأتنشّق عطرها الزكيّ، وأحسّ بدفء جسدها البالغ النقاوة والنعومة، وأرى إلى وجهها الفاتن، وشفتيها الورديتين العذبتين، وعينيها الواسعتين الشديدتَي الزرقة، حيث جوهرها وسرّها، إلى أن أسمع وقع يدها على الباب. كما كنت أحياناً أمضي فترة الانتظار في مقهى "لوتيسيا" المجاور، المطلّ على ساحة مونج، حيث اعتدتُ الكتابة، فأترقّب لحظة مرورها في سيل العابرين، وأتابع بشغف طيفها ومسارها، وأمشي وراءها، ثم أناديها عن قرب "لورا، لورا"، فنستقلّ المصعد يداً بيد ونلج البيت معاً.هذه المرحلة الهانئة المستقرّة من علاقتي بلورا لم تدم طويلاً. فقد أدركتُ بعد حين، ثم أكثر فأكثر، أنّ لورا، على حداثة سنّها وجمالها ورونقها ورهافة مشاعرها وخفرها، هي كائن مجروح النفس، وأنّ جرح نفسها لا شفاء منه. لذلك، ربّما، أحببتُها. العلاقة معها التي رأيتُ فيها في البدء واحة وئام وسكينة في بحر الاضطراب الباريسي، كانت نقيض ذلك تماماً. فلورا هي بحر الاضطراب عينه. وقد بدأ التحوّل حين أبلغتني ذات مساء رغبتها في السفر إلى جزيرة برَايا البريتانيّة لتمضية بعض عطلتها الصيفية. لم تطلب منّي مرافقتها إلى هناك ولم أسألها ذلك. عند عودتها إلى باريس، لم تتّصل بي وتوارت نحو أسبوعين عن ناظري، فتّشتُ خلالها عنها في كلّ مكان فلم أعثر لها على أثر. حينئذ بدأ هيامي بها، الذي لا يزال يمتلك نفسي بالقوّة عينها، فلم يفتر لهيبه ولم يستكن منذ سنين عشر، ولا أدري إذا كان سيستكين يوماً.كان ولهي بلورا سلسلة طويلة مضنية من اللقاءات والفراقات، في خضمّ التحوّلات المفاجئة وغير المفهومة التي تطبع شخصها. هي مفاجئة وغير مفهومة في نظري، وليس في نظرها، الذي لم أدرك سرّه قطّ. أغلب الظنّ أنها تبادلني الشعور نفسه، فترى أفعالها مبرّرةً تماماً وأفعالي مستغربة، وأنه يستحيل عليها ولوج سرّي. كرّس هذا المأزق، أنّ لورا لا تحبّ التعبير الكلامي، وترى على الأرجح أنّ فهم الأشياء لا يمرّ أوّلاً بهذه الوسيلة، ومجرّد الاضطرار إليها تأكيد أنّ الواحد لا يعي ما في الآخر ولا يتفاعل بعمق معه. هكذا، كان كلّ نقاش يزيد الطين بلّة.كرّس هذه الحال أيضاً أنّ أحدنا لم يعد يستطيع التخلّي عن الآخر، وبات كلٌّ منّا محور حياة الآخر. كان الوله بلورا مزيجاً مأسويّاً من اللذّة والألم، والسعادة والتعاسة، واليأس المطبق والأمل المتجدّد، والنعيم والجحيم، لكلّ منّا، فكيف الخلاص؟ لم تكن فترة الوفاق لتدوم أكثر من أسبوع أو أسبوعين، كذلك فترة الفراق. طوال هذه السنين العشر، كان يبدو الوفاق، في كلّ مرّة، نهائياً لا شكّ فيه، يحمل ألق اللقاء الأول ووعوده، كذلك القطيعة والانفصال يبدوان نهائيين حاسمين لا عودة عنهما قطّ. مع ذلك، لا يلبث أن يحلّ وقت العودة، محفوفاً بالأشواق التي لا تُقَاوَم، ومغلّفاً في كلّ مرّة بأسباب وحجج لا تخطر على بال، على رغم ما بذلتُه من جهود يائسة للنسيان. غالباً ما كنت أنا صاحب مبادرة العودة. حين أتأخّر كثيراً كانت تأخذ هي المبادرة. وغالباً ما كانت تقول همساً، مستسلمةً لقدر أقوى منها بكثير: "لا شيء ينتهي حقّا".فقط بعد سفر هنري مارتي إلى أميركا ووجودي وحدي في دارة اللواريه، بدأتُ أصطحب لورا إليها. وفي يوم مضيء من حزيران، كان شوق أحدنا إلى الآخر قويّاً، عاصفاً، وكان التواصل عميقاً، مؤثراً، بيننا، فبقينا طوال النهار معاً في بيت اللواريه. عزفتْ لورا في وقتٍ ما بعد الظهر على البيانو، وهي تجيد العزف، ألحاناً أحبُّها، اختارتها خصّيصاً لي، أصغيتُ إليها بشغف وتسرّبت إلى أقاصي ذاتي. استعدنا زيارتنا الأخيرة إلى بروج حيث كادت عربة الخيل المجنونة تصدم لورا فنجت منها بأعجوبة، وتذكّرنا الفندق الصغير الغريب الذي وقعنا مصادفةً عليه في كانّ القديمة، الذي كانت تديره أختان طاعنتان في السنّ ترتديان الأسود، وترتفع في باحته المسوّرة نخلتان كبيرتان، وأنا أحنّ دائماً إلى العودة إليه، مع أنّ إقامتنا فيه لم تكن تغمرها السعادة.تكلّمنا على أمور كثيرة، بهدوء وشغف، في تلك السكينة، التي كانت تخفرها في الخارج زقزقة العصافير وأصوات الغابة. كانت لورا ترتدي فستاناً صيفيّاً خفيفاً فاتناً، ناعم الزرقة، منسجماً مع لون عينيها وموشّى بزهور صغيرة صفراء. كان جوٌّ من البوح والصفاء التامّ يسود بيننا، وأحدنا ممسكٌ بطمأنينة واستسلام عميقين بيد الآخر. في لحظة ما، بعد فترة من الصمت، نظرت لورا إليَّ وطرحت عليَّ، لا أعلم لماذا، السؤال الآتي: "ما هي القصّة الأغرب في حياتك؟". فوجئتُ بسؤالها ولم أشأ القول بأنّها قصّتي معها. أجبتها: "هناك قصص غريبة عديدة في حياتي". قالت: "أودّ لو تخبرني إحداها".أمعنتُ التفكير قبل أن أجيبها بـ"أجل"، ثم نظرتُ طويلاً إليها وأكملتُ: "لم أتحدّث إليكِ من قبل عن ذلك. كانت لي مراهقة صعبة للغاية. ما بين السادسة عشرة والتاسعة عشرة من العمر، وراء مظهري البالغ الهدوء، كنت حسّاساً إلى حدّ أنّ هبوب النسيم يجرحني، ومثاليّاً على نحو لا يُعقل، كأنّي لست من هذا العالم، وكانت نفسي مسرحاً لأشدّ العواصف وأقسى الهواجس. أعتقد أنّ الحبّ الأوّل كان هو الشرارة التي أطلقت كلّ ذلك، لست أدري، وهو حبّ عذريّ لفتاة في مثل عمري كنت أراها واقفة على الشرفة المقابلة. طوال تلك السنين الثلاث، لم ألتقِ ولا مرّة هذه الفتاة، ولم أتكلّم معها قطّ، وأنا لا أعرف اسمها حتى، فأدعوها "فتاة الشرفة". كان ذلك الحبّ نبع العذابات التي لا توصف، ومصدراً لاضطراب هائل في علاقتي بالطبيعة، حيث كانت تَمْثل تلك الفتاة على مدى الوقت، ليس في ذاتي المتألّمة فقط، بل في كلّ مشهد أراه. كنت أجهد في اقناع نفسي بأنها ليست موجودة في المشهد، لكنّي عبثاً كنت أفعل. فأنا لم أتصّور يوماً أنّ لاعقلانية الشعور يمكن أن تصل إلى هذا الحدّ. كما كانت "فتاة الشرفة" مصدراً لرؤية مأسويّة لهشاشة الجسد البشري لم تكن تفارقني، ولا أوّد الآن استعادة تفاصيلها الموجعة، وكانت مبعثاً لهواجس كثيرة أخرى تنوء تحتها الأنفس الأكثر قوّة. كنت أتساءل في سرّي خلال تلك السنين إذا كان ثمّة انسان آخر عرف قبلي مثل هذه العذابات المبرّحة، وإذا كان من انسانٍ مرّ بمثل هذه التجربة. لا شكّ في أنّ ما حدث لي في تلك المرحلة من العمر، كان سيحدث في أيّ حال، بـ"فتاة الشرفة"، أو بشرارة أخرى سواها".كانت لورا تتابع كلامي باهتمام بالغ، وتنمّ عيناها ووجهها عن مدى تشوّقها لمعرفة ما سيجري. توقّفتُ قليلاً ثم أكملتُ: "بعدها، غادرتْ تلك الفتاة وأهلها إلى منطقة أخرى ولم أعد أعرف عنها شيئاً، وعمل الزمن على بلسمة جراح نفسي، فانطوت حقبة المراهقة وأنواؤها. بعد سنوات عديدة كانت هجرتي إلى باريس التي انتقلتْ حياتي إليها. كنتُ في وقتٍ ما أعطي درساً خصوصياً في اللغة في حيّ بولونيه، مرّتين في الأسبوع، آخر بعد الظهر. ذات مساء دافئ وكان الوقت قد تأخّر بعض الشيء، نزلتُ إلى "محطة أوتوي" لقطار الأنفاق في طريق العودة إلى البيت. كان رصيف القطار خالياً إلا من امرأة واحدة أنيقة الشكل واقفة تنتظر. تأخّر القطار فصرت أتمشّى قليلاً. وحين أضحيتُ على مقربة من تلك المرأة التي بدت في الخامسة والعشرين من العمر، ونظرتُ إليها ونظرتْ إليَّ، كاد قلبي يتوقّف عن الخفقان وتمالكتُ نفسي كي لا أقع أرضاً. كانت المرأة تشبه إلى حدٍّ مذهل "فتاة الشرفة"، كأنّها هي نفسها. لا أدري إذا كانتْ أدركتْ في صورةٍ ما اضطرابي، إذ إنّها اقتربتْ بعد قليل منّي فحيّتني وسألتني إذا كان القطار سيتأخّر كثيراً. قلت لها: "لا أعرف".لم تعد إلى مكانها بل ظلّت واقفة بقربي. وحين وصل القطار، دخلنا المقصورة نفسها التي لم يكن فيها أحد، فجلست المرأة على المقعد إلى جانبي. تبادلنا على الطريق أطراف الحديث جاهداً في إخفاء تأثّري وارتباكي. سألتْني أين سأنزل. قلت: "في محطّة مابيون". أجابتني: "أنا كذلك". حين خرجنا، اتّفقنا أن نرتاد قليلاً مقهى الـ"مابيون" لاحتساء القهوة. خلال اللقاء، عرفتُ أنّها رسّامة، وشعرتُ أنّها تودّ مرافقتي إلى شقّتي. قالت إنّها تحبّ التعرّف إلى حيّ حديقة مونسوري حيث كنت أقيم. لم أرتح للسرعة التي تطوّرت فيها الأمور بيني وبين هذه المرأة، التي من جهة بالكاد أعرفها، ومن جهة أخرى كأنّها تسكن عميقاً في نفسي. وجدتُ لها عذراً لعدم الذهاب. لكنّها لم تلبث أن دعتني لمرافقتها إلى شقّتها التي هي محترفها أيضاً، لتريني أعمالها، فعدنا أدراجنا في قطار الأنفاق. كانت تقيم في الطبقة الخامسة من بناء أنيق مطلّ على جسر ألكسندر الثالث في ذلك الحيّ الراقي. أخذنا المصعد، وما كدنا نلج الشقّة ونغلق الباب وراءنا، حتى قامتِ المرأة بخلع ثيابها كلّها ووقفتْ عارية تماماً أمامي. قالت همساً: "أنا أعرف فوراً الرجل الذي أهوى". ذهلتُ لذلك، وقلت لنفسي: "هذا هو جسد فتاة الشرفة الذي طالما هجَستَ به وكواكَ الشوق إليه". لكنّي لم أقدم على لمسها. بعد تلك الليلة ما عدنا التقينا ولا مرّة".توقّفتُ عندها عن الكلام وحلّت فترة من الصمت اشتدّت خلالها زقزقة جوقات العصافير المودّعة النهار. لم تطرح عليَّ لورا بعدها أيّ سؤال، لكنّها قامت وارتمت بين ذراعي، واتّحد جسدانا بهيام عميق، ثم أخذتْنا إغفاءة وجيزة صحونا بعدها ولم يبقَ من الأصوات حولنا إلا شدو العندليب وحفيف أجنحة بعض الطيور الكبيرة الذاهبة إلى مأواها.قالت لي لورا إنّها تودّ القيام بنزهة قصيرة وحدها قبل حلول الظلمة. أجبتها: "تأخّر الوقت قليلاً، أليس كذلك؟". قالت إنّها تحبّ كثيراً هذا الوقت. تأمّلتُها من النافذة وهي تبتعد ببطء. لم تتّجه إلى حديقة المنزل، بل سلكت الدرب الضيّقة الموصلة إلى الغابة والبحيرة. جلستُ أنتظرها في هذه الساعة الفاصلة بين النهار والليل التي لها تأثيرها السحريّ فيَّ. في لحظةٍ ما، أدركتُ أنّه طال غيابها، إذ اختفت تماماً أصوات الطيور، وأخذ يحلّ محلّها غناء الزيزان ونقيق الضفادع في المستنقعات القريبة.نزلتُ إلى تحت وبدأتُ أناديها بأعلى صوتي في كلّ اتّجاه: "لورا، لورا"، فلم أعثر عليها. عندئذ، أخذتُ المصباح الكبير واتّجهتُ داخل الغابة نحو ضفاف النهر واجتزتُها وأنا أنادي بكلّ قواي، وقد خنق القلق صوتي، "لورا، لورا"، مجفّلاً الطيور الراقدة التي راحت تفرّ خائفةً من حولي. تصاعد قلقي على نحو بالغ وانطلقتُ أركض متعثّرا في عتمة الغابة إلى أن وصلتُ إلى البحيرة، فأسرعتُ إلى الجسر الخشبي علّني أجدها في المقصورة العائمة. وما إن دخلتُ المقصورة حتى رأيتُ من نافذتها على ضوء المصباح، يا للهول الذي لا يوصَف، رأيتُ لورا طافية على ظهرها على سطح الماء بلا حياة، بجسدها الحبيب الهامد، وفستانها الأزرق الموشّى بالأزاهير الصفراء".
فصل من رواية "غريقة بحيرة موريه" لأنطوان الدويهي، صادرة عن "الدار العربية للعلوم-ناشرون"، و"دار المراد".
التعليق
فصل من رواية - الغريقة
أنطوان الدويهي
إنّها ليلة الأربعاء في الثاني والعشرين من حزيران. أكتبُ ما يأتي: "كنت أحبّ حبّاً جمّاً بيت الدكتور مارتي الذي ورثه عن أجداده. كان البيت، الذي يعود بناؤه إلى أوائل القرن التاسع عشر، يقع على مقربة من مدينة أورليان ومن نهر اللواريه الصغير، أحد روافد اللوار. وهو مؤلّف من طبقتين يعلوهما قرميد رمادي غامق، وترتسم في واجهتهما نوافذ كبيرة بيضاء، وسط حديقة فسيحة يزنّرها سور حجري، وتضمّ أشجاراً مسنّة من الحور والبلوط والزان والصفصاف، إضافة إلى بضع أرزات باسقات يفوق عمرها الثلاثمئة عام. تسكن الحديقة ليلَ نهار طيورٌ بريّة من مختلف الأنواع. ويحوي المنزل أثاثاً عريقاً وأنيقاً، ينمّ عن ذوق مرهف وثقافة متوارثة منذ أجيال، تزيّنه لوحات زيتية قيّمة. كان المنزل لا يبعد كثيراً عن بحيرة موريه داخل الغابة التي تحمل الإسم نفسه، الغنية بالبرك والمستنقعات. ويمكن الوصول إلى البحيرة عبر درب ترابية ضيّقة تنساب بين العوسج والزعفران وأجمام الأزاهير، في هدأة عميقة لا تقطعها إلا أصوات الغابة. ويلج البحيرة جسر خشبي يقود إلى مقصورة عائمة، آسيوية الطراز، يسودها جوّ ساحر.كانت تربطني بالدكتور هنري مارتي، رفيقي على مقاعد السوربون، صداقة وطيدة. وغالباً ما كنت أتردّد على منزله في عطل نهاية الأسبوع، حين أكون وحيداً، أو في حال فراق مع لورا. غير أنّ ما شغل فكري ولا يزال في تلك الأنحاء، هو حادثة "عشيقَي كليري"، نسبةً إلى اسم قريتهما المجاورة، أو "عشيقَي البحيرة"، اللذين قضيا غرقاً قبل سنوات، ووُجِد جسداهما الهامدان طافيين على سطح الماء ذات مساء ربيعي من العام 1992، وكان ذلك قبل يومين من موعد زفافهما. فهذان العاشقان الغريقان لا يبارحان مخيّلتي، وأنا أشعر كأنّهما مقيمان على الدوام في هذا المكان، كلما أتيت اليه. ولم يُعرَف قطّ حتى الآن ما إذا كانا انتحرا معاً عشية قرانهما، أم أنّ أحداً دفع بهما عمداً إلى لجّة البحيرة، أم أنّ حادثاً غريباً ما قد أودى بهما. ومن غير السهل كشف الحقيقة في هذه الأراضي الداخلية التي يتّسم أهلها بالحذر والكتمان وتذهب معهم أسرارهم إلى مثواهم الأخير.لكنّي، وإن لم أبح بذلك لأحد، شبه متيقّن في قرارتي أنّ "عشيقَي البحيرة" انتحرا غرقاً قبيل زفافهما. فلا بدّ أنّهما وصلا في لحظة ما، إلى ذروة قصوى من التواصل الجسدي والروحي ومن الامتلاء والسعادة التامّين، بحيث تمنّيا في تلك اللحظة الموت، فجذبتهما البحيرة إليها. أعتقد أنّهما لو كانا في تلك اللحظة في مكان آخر، في بيت ما، أو في أحد الحقول، بعيداً عن المقصورة العائمة، لما انتقلا من الرغبة إلى الفعل. إنّ غرقهما مزيج من السعادة القصوى ومن جاذب الماء. أنا أدرك ذلك تماماً. أذكر أحد أيّام الخريف، حين أمضينا، لورا وأنا، فترة بعد الظهر معاً في غرفة فندق أرل، كيف امتلكتني آخر النهار هذه الرغبة نفسها، فقلت في سرّي: "كم أودّ أن أموت الآن". يمكن أن يتكرّر ذلك. أمّا جاذب الماء فأعرفه هو أيضاً، أيّما معرفة.كانت لورا هي حديقتي السريّة. حتى اليوم لم يعرف بأمرها أحد، على رغم انقضاء كلّ هذا الزمن على علاقتي بها. حين تعرّف أحدنا الى الآخر، كانت لورا في الحادية والعشرين وكنت أنا تجاوزتُ الثلاثين قليلاً. لم تكن علاقتنا في بداياتها علاقة وله كما أضحت عليه. كان يغلب عليها الطابع الجسدي خلال لقاءاتنا الأولى في شقّة حيّ مونج التي كنت تسلّمتها قبل حين وكانت خالية من الأثاث.لا شكّ في أنّ تلك الفترة الأولى، المحرَّرة من الوله، كانت هي الأسعد في علاقتي الطويلة بلورا. كانت لذّة اللقاء في شقّة مونج لا تبدأ لحظة تدّق لورا دقّتها الخفيفة الخاصّة على الباب، التي تنطوي دوماً على مسحة من التردّد والخجل، بل قبل ذلك، طوال وقت الانتظار، على رغم الخشية التي تنتابني في كلّ مرّة من عدم حضورها. لكنّها لم تتخلّف ولا مرّة عن المجيء. غالباً ما كنت أسترق النظر من وراء النافذة في الطبقة الرابعة، إلى الباحة والحديقة الصغيرة، فأتأمّل بشغف صعود لورا الدرج الخارجي، بقامتها الطويلة الهيفاء، الأنيقة اللباس على بساطة، ومشيتها الرشيقة والحالمة في آن واحد، فأتخيّل أنّي سأضمّها بعد قليل إلى صدري، وأتنشّق عطرها الزكيّ، وأحسّ بدفء جسدها البالغ النقاوة والنعومة، وأرى إلى وجهها الفاتن، وشفتيها الورديتين العذبتين، وعينيها الواسعتين الشديدتَي الزرقة، حيث جوهرها وسرّها، إلى أن أسمع وقع يدها على الباب. كما كنت أحياناً أمضي فترة الانتظار في مقهى "لوتيسيا" المجاور، المطلّ على ساحة مونج، حيث اعتدتُ الكتابة، فأترقّب لحظة مرورها في سيل العابرين، وأتابع بشغف طيفها ومسارها، وأمشي وراءها، ثم أناديها عن قرب "لورا، لورا"، فنستقلّ المصعد يداً بيد ونلج البيت معاً.هذه المرحلة الهانئة المستقرّة من علاقتي بلورا لم تدم طويلاً. فقد أدركتُ بعد حين، ثم أكثر فأكثر، أنّ لورا، على حداثة سنّها وجمالها ورونقها ورهافة مشاعرها وخفرها، هي كائن مجروح النفس، وأنّ جرح نفسها لا شفاء منه. لذلك، ربّما، أحببتُها. العلاقة معها التي رأيتُ فيها في البدء واحة وئام وسكينة في بحر الاضطراب الباريسي، كانت نقيض ذلك تماماً. فلورا هي بحر الاضطراب عينه. وقد بدأ التحوّل حين أبلغتني ذات مساء رغبتها في السفر إلى جزيرة برَايا البريتانيّة لتمضية بعض عطلتها الصيفية. لم تطلب منّي مرافقتها إلى هناك ولم أسألها ذلك. عند عودتها إلى باريس، لم تتّصل بي وتوارت نحو أسبوعين عن ناظري، فتّشتُ خلالها عنها في كلّ مكان فلم أعثر لها على أثر. حينئذ بدأ هيامي بها، الذي لا يزال يمتلك نفسي بالقوّة عينها، فلم يفتر لهيبه ولم يستكن منذ سنين عشر، ولا أدري إذا كان سيستكين يوماً.كان ولهي بلورا سلسلة طويلة مضنية من اللقاءات والفراقات، في خضمّ التحوّلات المفاجئة وغير المفهومة التي تطبع شخصها. هي مفاجئة وغير مفهومة في نظري، وليس في نظرها، الذي لم أدرك سرّه قطّ. أغلب الظنّ أنها تبادلني الشعور نفسه، فترى أفعالها مبرّرةً تماماً وأفعالي مستغربة، وأنه يستحيل عليها ولوج سرّي. كرّس هذا المأزق، أنّ لورا لا تحبّ التعبير الكلامي، وترى على الأرجح أنّ فهم الأشياء لا يمرّ أوّلاً بهذه الوسيلة، ومجرّد الاضطرار إليها تأكيد أنّ الواحد لا يعي ما في الآخر ولا يتفاعل بعمق معه. هكذا، كان كلّ نقاش يزيد الطين بلّة.كرّس هذه الحال أيضاً أنّ أحدنا لم يعد يستطيع التخلّي عن الآخر، وبات كلٌّ منّا محور حياة الآخر. كان الوله بلورا مزيجاً مأسويّاً من اللذّة والألم، والسعادة والتعاسة، واليأس المطبق والأمل المتجدّد، والنعيم والجحيم، لكلّ منّا، فكيف الخلاص؟ لم تكن فترة الوفاق لتدوم أكثر من أسبوع أو أسبوعين، كذلك فترة الفراق. طوال هذه السنين العشر، كان يبدو الوفاق، في كلّ مرّة، نهائياً لا شكّ فيه، يحمل ألق اللقاء الأول ووعوده، كذلك القطيعة والانفصال يبدوان نهائيين حاسمين لا عودة عنهما قطّ. مع ذلك، لا يلبث أن يحلّ وقت العودة، محفوفاً بالأشواق التي لا تُقَاوَم، ومغلّفاً في كلّ مرّة بأسباب وحجج لا تخطر على بال، على رغم ما بذلتُه من جهود يائسة للنسيان. غالباً ما كنت أنا صاحب مبادرة العودة. حين أتأخّر كثيراً كانت تأخذ هي المبادرة. وغالباً ما كانت تقول همساً، مستسلمةً لقدر أقوى منها بكثير: "لا شيء ينتهي حقّا".فقط بعد سفر هنري مارتي إلى أميركا ووجودي وحدي في دارة اللواريه، بدأتُ أصطحب لورا إليها. وفي يوم مضيء من حزيران، كان شوق أحدنا إلى الآخر قويّاً، عاصفاً، وكان التواصل عميقاً، مؤثراً، بيننا، فبقينا طوال النهار معاً في بيت اللواريه. عزفتْ لورا في وقتٍ ما بعد الظهر على البيانو، وهي تجيد العزف، ألحاناً أحبُّها، اختارتها خصّيصاً لي، أصغيتُ إليها بشغف وتسرّبت إلى أقاصي ذاتي. استعدنا زيارتنا الأخيرة إلى بروج حيث كادت عربة الخيل المجنونة تصدم لورا فنجت منها بأعجوبة، وتذكّرنا الفندق الصغير الغريب الذي وقعنا مصادفةً عليه في كانّ القديمة، الذي كانت تديره أختان طاعنتان في السنّ ترتديان الأسود، وترتفع في باحته المسوّرة نخلتان كبيرتان، وأنا أحنّ دائماً إلى العودة إليه، مع أنّ إقامتنا فيه لم تكن تغمرها السعادة.تكلّمنا على أمور كثيرة، بهدوء وشغف، في تلك السكينة، التي كانت تخفرها في الخارج زقزقة العصافير وأصوات الغابة. كانت لورا ترتدي فستاناً صيفيّاً خفيفاً فاتناً، ناعم الزرقة، منسجماً مع لون عينيها وموشّى بزهور صغيرة صفراء. كان جوٌّ من البوح والصفاء التامّ يسود بيننا، وأحدنا ممسكٌ بطمأنينة واستسلام عميقين بيد الآخر. في لحظة ما، بعد فترة من الصمت، نظرت لورا إليَّ وطرحت عليَّ، لا أعلم لماذا، السؤال الآتي: "ما هي القصّة الأغرب في حياتك؟". فوجئتُ بسؤالها ولم أشأ القول بأنّها قصّتي معها. أجبتها: "هناك قصص غريبة عديدة في حياتي". قالت: "أودّ لو تخبرني إحداها".أمعنتُ التفكير قبل أن أجيبها بـ"أجل"، ثم نظرتُ طويلاً إليها وأكملتُ: "لم أتحدّث إليكِ من قبل عن ذلك. كانت لي مراهقة صعبة للغاية. ما بين السادسة عشرة والتاسعة عشرة من العمر، وراء مظهري البالغ الهدوء، كنت حسّاساً إلى حدّ أنّ هبوب النسيم يجرحني، ومثاليّاً على نحو لا يُعقل، كأنّي لست من هذا العالم، وكانت نفسي مسرحاً لأشدّ العواصف وأقسى الهواجس. أعتقد أنّ الحبّ الأوّل كان هو الشرارة التي أطلقت كلّ ذلك، لست أدري، وهو حبّ عذريّ لفتاة في مثل عمري كنت أراها واقفة على الشرفة المقابلة. طوال تلك السنين الثلاث، لم ألتقِ ولا مرّة هذه الفتاة، ولم أتكلّم معها قطّ، وأنا لا أعرف اسمها حتى، فأدعوها "فتاة الشرفة". كان ذلك الحبّ نبع العذابات التي لا توصف، ومصدراً لاضطراب هائل في علاقتي بالطبيعة، حيث كانت تَمْثل تلك الفتاة على مدى الوقت، ليس في ذاتي المتألّمة فقط، بل في كلّ مشهد أراه. كنت أجهد في اقناع نفسي بأنها ليست موجودة في المشهد، لكنّي عبثاً كنت أفعل. فأنا لم أتصّور يوماً أنّ لاعقلانية الشعور يمكن أن تصل إلى هذا الحدّ. كما كانت "فتاة الشرفة" مصدراً لرؤية مأسويّة لهشاشة الجسد البشري لم تكن تفارقني، ولا أوّد الآن استعادة تفاصيلها الموجعة، وكانت مبعثاً لهواجس كثيرة أخرى تنوء تحتها الأنفس الأكثر قوّة. كنت أتساءل في سرّي خلال تلك السنين إذا كان ثمّة انسان آخر عرف قبلي مثل هذه العذابات المبرّحة، وإذا كان من انسانٍ مرّ بمثل هذه التجربة. لا شكّ في أنّ ما حدث لي في تلك المرحلة من العمر، كان سيحدث في أيّ حال، بـ"فتاة الشرفة"، أو بشرارة أخرى سواها".كانت لورا تتابع كلامي باهتمام بالغ، وتنمّ عيناها ووجهها عن مدى تشوّقها لمعرفة ما سيجري. توقّفتُ قليلاً ثم أكملتُ: "بعدها، غادرتْ تلك الفتاة وأهلها إلى منطقة أخرى ولم أعد أعرف عنها شيئاً، وعمل الزمن على بلسمة جراح نفسي، فانطوت حقبة المراهقة وأنواؤها. بعد سنوات عديدة كانت هجرتي إلى باريس التي انتقلتْ حياتي إليها. كنتُ في وقتٍ ما أعطي درساً خصوصياً في اللغة في حيّ بولونيه، مرّتين في الأسبوع، آخر بعد الظهر. ذات مساء دافئ وكان الوقت قد تأخّر بعض الشيء، نزلتُ إلى "محطة أوتوي" لقطار الأنفاق في طريق العودة إلى البيت. كان رصيف القطار خالياً إلا من امرأة واحدة أنيقة الشكل واقفة تنتظر. تأخّر القطار فصرت أتمشّى قليلاً. وحين أضحيتُ على مقربة من تلك المرأة التي بدت في الخامسة والعشرين من العمر، ونظرتُ إليها ونظرتْ إليَّ، كاد قلبي يتوقّف عن الخفقان وتمالكتُ نفسي كي لا أقع أرضاً. كانت المرأة تشبه إلى حدٍّ مذهل "فتاة الشرفة"، كأنّها هي نفسها. لا أدري إذا كانتْ أدركتْ في صورةٍ ما اضطرابي، إذ إنّها اقتربتْ بعد قليل منّي فحيّتني وسألتني إذا كان القطار سيتأخّر كثيراً. قلت لها: "لا أعرف".لم تعد إلى مكانها بل ظلّت واقفة بقربي. وحين وصل القطار، دخلنا المقصورة نفسها التي لم يكن فيها أحد، فجلست المرأة على المقعد إلى جانبي. تبادلنا على الطريق أطراف الحديث جاهداً في إخفاء تأثّري وارتباكي. سألتْني أين سأنزل. قلت: "في محطّة مابيون". أجابتني: "أنا كذلك". حين خرجنا، اتّفقنا أن نرتاد قليلاً مقهى الـ"مابيون" لاحتساء القهوة. خلال اللقاء، عرفتُ أنّها رسّامة، وشعرتُ أنّها تودّ مرافقتي إلى شقّتي. قالت إنّها تحبّ التعرّف إلى حيّ حديقة مونسوري حيث كنت أقيم. لم أرتح للسرعة التي تطوّرت فيها الأمور بيني وبين هذه المرأة، التي من جهة بالكاد أعرفها، ومن جهة أخرى كأنّها تسكن عميقاً في نفسي. وجدتُ لها عذراً لعدم الذهاب. لكنّها لم تلبث أن دعتني لمرافقتها إلى شقّتها التي هي محترفها أيضاً، لتريني أعمالها، فعدنا أدراجنا في قطار الأنفاق. كانت تقيم في الطبقة الخامسة من بناء أنيق مطلّ على جسر ألكسندر الثالث في ذلك الحيّ الراقي. أخذنا المصعد، وما كدنا نلج الشقّة ونغلق الباب وراءنا، حتى قامتِ المرأة بخلع ثيابها كلّها ووقفتْ عارية تماماً أمامي. قالت همساً: "أنا أعرف فوراً الرجل الذي أهوى". ذهلتُ لذلك، وقلت لنفسي: "هذا هو جسد فتاة الشرفة الذي طالما هجَستَ به وكواكَ الشوق إليه". لكنّي لم أقدم على لمسها. بعد تلك الليلة ما عدنا التقينا ولا مرّة".توقّفتُ عندها عن الكلام وحلّت فترة من الصمت اشتدّت خلالها زقزقة جوقات العصافير المودّعة النهار. لم تطرح عليَّ لورا بعدها أيّ سؤال، لكنّها قامت وارتمت بين ذراعي، واتّحد جسدانا بهيام عميق، ثم أخذتْنا إغفاءة وجيزة صحونا بعدها ولم يبقَ من الأصوات حولنا إلا شدو العندليب وحفيف أجنحة بعض الطيور الكبيرة الذاهبة إلى مأواها.قالت لي لورا إنّها تودّ القيام بنزهة قصيرة وحدها قبل حلول الظلمة. أجبتها: "تأخّر الوقت قليلاً، أليس كذلك؟". قالت إنّها تحبّ كثيراً هذا الوقت. تأمّلتُها من النافذة وهي تبتعد ببطء. لم تتّجه إلى حديقة المنزل، بل سلكت الدرب الضيّقة الموصلة إلى الغابة والبحيرة. جلستُ أنتظرها في هذه الساعة الفاصلة بين النهار والليل التي لها تأثيرها السحريّ فيَّ. في لحظةٍ ما، أدركتُ أنّه طال غيابها، إذ اختفت تماماً أصوات الطيور، وأخذ يحلّ محلّها غناء الزيزان ونقيق الضفادع في المستنقعات القريبة.نزلتُ إلى تحت وبدأتُ أناديها بأعلى صوتي في كلّ اتّجاه: "لورا، لورا"، فلم أعثر عليها. عندئذ، أخذتُ المصباح الكبير واتّجهتُ داخل الغابة نحو ضفاف النهر واجتزتُها وأنا أنادي بكلّ قواي، وقد خنق القلق صوتي، "لورا، لورا"، مجفّلاً الطيور الراقدة التي راحت تفرّ خائفةً من حولي. تصاعد قلقي على نحو بالغ وانطلقتُ أركض متعثّرا في عتمة الغابة إلى أن وصلتُ إلى البحيرة، فأسرعتُ إلى الجسر الخشبي علّني أجدها في المقصورة العائمة. وما إن دخلتُ المقصورة حتى رأيتُ من نافذتها على ضوء المصباح، يا للهول الذي لا يوصَف، رأيتُ لورا طافية على ظهرها على سطح الماء بلا حياة، بجسدها الحبيب الهامد، وفستانها الأزرق الموشّى بالأزاهير الصفراء".
فصل من رواية "غريقة بحيرة موريه" لأنطوان الدويهي، صادرة عن "الدار العربية للعلوم-ناشرون"، و"دار المراد".
التعليق
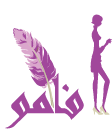

 من نحن
من نحن أشواك الورد
أشواك الورد قصاصات.كوم
قصاصات.كوم متابعات
متابعات فضاء للبوح
فضاء للبوح سرديات
سرديات قصائد
قصائد آراء حرة
آراء حرة في المرآة
في المرآة الأسوأ
الأسوأ دليل فامو
دليل فامو Boutique FaMoh
Boutique FaMoh Café FaMoh
Café FaMoh إتصل بنا
إتصل بنا