مرّة أخرى ألتقي بجوهر، ولأوّل مرّة لا يتملّكني ذلك الشعور الذي ينتابني كلّما التقيت بها، فأتحوّل إلى عصفور معلّق على غصن روحها الشفافة.
وحده الحبّ الذي يسكننا لسنوات يجرّدنا من أثقال الجسد، ويرسمنا ريشا متطايرا في الفضاء ،كلّما تجدد فينا و تحركت مياهه الراكدة في عروقنا..
كانت لا تزال تتناول الغذاء رفقة أمي وأخويّ، يفترشون زربية حمراء تتقاطع فيها خطوط سوداء في مزيج بعث الدفء في أوصالي الباردة، جلست في تكاسل على أريكة تقابلهم ثمّ قلت لهم بحماس من لا زال مذاق شيء شهيّ يأسره:
-تناولت وجبة لذيذة عند سي مختار.
لكنّ والدتي أصرّت أن أجلس إلى المائدة لأتذوّق كسكسها اللذيذ. نهضت مثقلا بشيء لم أستطع تحديده في تلك اللّحظة، جلست إلى جانب والدتي، فقابلني وجه جوهر الملائكي، حوّلت نظري إلى طبق الكسكسي، الصّمت خيّم على المكان، نقلت لهم حالتي، سحبي والضباب الذي أحاط بلحظاتي فلم نعد نسمع سوى صوت الملاعق. إحساس غريب تملّكني، رفع رأسي عن الطبق، ها هما عينيا تلتقيان بعينيّ جوهر، فأشعر بفنائي فيها وقد امتزجت روحي بروحها منذ الأزل، فصار لقاؤنا يتوهّج بالنور ويعف عن ظلمات الجسد.
تجلّى فيها النور أكثر وهي تجلس على بساطتها كملكة متوّجة؛ إنّها تسحرك حتى وهي تجمع الأطباق وتنظّف المائدة تتحرّك، ضفيرتها الطويلة كغزال يلاحقها. نهضتُ لأنزوي إلى ركن من البيت تنبت فيه شجرة العنب، تتطاول أغصانها عاليا تعانق عين الدار المنفتحة على الفضاء، تمنحنا مجالا لرؤية السماء أكثر زرقة.. جلست على مقعد خشبي للاستمتاع بأشعة الشمس، لعلّ السحاب ينقشع من روحي. ها هي جوهر قادمة بفستان وردي تزيّن حواشيه رسوم لأزهار بألوان زاهية تستحضر الربيع في الأجواء. كانت تحمل صينية الشاي كملاك يحمل هداياه النورانية إلى أهل الأرض ليخلّصهم من شقائهم، وأشعة الشمس تنظر إليها بخجل، ونور عينيها يمتزج بالشاي الذي تسكبه في كأسي ليتجلى لي الكون في موكب نوراني تقوده هذه الجوهر بسحرها. قديما قيل العقل نور والجمال نور ولا يدرك النور إلا النور.. امتدّت يد جوهر نحوي كما تمتدّ موجة بحر وهي تناولني كأس الشاي، في عينيها قرأت نظرة العاشقة، وهم لم يعد يناسبها أن تعيش فيه،
ولم يعد يسعدني كما كنت في وقت مضى. حدّثتها عن رغبة عيسى في الزواج منها. ارتبكت وتحوّل النور من حولها إلى دخان.... كان عليّ أن أرجّ قلعتها، أن أسقط أبراجي، جندي، حرسي، أن أحرّر أميرتها.. عليها أن تشفى منّي، مثلما شفيت منها؛ كثيرا ما يعيد القدر ترتيب أمور بشكل لا نتوقعه، لكن يكفي أنّه الشيء المريح لنا..
الصمت غزل شيئا غمر وجهها ، جعله يبدو بعيدا عنّي، سألتها:
-ما رأيك جوهر؟
نكّست رأسها، غرست ذقنها في كفّ مرتعشة وهي تنظر إلى الأرض وتقول:
-يهمّني قبل ذلك رأيك ورأي خالتي.
-أنا موافق وسعيد لأجلك، وستكون والدتي أسعد منّي بالخبر.
شبح الابتسامة الذي زار شفتيها المكتنزتين أراد أن يطمئنني بأنّ الأمور ستجري كما نريد جميعا. احتسيت الشاي، وضعت الكأس في الصينية فارغا، كما نُفرغ من ذكرى لازمتنا لسنوات.
خبر العريس الذي تقدّم لخطبة جوهر أعاد اللون الوردي يغمر وجه أمّي، ويبثّ النشاط فيها كما لو أنّها صبية في ربيع العمر. كنت دائما أحتار من فرحة الأمّهات كلّما اقترب موعد مغادرة البنات للبيت العائلي إلى بيت الزوجية، رغمّ أنّهن يحزن بعد ذلك لفراقهنّ، ويذرفن الدموع يوم الزفاف. أسرار كثيرة كانت تحيط بهذه اللحظة بالنسبة لي وأنا صغير، الآن ولم يبق على موعد زفاف جوهر إلا يوم واحد صرت أتقاسم معهنّ هذا الشعور، أتقاسمه على الأقل مع أمّي، هو مزيج من الفرح لأجل جوهر
وبالحزن حين تغيب عن البيت. رنين هاتفي كان أشبه بمعول نزل به عيسى على وتر السكينة الذي طوّقني ،جاءني صوته الأجش ليخرجني من جوّ طرّزت غيمه أفراح جوهر . كان نذير شؤم، لم يكف بعد عن إلحاحه كي أساعد المقاول المجرم لإتمام سكنات لا تليق بالإنسان. أقفلت الهاتف، لم أعد أبالي بحديثه المهترئ. سي بلقاسم من الوجوه التي جمعني بها بيت سي مختار هو صديق عيسى، دعاه للانضمام إلينا، لكن من أوّل يوم عرف بأنّ ما يجمعنا لن يكون سوى سقف بيت سي مختار، كما يجمعنا تراب هذا الوطن. موجة برد تلبّستني احتجت إلى دفء الجلابة التي أهدتها لي والدتي. لونها البنّي يحاكي الدفء في بيت جدّي المتراكمة بقاياه في أطلال القصر. لبستها كأنّني ألبس مدينة بكاملها.. الأيدي التي نسجتها لا تختلف عن الأيدي التي عجنت طين طوب القصر.. غادرت البيت ورغبة ملحة تسحبني إلى مقهى عمّي رضوان، وكأنّما اهتديت في الشارع إلى مخرج من لحظة متأزّمة. رائحة التربة الندية الممزوجة بقطرات المطر فتحت النوافذ مشرّعة أمام روحي للتخلّص من ثقل أنهكها ومن صوت عيسى وشريف
وبلقاسم .. المساكن بدت كشيوخ انزووا إلى ركن في المدينة محتمين به من الغد المجهول. منظر متسوّلة تضع ابنها نصف عار في حجرها في جوّ بارد، أربكني، وجدت نفسي منقادا إلى الصغير، وضعت قطعة نقدية في يده، صرخت المرأة نشوانة من الفرح وهي تدعو لي بالخير. تطلّعت في وجهها، كانت فلقة من قمر.. أدرت ظهري لها وسرت في طريقي إلى مقهى عمّي رضوان.
ظلّ دعاؤها لي يمطر شيئا من الرذاذ ممزوجا برمل حارق اكتسح روحي. استوقفني طفل يبيع السجائر التي أحرقت كثيرا من براءته، لبس وجه الرجل الكبير وراح يعرض عليّ بصوت أجش ماركات في طاولة لبيع السجائر. صوت والدتي كان أقوى، تردّد صداه في شرخ استوطن الذاكرة:
- "دعوة الشر درتها لك في القارو". حرائق السجائر حزنا على زوجتي فريدة لم تشف منها السنوات العشرون التي قضيتها وحيدا منذ رحيلها وهي تهبني ابنتي أمل، لتدخل أمل الحياة من بوابة و تخرج منها فريدة من البوابة الأخرى، السيجارة لم تعجّل لحاقي بها، فقررت إسكات لهيب الدخان من حولي مثلما نسكت صوت قطار. كنت على فراش المرض حين أعلنت موت آخر سيجارة في حياتي إرضاء لوالدتي، وخوفا من دعوة الشر. اليوم كنت بحاجة إلى ممارسة فعل الخيانة، لكن ليس بحجم خيانة سي بلقاسم و لا سي بن يونس ولا غيرهما ، هي خيانة بحجم قارو؛ وقارو واحد حتى يسهل عليّ التكفير عن الخطيئة والتخلص من لعنة دعوة الشر، قلت له:
-واحدة فقط.
رمقني بنظرة غريبة، سلّمني السيجارة، تأمّلتها وضحكت ضحكة أربكته. طلبت منه أن يشعلها، سحبَ قدّاحة من طاولته وأشعل سيجارتي، أمسكتها بين إصبعي، كما نمسك ممنوعا لحظة اقتناص الفرصة الممكنة. كنت بحاجة إلى هذه السيجارة ، كما نحتاج لعود كبريت كي نحرق صورة تنتهي أمامنا إلى رماد؛ حين نتخذّ قرارا بحرق صورة كانت جزء من حياتنا ،نكون تخلّصنا من الماضي. دخلت المقهى، جلست إلى طاولة كما نجلس إلى صديق نحتاج أن نبوح له بما يؤلمنا. سرّ يسكن زواياها ساعدني على ترتيب أفكاري و جمع شتاتها،فمن الأحداث ما يفجّرنا فتتطاير أمانينا و تتشظّى أفكارنا كوقوفي أمام كمال و هو يحاول إقناعي بمساعدة سي بلقاسم في إتمام مشروعه الذي سيكون الجرف المطلّ على حافة الموت لمائة و خمسين شخص .و أن يعرض عليّ ذلك المقاول النتن مبلغا قد يكون رأس المال الذي أحقق به مشروعي مقابل أن ينجح مشروعه ، اقتلعني من جذوري و أبقاني لوقت جدار سور تهاوى بفعل القدم. طلبت من النادل فنجان قهوة ، لعلّ عبق رائحتها ينهي وجعا تحرّك داخلي.صورة جوهر كانت ما تزال مرتسمة في ذهني، ها هي تُنتزع منّي كما تنتزع منّا الأرض التي تمتدّ فيها جذورنا إذا لم نحافظ عليها. سحبني رماد السيجارة إلى ذكرى أوجدت لها فاصلة في ذاكرتي . يوم وقفت جوهر أمامي بفستان أحمر امتلأ به جسدها الفاتن، سحبت ضفيرتها الطويلة على كتفها فتدلّت متخذة صدرها جسرا لتتدلى إلى أسفل خصرها ..الشمس يومئذ كانت تميل للغروب فوق سطح بيتنا ،و كانت هي تمسك قبضتها على ملابسي التي غسلتها ، بقايا أشعة داعبت خدّها الأسيل، و تحرّك رمشها كسعف نخيل لاعبته النسائم في واحة بديعة. تحرّكت رغبة داخلي، تأرجحت بين إلهي و شيطاني، اضطرمت نار شوق بين أضلعي ، أطفأها طيف فريدة الذي سكنني طويلا . جوهر كانت كقطعة من نور يشدّك إليها الصفاء و ما تكتنزه ضفيرتها من أصالة و ما يعبق به نقش الحناء في يديها ليشي بمعدن أنوثة تزرع الأمومة في حدائقنا. ما لم تكن قد أدركته هو أنّ اتحاد روحينا انتشلنا فوق ظلمات الجسد. انتظرت أن تطلب شيئا فقالت: اشتقت إلى أمل. بدل أن تقول لي أريد أن أكون أمّا لابنتك أمل، أريد أن أكون لك، كثيرا ما تكون اللغة أعجز من أن تفي بالقصد . يومها أخذت نفسا عميقا من سيجارة،ثمّ سحقتها في إصّيص نبتة ظلّت صغيرة ،و اكتفيت بأن قلت: -سأحضرها قريبا لتعيش هنا مع والدتي. لحظتها اكتسحت عذوبة الواحة في عينيها قطرات رقراقة ، سلّمتني ملابسي بيد مرتعشة و مضت. و بقيت واقفا أتأمّل غروب شمس سحبت معها حلما طالما اقتات عليه قلبها المحب. كنت ساعتها أفكر في سفر ينتظرني ضمن بعثة لتكوين المهندسين في باريس.
و سافرت إلى باريس ، هنالك تعرّفت على سعاد، كانت تشتغل في الأعمال الحرّة ، سيّدة أنيقة في الثلاثينات من عمرها، شعرها الأشقر و عيناها الزرقاوان جعلاني أقول لها:
-أنت تشبهين الباريسيات.
تلألأت أسنانها و هي تبتسم و تقول:
-والدتي فرنسية و والدي جزائري.
كلّ تصرّفاتها فيما بعد رسمت ملامح المرأة الفرنسية فيها. عطرها كان أكثر ما يشدّني ، لكنّ الفراغ الذي تركته فريدة رحمها الله هو الذي بنى مدن سعاد في حياتي.
توطّدت علاقتنا، صارت لقاءاتنا تتكرّر نهاية كلّ أسبوع. سألت نفسي : هل أحببتها ؟
لأنّنا عندما نحبّ نلبس وجه الحبيب و ننتعل الذاكرة..السؤال اجتاحني و أنا أقول لوالدتي:
-قد أستقرّ هنا، في باريس.
منذ شهر فقط و أنا أزورها بعد غياب قلت لها:
-هاذ الطوبة ما عندنا عليها وين ، أنهي الدراسة و أعود.
ها أنا غيّرت رأيي ،هي أعراض الحبّ إذا.
حمُىَّ الحبّ تمكنت منّي، سحبتني إلى عوالم سعاد ،اعتقدت في لحظة بأنّني دخلت الجنّة و ضمنت إقامة بها، لكنّني اكتشفت بأنّ رفيقتي لم تكن حوّاء . وجدت إبليس بخططه الجهنّمية. بحثت في سعاد عن تلك العاطفة المتأجّجة التي تفجر ما بداخلي من مشاعر و سعادة ، فلم أجد غير كائن بارد مغرور .. اعتقادا منها بأنّها أرقى و أفضل منّي ... أنا كنت ضحية عندما صدّقت مقولة بلزاك "الحبّ كالموت لا يعترف بالطبقات و لا بالثروة و لا بالحياة" ، وحده قلب جوهر يعرف كيف يحبّ. الوحش فيها لم يشبع من جمع المال و إبرام الصفقات .حاولت تجاهل حديثها عن مشاريعها التي لا تنتهي .سألتها عن ما الذي يشدّها إليّ و هي امرأة فاتنة و سيّدة أعمال ناجحة،حدجتني بنظرة ألهبت شيئا في روحي و تمتمت:
-أنت الوحيد الذي أثق فيه.
قدّمتُ لها عطرا باريسيا هدية، دعوتها للعشاء، همست في أذنها :
- لن أخذلك أبدا.
كان العشاء فاخرا ، الأنوار و الألوان في ذلك المطعم الراقي كانت تتراقص في دلال، توجد لنفسها ممرّات في وجهينا و حتى في أعماق روحينا.
أو أنّني حاولت رسمها كذلك لأعطي لنفسي فرصة أن أفرح، أن أنتصر على شعور بالإحباط بدأ يتسرّب إلى داخلي و هي تحدّثني عن قلقها من صفقتها الأخيرة . الأدوية التي زوّدت بها بلدي منتهية صلاحيتها..تورّطت مؤسستها في تزوير تاريخ انتهاء مدّة الصلاحية.
ثقتها بي جعلتها تسرد عليّ علاقاتها المشبوهة مع أيد قذرة هنالك تلوثّ وطني و تجلب المرض لأبنائه. .
وقعت في مأزق اللغة ، لم تسعفني الكلمات للخروج من وحلها.. الحقائق كالفجائع تماما لها القدرة على أن تخرسنا.
خيّم علينا الصمت، صوت الكمان وحده كان ينتشر مع الأضواء كغيمة وردية نلمسها بأرواحنا ..كانت سعاد تنظر إليّ بين الفينة و الأخرى ، الأكيد أنّها عرفت بأنّ شيئا تكسّر بداخلي، أخرجت زجاجة عطرها،
و ببخّات بسيطة على فستانها أعادتني إلى الواقع ، أخفت زجاجة عطرها في حقيبتها و هي تعدّل من جلستها ، انتبهت إلى أناقة فستانها الأرجواني، لكنّني ركّزت نظري أكثر على سحر عينيها الزرقاوين، و ظلال ساحرة تتكسّر من خصلات شعرها الأشقر الفاتن عليهما. رغم ذلك تراجعت عن قرار الزواج منها ، تحرّكت جذوري لتعيدني إلى تربة أرضي .
في حفل زفاف جوهر كانت الزغاريد تشيّع فرحي، و كان الضرب على الدف لا يختلف عن القرع على طبول حرب أعلنتها الحياة ضدّي. إنّنا في اللّحظة التي نتخلى فيها عن الآخر، تكون الحياة قد تخلّت عنّا ،و لو بشكل مؤقت لتسلّمنا للحيرة خاصة عندما يلاحقنا شريط الذكريات بكل محطاته .
عدت إلى بيتي بعد انتهاء حفل الزفاف،و لأول مرّة أشعر فيه بالوحدة . قبل الليلة كان ممتلئا بطيفها، أو كما قال أحدهم "بعض الناس يجعلون حياتك سعيدة ، فقط بتواجدهم فيها".
دخلت غرفتي و كأنّني أدخل كهف وحش سيفترسني ، الستائر بدت ألوانها كجيوش منهزمة، أقلامي مبعثرة، و الأوراق عطشى لتصميم لم يكتمل ..
ارتميت على السرير كأنّني أهوي من مرتفع ، وضعت رأسي على المخدة لعلّ النوم يسعف شيئا تألّم داخلي.
الصباح موعد آخر مع عمّي حمّو و مع حكاياته الطريفة ..
موعد أيضا مع فصل من عذابات الحديث عن مشروع لا يريد أن يكتمل.
قرّرت مقابلة المدير، و عرض المشروع عليه قبل الاجتماع الذي لم ينعقد.
ودّعت عمّي حمو، أقلعت بسيارتي، مررت بجسر الدبدابة ، كان الوادي في حالة فيضان، يلهث وراء أقدار المكان ، يجري ، يحفر في الأرض..غمرني بفرحة تحدّث عنها عمّي عاشور، عندما قال لي مرّة بأنّ فيضان الوادي كان فصلا من فرح لسكان القصر، يمنح الأرض وجه الأمّ الحنون لتغدق عليهم حنانها ، خيراتها...تلبس البساتين خضرتها ، و تهنأ أشجار النخيل بعراجينها..
العراجين تدلّت اليوم وجعا في ذاكرة عمّي عاشور ، وبقايا البساتين
أشباح تتوكّأ على جدار القصر، النخيل شاخ ...في الوادي "قلتة حمو قيو" تلك البركة التي لا ترحم ، كثيرا ما نسب سكان الحي سبب شلل أبنائهم إلى العفريت الرابض فيها ،ثمّ أدركوا بأنّ العفريت ما كان سوى التهاب السحايا.
وصلت إلى المؤسسّة ، فيضان الفكرة في ذهني جرف كلّ لحظة للانتظار. توجهت إلى الإدارة أطلب مقابلة المدير.
السكرتيرة طلبت منّي أن أنتظر ، لكن أمام إلحاحي ، أشارت بيدها:
-تفضّل.
إحساس يلازمني دائما بأنّ الدخول إلى مكتب مسؤول كالسقوط في هاوية.عليك أن تتهيّأ لتشوّهات الكذب ، لجراح السخرية ، لكدمات النكران.، تهيّأ للكسور و حتى للعطب، ما دمت لم تزر مكتب مسؤول فأنت بخير.
طرقت الباب، دلفت المكتب . كان المدير يلبس وجه الكبير ، الذي يملك السلطة ، يده ارتسمت عليها ظلال الإمضاءات، لا يراها إلا من مزّقت الإمضاءات أحلامه، أنفه المعقوف و شاربه الكثّ و تلك العقدة بين حاجبيه تفاصيل جعلت قلبي ينقبض إلى درجة شعوري بالاختناق . أشار لي بيده أن أجلس .
تحدثت في الموضوع بدون مقّدمات:
-أحضرت لك البطاقة الفنية لمشروعي الذي تأجل أكثر من مرّة.
دون أن يلقي نظرة على الملف، قال:
- مشروعك يا سي فاتح لا يصلح في مدينة.
قلت له بأنّ مدينتنا صارت مساكنها بدون هوية ، ما أردته هو مجرّد فرصة أجرّب من خلالها جمع شتات المجتمع.
العبارة الأخيرة استفزّته: ارتفع صوته و هو يقول:
- سي فاتح رجاء ، نحن نعوّل عليك و لدينا ثقة في كفاءتك، رجاء أكمل التصاميم التي اقترحناها عليك و أجّل الحديث في هذا الموضوع.
خيبة أخرى تسلّمني لإحباط شديد.. غادرت مكتبه ،مشيت في رواق تناسلت المذكّرات على جدرانه و لا جديد، دخلت إلى مكتبي مثقلا بأفكار عديدة ..لا استسلام أمام كبوة الإمضاءات..أو كما قال أحدهم:
نحن نسقط لكي ننهض، و ننهزم في المعارك لنحرز نصرا أروع ، تماما كما ننام لكي نصحو أكثر قوة و نشاطا. خرجت من أفكاري على صوت زميلتي رقية :
-صباح الخير فاتح.
-صباح الخير.
تطّلعت في ملامحها لأستحضر ملامح المهندسة سارة كما نستحضر مدينة في شوارع غربتنا، سألتني:
-هل وافق المدير على مشروعك؟
لم أستطع النطق بكلمة لا، هذه ال"لا" كانت لحظتها أثقل من الجبل، وقفت غصّة في حلقي، اكتفيت بهزّ رأسي لأفرغه من شيء علق به ...الصدمة قد تكون بحجم ذبابة تباغتنا و تنزلق عبر أحد تجاويفنا.
الخيبة أجلست رقية على الكرسي و هي تقول:
-للأسف المشروع أعجبني كثيرا ، هم يرون في السور مؤشرا للعزلة.
-لولا العزلة لما خرجت اليابان أقوى.
قلت هذه الجملة لتجحظ عينا رقية الواسعتين وسط وجه أسمر ممتلئ و أنف ينتصب بشموخ على شفتين شهيتين، أسئلة كثيرة تحرّكت فيهما ،فأطبقتا عليها مرتجفتين.
أمّا السؤال الذي حفر شيئا في أعماقي كان عن ذلك التاريخ 1258م الذي سقطت فيه بغداد على يد المغول ، هو نفسه التاريخ الذي تبنّت فيه اليابان فلسفة وضع الشخص المناسب في المكان المناسب ، كان الإعلان عن الوظيفة يتمّ عن طريق تجوال الموظّفين المكلّفين بالإعلان في الطرقات و ضرب الطبول للفت انتباه الناس. من هنا بدأت انتصارات اليابان و قوتها عندما وضعت الشخص المناسب في المكان المناسب. و بدأت هزائمنا يوم وضع مثل مدير مؤسستنا في غير مكانه.
انتبهت من هواجسي على جملة قالتها رقية:
-لا تقلق فاتح ، للأمور توقيت محدّد تتحقق فيه.
الجملة نزلت بردا و سلاما على قلبي،فشعرت بطعم خاص لابتسامتي التي رغما عنّي طبعت وجهي المتعب. نظرت إليها في امتنان فاستحضرت ملامح المهندسة سارة في وجهها الهادئ. وجدت نفسي أسألها عنها بعد أن لاحظت غيابها.نكّست رقية رأسها و قالت:
-المسكينة سارة توفيت والدتها.
تهشّم شيء داخلي من وقع الخبر ، قلت لها:
-هل لديك رقم هاتفها؟
رمقتني بنظرة غريبة ، استدركت قائلا:
-أودّ أن أقدّم لها واجب العزاء.
سحبت رقية هاتفها المحمول من جيب معطفها و أملت عليّ رقم هاتف سارة.
ماتت أمّ سارة إذن ، هذا الموت الذي يباغتنا و يسخر من فرحتنا بإنجازاتنا في هذه الحياة.
الموت أبشع ما يمكن أن يحدث لنا، تساءلت كم من أمّ فجعها بن يونس في ابنها فبكت و لم تجد لها عزاء ؟
اتصلتُ بسارة ، قدّمت لها تعازي و أنا الذي كان بحاجة إلى عزاء في مشروع سيدخل غرفة الإنعاش، ثمّ يقبر ، كما تقبر ذاكرة.
انصرفت إلى عملي ، إلى إنجاز التصاميم التي يريدها المدير ؛ لا يهمّه أن تكون مشروعا لبيوت بلا ملامح ، بلا ذاكرة ، غريبة عن رمل المكان، عن نخيله و تربته.، لا يهمّ إن كانت ستزيد في غربة الإنسان ..المهمّ أن ترتفع تلك العلب الإسمنتية في مدينتنا لتصبّر أحاسيسنا و علاقاتنا الإنسانية ، و لا أحد يعرف متى تنتهي مدّة صلاحيتها...
يومي أثقله قرار المدير ، فكّرت في حلّ للخروج من المأزق . التعامل مع جمعية قد يكون فرصتي لتحقيق مشروعي.الناجحون في الحياة كما قال برنار دشو : هم أناس بحثوا عن الظروف التي يريدونها، فإذا لم يجدوها وضعوها بأنفسهم. اتصلت بمحفوظ رئيس جمعية قصر أشرفت على ترميمه. طلبت منه تحديد موعد نلتقي فيه لأمر مهمّ، قال لي:- نلتقي غدا في مقهى وردة الرمال .
أمضيت يومي كاملا في إنجاز التصاميم ، القهوة كانت رفيقتي تربّت على روحي و تنفض عنّي بعض التعب.
عدت مساء إلى بيتي في تلك العمارة ، وجدته باردا ، موحشا .. قرّرت الذهاب إلى بيتنا لتناول العشاء ، و قضاء الليل هنالك..الإصابة بخيبة ، هي كالإصابة بوعكة تماما ، نحتاج لمن يسعفنا منها ، لمن يرعانا
و يخفّف عنّا الألم.
غادرت بيتي من جديد. و أنا أغادر المرآب تناهى إلى سمعي صوت عمّي حمو:
- المطلوع يا فاتح.
امتلأت بشعور جميل ، تأمّلت وجهه الأسمر المعجون بماء الطيبة. دأب على أن يهديني خبزة مطلوع تعدّها زوجته خالتي ميمونة. هذا الرجل الطيب ينشر جناح رحمة في المكان.شكرته فخبزة المطلوع ستكون هدية مناسبة لأمي على مائدة عشاء يجمعنا في بيت العائلة.
-6-
لو يدري هذا اللّيل كم من ذنب يقترفه في حقي و هو يخنقني بظلامه، يحاول إقناعي بأنّه ممتدّ لا ينتهي، بأنّه الحقيقة الوحيدة في هذا الوجود و ما النّهار إلا حالة عابرة ، نحتاج لإعادة ترتيب الظلمة و النور في حياتنا كي نكمل الطريق، كي نبقى على قيد الأمل...عبقري الإنسان الذي بنى القصر ، حبس الظلام في بعض أجزائه و قهره بمنافذ للنور..الإنسان لا يكون حكيما إلا إذا عرف كيف يعيش بين الظلام و النّور..
المؤكّد أنّ في وجه الليل الكئيب نافذة أمل فهو على الأقلّ يمنحني السكون و الهدوء الذي أحتاجه للوصول إلى البيت ، كي أمنح لوالدتي شعورا بأنّ الشمس أشرقت و أنّ النّهار لا يعقبه ليل.
ما لم أكن أتوقعه هو احتضان بيتنا الدافئ لي ، لم أر في زواياه وحشا كالذي رأيته في مسكني ، لم أشعر بغربة. رغم أنّ جوهر كانت غائبة إلا أنّ عطرها كان لا يزال يستوطن ستائر النوافذ، و كأنّي به بقي لأجل الشمس لتستعين به كي تبعث الدفء في الأرجاء.
جلوسي إلى جانب أخي سعيد يزوّدني ببعض القوة بأنّ لي سورا أحتمي به. عمّي عاشور يقول :الزوج و الأخ و الولد أسوار هذه الحياة .. تأمّلته ، رأيت ضباب همّ كبير يثقل ملامح وجهه ، سألته:
- هل ما زال بوزيد يلاحقك؟.
- ذلك القرش الأزرق، لم أعد أحتمل عفنه.
بوزيد الذي يتهرّب من دفع الضرائب و يستغلّ العمّال، خاصة الفتيات أشنع استغلال فلا شيء على الورق يثبت بأنّهنّ ينتسبن إلى مؤسّسته، عرف كيف يورّط المدير ، صار سلاحه الذي يصوّبه في صدر سعيد ، بعد كلّ عملية تفتيش يقوم بها لمحلاته. وجدت نفسي أقول له:
-هذا النوع من التجار يجب أن يعاقب.
-و من سيعاقبهم يا أخي ، من يعاقب الحوت؟
انتصبت كلمات سعيد أشواكا، أحسست بوخزها في روحي، تشابكت أصابعه و هو يضيف :
-أفكّر في تغيير المهنة.
-أنا أيضا أفكّر في فتح مكتب دراسات لتنفيذ مشروعي.
دعوة أمّي لنا لتناول العشاء سحبتنا من قاع هذا الوضع المقرف.جلسنا صامتين نتناول المردود الحار الذي تعدّه والدتي بالأعشاب البرية و نتابع الأخبار في التلفزيون ؛ أخبار الموت والقتل و التفجيرات والانقلابات، و كأنّ العالم انتهى. طلبت منهم تغيير القناة. إنّنا دون أن نشعر نقتل إحساسا جميلا ضمّنته والدتي عطر التوابل في أكلها اللذيذ، شبيه بالحبل السري الذي ربطنا بها. ضحك أخي الأصغر أمين و هو يقول:
-لم ننتبه يا فاتح.
تمتمت والدتي :
-الله يلطف بنا .
لم أستلذّ طعم المردود الذي أعشقه أكثر من الكسكسي ، نسميه عادة
الطعام الغليظ. مرارة ما تتذوقه النساء العاملات في مؤسسة بوزيد أفسدت عليّ كلّ شيء.قصّة كلّ واحدة منهنّ كما رواها لي أخي سعيد شتّتت فكري، كما تشتّت قنبلة أشلاء الأشياء.
تحدّثنا طويلا ، تشعّب بنا الكلام إلى عتمة علاقات بوزيد على أعلى المستويات، فبدا لي الطريق مسدودا أشبه بالسقوط في نفق مظلم. قلت له:
- لا بدّ من تغيير ،آن الأوان لأنخرط في السياسة.
-لا تذكر لي السياسة ، أنت تعرف موقفي من السياسيين.
-لا أوافقك سعيد في رأيك ، الذي يحمل رسالة نبيلة و يخلص الحبّ للوطن ، سيكون نضاله السياسي هو الدواء الناجع.
تركت سعيد مستسلما لأفكاره و هواجسه ، قادتني خطاي المتعبة إلى الغرفة التي تقاسمتها لسنوات معه . مسحت الغرفة بنّاظري لأمتلئ بعطر الذي مضى ها هنا .
لم تتغيّر كثيرا ، لا زالت وفية للأثاث المصنوع من خشب أصفر من طراز عتيق، يتألّف من سريرين و طاولة مستطيلة عليها إطار ضمّ صورة والدتي في ريعان شبابها ، يقابلها كرسي و إلى جانبها خزانة تزيّنها مرآة صغيرة. ارتميت على سريري لأتخلّص من تعبي، فاحتواني في حنان.
بقدر حاجتي للنوم، احتجت أيضا للاطمئنان على سارة، فكّرت في إرسال رسالة قصيرة على هاتفها النقال، الرسائل القصيرة على هذه الأجهزة الغريبة أشبه بزخّات المطر ، تتلقفها الأفواه العطشى، ترجو بعض البلل.. كتبت لها:
-أرجو أن تكوني بخير.
و استسلمت لنوم عميق.
التعليق
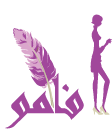

 من نحن
من نحن أشواك الورد
أشواك الورد قصاصات.كوم
قصاصات.كوم متابعات
متابعات فضاء للبوح
فضاء للبوح سرديات
سرديات قصائد
قصائد آراء حرة
آراء حرة في المرآة
في المرآة الأسوأ
الأسوأ دليل فامو
دليل فامو Boutique FaMoh
Boutique FaMoh Café FaMoh
Café FaMoh إتصل بنا
إتصل بنا