سرديات عودة
فصل من رواية "بيوت بيضاء" للكاتبة المصرية هدى توفيق (السبت 15 ت2 2014)
التعليق
تحولت بعد موت فاطمة البلوشية إلى شخص بارد، صلب كالصخر، جافة كأنني إسفنجة ناشفة تعصرها فلا تنزل منها قطرة ماء واحدة، والصدمة وَقَفَتني في بحر من الندم والشعور بالذنب وأنا أستدعي ذكريات الماضي وأنا أرمقها بنظرات الحب والصداقة والغيرة تنهش في قلبي كأي امرأة أحبت من أحب صديقتها الغالية، لأتوارى بمشاعر سلبية خلف نظرات زاهدة قرفانة، لا يستثيرني أي حديث أو شخص إلاّ إدامة التحديق أو إمعان البصر في لا شيء، وروحي منفصل عن جسدي الذي يتحرك كروبوت آلي بين القاعة والحجرة وأحاديث عابرة، شعرت أنني كبرت في تلك الأعوام القليلة، سنوات وأصبحت امرأة شاخت في السن، وأنا أضغط روحي القديم لينزلق في نفق مظلم يحوطه الندم والحسرة، لتصير كل تلك القصص والحكايات علة تنخر في عظامي كالسوس وقد صرت أتنفس بلاهة الصمت وآكله في الرستاق واعتزلت جميع من حولي، وانهياراتي مكتومة الصوت وأنا الوحيدة التي أسمع صداها، فتجعل النوم والصحو مستحيلَين عليّ والساعات الداخلية بين قاعة التدريس وغرفة بدر تجري على نحو وحشي ومرعب ينزع إنسانيتي عنِّي، وقد بدت لي ذاتي فكرة شيطانية، تستثير تدمير كل من حولي لينفضوا عنِّي بعبث، رغم يقيني بأنه لا دخل لي في هذا، لكن أحسّ به شؤمًا يسكنني، يسري ويتغذى على هزيمة الآخرين، ورحيلهم عنِّي، ليُبقِي لي هواجس الاكتئاب والفقد الممتدّ كأنه خط سيري المقدر لي في الحياة وربي يقذفهم لي من السماء ككرات مطّاطية أنشغل باللعب واللهو بها وتتداخل التفاصيل، وتمتزج المشاعر حتى تلتغي تفاصيلي الخاصَّة ويظل لي توجُّس شيطاني بين مرور الوقت الداخلي لأحاسيسي المعلولة والوقت الخارجي لساعة الزمن التي تمر وتجري وتعدو كالذئب في طريق الحياة التي لا ولن تتوقف، لذا قررت الهروب والسفر بأي طريقة، فالمكان ليس له أي معنى دون من نعرفهم ونحبهم.
كنا في نهاية أغسطس، والجدران في غرفة بدر تنضح صهدًا، ومربع الشمس من النافذة مسلَّط على الأرض لا يتحول، وقد أرسل الحَرُّ لنا لفحات من نيرانه، استغرقت أيامًا طويلة وممتدة تشوي البلد دون تراجع، والشمس فوقي شديدة الوهج تكاد تحرق بشرتي، وتزيد أعصابي المنهارة اشتعالاً وعصبية.
هاتفت ابتسام أرجوها بعد سلام فاتر عن أحوالها، أنني أريد أن أسافر على وجه السرعة، وأنني لم أعد أحتمل العمل والإقامة في الرستاق، فردَّت بنبرات هادئة وباردة أثارت أعصابي، أن هذا لا ينفع في الوقت الحالي فلا أحد غيري في المعهد للتدريس، وأنني صديقتها المفضلة، ولا يصحّ أن أتخلَّى عنها فعلت حدة نزقي وغضبي، وقلت أصرخ فيها:
- اسمعي، أنا مش عايزة حد يحبني، أنا زهقت وعايزة أسافر، فاهمة؟ ما تقوليش حاجة عن الصداقة والحب، خلاص أنا كرهت نفسي، مش قادرة، عايزة أسافر، فاهمة؟
وأغلقت في وجهها السماعة وألقيت التليفون في حقيبتي بنرفزة، وسرت بخطوات حازمة، عازمة النية بعناد على السفر، لا أبالي بنظراتهن الغريبة لي وأنا أصوّب إليهن نظرات متعالية عليهن وعلى كل الأحداث التي مرت بي كأنني أحاول أن أثبت لنفسي كم أنا قوية، وغير مكترثة بشيء أو بأحد، حتى أستلقي على سرير بدر والغثيان يملؤني، أحملق إلى السقف، وأهمس لأنفاس بدر أن تأتي لتؤنسني، وأخاطبه كروح تماسّ مع روحي الممزق كأعضاء محمد المصري، وأصبحت غائبة عن جسدي مثل بدر، ويعتريني اليأس أن يرد علي فأعاود الحملقة إلى السقف ليخترق ندائي السماء التي بها ربي لأرجوه قائلة:
- ارحمني يا رب، ارحمني يا قلبي، فأنت وعدتني في حبهم صبرًا، فحاذر أن تضيق وتضجر.
رغم وقاحتي معها جاءت ابتسام سريعًا في إجازة الخميس تجر معها معلِّمة جديدة تُدعَى جيهان حضرت من أيام قليلة وطلبت مني بهدوء مفتعل أن أجمع أغراضي، وأعود معها إلى مسقط، حتى تتهيأ فرصة للسفر تحددها إدارة العمل والكفيل، كنت أدرك أنها تتعامل معي كطفلة مجنونة عليها أن تهدهدها، وتصغي إليها وتستجيب لمطالبها حتى تحتويها وتبدأ في تنفيذ ما تريده هي.
ذهبت إلى مسقط وأنا أثير الشفقة لكل من في المنزل الكبير، حتى نظيرة التي كنت أظنها نبعًا من التعاسة أمامي، صارت مشاعري تجاهها بيضاء، كبيوت مسقط البيضاء، ذلك البياض المتعكر، المفضي إلى العدم والموت البطيء وقد انتهت صحبتي معها ومع غيرها.
في هذا العالم الذي يتألف من امتدادات لا نهائية وألوان وأحزان لا حصر لها من الحكايات وقد تلاشت الآن، لتتحلل انفعالاتي في بركة ماء راكدة، جسدي يضمر كأنه يأكل بعضه بعضًا، وروحي تَكَسَّر وتَهَشَّم كزجاج بلُّوري إلى جزئيات حادة تدمي جراحًا طويلة الأمد، يستحيل استجماعها مرة أخرى في روحي الجديد وعهدي مع الحياة القادمة.
عدت إلى غرفتي القديمة في نفس المنزل الكئيب، بوجوه كلها جديدة بعد سفر القديمات بلا عودة لأسباب لا يعلمها إلاّ الله. ولم يتبقَّ غير أبلة فوزية كما هي على نفس السرير الذي كنا نتقاسمه، وقد تبدل حالها وأصبح لها شعبية كبيرة بين الأهالي، وتولت إدارة مدرسة تحفيظ القرآن صباحًا ومساءً كمديرة لها. ولم تعد إلى التدريس في مدرسة مسقط، وبفضلها عملت معها كنائبة مديرة وتركت التدريس أنا الأخرى، قابلتني بضحكتها المعهودة، لكن قلبي كان مُقفَلاً، وابتسمت ابتسامة مقتضبة، واحتضنتها حضنًا هزيلاً وهي تنهال عليّ قبلاتٍ وقد تهدج صوتها بالذكريات القديمة التي كانت بيننا حتى قالت ضاحكة مازحة:
- مالك يا بت خسيتي كده ليه؟! ولا يهمك، هترجع أيام زمان وأحلى منها إن شاء الله... وحشتيني، وحشتيني قوي يا فقرية.
أقنعت نفسي أنني فعلت كل ما يمكن فعله في نفسي بعد موت فاطمة البلوشية، لكن الحزن لم يمضِ بعيدًا، والأيام تمر مرورًا عبثيًّا ولاهيًا كأن شيئًا لم يكُن، إلاّ أن الأمر كان يمر عليّ بشق الأنفس، أدرك أن إحساسنا بالحب والهزيمة والنشوة والفرح يختلف من شخص إلى آخر، أقلهم الأكثر ارتباطًا وتأثُّرًا مثلي ومثل آخرين في الحياة لا يستطيعون أن ينسوا ويتداركوا الأمور سريعًا، ما يطلق عليها رفاهية في المشاعر وحساسية مفرطة، لكنه من المؤكد أيضًا أن وجوه الحياة كل الحياة لا تتشابه فيها دقتا قلب وبصمتا صوت وعاشقان مثل فاطمة البلوشية وأحمد، اللذين أدهشاني إلى درجة من الروعة والحسد العالي، لكنهما في النهاية استخدما حبهما لي كحجة حاسمة لقطع الخيوط لي مع استمرار حياتي التي توقعتها لنفسي، حتى تحولت إلى جحيم وأعصابي حطام بعد كل تلك الرحلات الأثيرية، واللقاءات العديدة مع كائنات متباينة أوهنت بطولتي على البقاء والاستمرار، وأريد بإصرار أن أهرب من المكان، فالمكان بالنسبة إلى أي إنسان خالدٌ وقاسٍ، يتدرب الإنسان على الحب والكراهية، والفراق الذي يحيله إلى مكان خالي المعنى وكئيب، والذكريات تطن في عقلي كطنين نحلات، تسقيني العسل المر حتى أهمس لنفسي بمسّ جفوني: حتى الموت ليس سهل المنال لك أيتها المسكينة، نعم، ليس بعد، وأنا أمتلئ بفكرة المغادرة عن عالم لم أفلح في العثور على الاستقرار به وقد رحل عنِّي الجميع لكن ظلاله تشوش رؤيتي ويقيني بأي أمر داخل مشاعري المحجوبة عن أعين الناظرين إليّ.
في ذلك المساء بالذات، انقبض قلبي، وطفق يقلب النظر في ما حوله شاردًا مقهورًا، وتكاسلت عن الذهاب دوام المساء مع أبلة فوزية، ومكثت بمفردي، فكلهن في العمل أو التنزُّه أو شراء احتياجاتهم الشخصية. سمعت طرقًا على الباب الخارجي، فتجاهلته محتارة، مَن سيطرق الباب الآن؟! حتى ازداد فذهبت غير مبالية أرتدي جلباب النوم وعارية الرأس، فربما إحداهن نسيت المفتاح، لكني فوجئت به يرشق إليّ نظرات قديمة ما زلت أتذكرها كلما تلاقت أعيننا، ظل للحظات مرتبكًا، لا يعرف من أين يبدأ الحوار، وخرجت الكلمات من حلقه مبحوحة:
- جئت لأراك وأطمئن عليك، فلم أعد أراك بعد أن عملت في المدرسة الأخرى.
قلت بجفاء:
- أشكرك يا وجدي، وماذا أيضًا؟
تردد لحظات وتنهد بعمق حتى أردف يقول:
- هل تسمحين لي بالدخول؟ يبدو أنه لا يوجد أحد، أريد أن أتحدث معك في موضوع خاصّ وهامّ...
وجدت نفسي دهِشة من طلبه، والتزمت الصمت للحظات، لكن الكلمات خرجت قوية من أعماقي حازمة كما أردت:
- لا لن أسمح لد بالدخول، هل جُننت؟ أنا بمفردي هنا.
فاتخذ وجهه لونًا آخر غير لونه، وشعر بالحرج والمرارة تغصّ في حلقه وهو يتظاهر بالجدية واللطف حتى يفرض هيبة مقنعة تستر أفعاله الدنيئة التي أعرفها جيدًا حتى اختفى صوته قليلاً في حلقه ثم خرج بغتة مندفعًا كالتيار:
- حريق هائل شبّ في مدينتك، فجئت أخبرك لأنك لا تقرئين الجرائد، وإذا فتحت التلفاز ستتأكدين وتعرفين التفاصيل، وتلك رسالة من أماني...
ومد يده يعطيني جريدة يبدو أنها مصرية، ورسالة، وقد هربت الكلمات التي امتلأت بها داخله، وكان ينوي قولها لي، وفر هاربًا كفأر مذعور من أمامي فورًا.
طالعت الجريدة وقلبي يخفق كأن بركانًا شبَّ فيه من الخوف والارتباك كما شبَّ الحريق المروِّع في قصر ثقافة مدينتي في أثناء عروضها المسرحية والغنائية في مهرجان ضخم. بحثت عن تليفوني الخاصّ حتى وجدته تحت الوسادة صامتًا، لكنه مضاء يهتز بذبذباته، يصرخ من عدة محاولات للاتصال، وكانت -كما توقعت- أمي، التي كنت سأهاتفها أول واحدة للاطمئنان عليها، ثم فعلت هذا مع بقية إخوتي وأسرتي وصديقاتي المقربات، أنتهي من مكالمة إلى أخرى حتى نفد رصيدي، ونسيت النوم والراحة وخرجت أشتري أكثر من كارت، حتى لا أُضطرّ إلى الخروج ثانية، وأثرثر على راحتي. هاتفتهم جميعًا وضعت الهاتف الذي كان صامتا استعدادا للنوم، أعدته إلى وضع عادي على الكومودينو وبجانبه رسالة أماني، وسقطت على السرير أحاول الاسترخاء حتى تهدأ دقات قلبي التي كادت تنفجر وهي تنتفض بقوة وتنبض من شدة الخوف وأنا أتساءل بتوتر وإنهاك:
- ماذا بتلك الرسالة؟ ومَن الآخرون الذين ماتوا؟
أفقت مذعورة على رنين تليفون متلاحق، وكان جسدي بكامله يتفصد عرقًا غزيرًا كقطنة مبلَّلة، وأنا بين نعاس ثقيل مضمَّخ بصداع أليم حتى التقطت الموبايل بصعوبة لأنصت:
- ازيّك يا فاطمة؟ عاملة إيه؟ وحشتيني، أنا اطمّنت على أمك، واخواتك كويسين ما فيش حاجة.
عرفت الصوت، إنها صديقتي نهى التي أحضرتني إلى هنا، وقد حضرت هنا من قبلي ثم تزوجت بمدرس وسافرت معه إلى السعودية، وانقلبت بعد عودتها إلى داعية وارتدت النقاب، وتمارس نشاطًا دينيًّا اجتماعيًّا تحث فيه الفتيات على ارتداء النقاب وحفظ الأدعية صباحًا ومساءً وذكر الله في كل الأوقات، وهداية البنات والسيدات إلى طريق التوبة والعودة إلى الله.
كنت قد أفقت بعض الشيء فقلت لها:
- ربنا يخليكي يا نهى. وانتي عاملة إيه؟ جيتي من السعودية؟
تجاهلت سؤالي واستطردت تتحدث عن شيء آخر:
- شُفتي اللي حصل لولاد الكلب الكفرة؟ ربنا بيعاقبهم على فجرهم...
قلت غير منتبهة لقصدها الحقيقي وأنا أقاوم الصداع الذي يدميني:
- اليهود؟ قصدك اليهود؟
فرنَّت ضحكة عالية هزَّت التليفون من جلجلتها وهي تتخلل أذني:
- يخرب عقلك يا فاطمة... طول عمرك دمك خفيف، والنبي عندك حق ما هم زي اليهود، ربنا شواهم في النار وبقوا زي العفاريت بيسرحوا بالليل في القصر اللي بقى زي الخرابة. ما انتي عارفة اني ساكنة جنب القصر المنيّل ده.. قال فنانين قال...
كلامها أصابني بالخرس للحظات، ومررت براحة يدي على جبيني المبتل حتى استوعبت كلامها الذي أغضبني فقلت مندفعة كموجة بحر هادرة طائشة:
- يا شيخة حرام عليكي، فنانين إيه وزفت إيه، هما مش ناس زينا وعندهم أسر وعيال؟ هو الدين اللي بتدعي له علّمك إن موت الناس والشماتة فيهم يبقى حلال؟ اتقي ربنا وبلاش شماتة حرام عليكي، دول مسلمين زينا...
وقاطعتني تردّ بتبرُّم:
- بس فيهم مسيحيين...
ولم أجد حلاًّ للردِّ عليها غير إبداء الوقاحة، فالبذاءة في أحيان كثيرة تكون المعنى الأوضح والمعبّر عن الموقف تمامًا ولا يصلح أي تهذيب في كل لغات العالم، فقلت لها وقد عاد عقلي بإفاقة بالغة:
- يا بنت الوسخة، الله يرحم الجيبة المفتوحة لحد ركبتك والمكياج والوقفة على النواصي مع البنات أصحابك، وشرب السجاير الفرط مع ولاد الجيران صبيان الحتة اللي كنتي بتقابليهم في المنور تحت بير سلم بيت أبوكي... فاكرة يا وسخة ولا خلاص عشان سافرتي واتجوزتي شيخ وبقى عندك فلوس، بقيتي انتي كمان شيخة وبتربي الناس؟ اقفلي السكة يا نهى، لأ، غوري من وشي خالص، أنا مش عايزة اعرفك تاني... انتي بت واطية وحقيرة... لا إله إلاّ الله بتشمتي في أذى الناس.
تثاقلت الهموم كجبل تسد أنفاس صدري، وطاش عقلي من هذا الصداع المزمن فقلت مرة أخيرة. لا بد من الهرب... لا بد من الفكاك حتى أنجو بجلدي من هذا الزخم المأساوي، الذي يحوطني خارج الوطن وداخله، ولكن عليّ أولا أن آخذ دشًّا باردًا... نعم، الآن.
كانت رسالة أماني لي تحية نابعة من القلب، تطالعني بها عن أخبار سعيدة وانزلاقها من أصعب موقف في حياة أي بنت تريد أن تكون عذراء في ليلة الدخلة، حتى تفوز بلقب الشرف والعفة والزواج الشرعي، وقد دبرت أمورها مع إحدى صديقاتها، وتمت الليلة الموعودة بسلام، وحامل في شهرها الثالث، وتعيش حياة مستقرة وآمنة وقطعت كل حبال الماضي القديم، وبدلت رقم هاتفها وأنها لولا مساعدتي لها ما كانت لها تلك الحياة، وهي تدين لي بالشكر، وتطمح إلى صداقة وود كلما سمحت الظروف بالزيارة أو الاتصال، تاركة لي رقم التليفون والعنوان، وترجو الاتصال قريبًا. ترددت ماذا أفعل بتلك الرسالة، ربما لو كانت أرسلتها في وقت سابق كنت سأنفجر من السعادة والفرحة لأمرها، لكنني في الوقت الحاضر روحي بعيد تمامًا عن أي مثالية أو تعاطف أو مشاركة أحد فرحه أو حزنه، فأرجأته بعيدًا في حقيبة خاصَّة بها قفل مع دفتر يومياتي "مذكرات العباقرة"، حتى أرى ماذا سأفعل به.
وانتهى عام 2005 بكارثة موت فاطمة البلوشية، وحريق قصر ثقافة بنى سويف الهائل في مدينتي الصغيرة.
مرت الأيام دون أن أجد حلاًّ، وابتسام تحاول المراوغة والهروب مني حتى أستسلم للبقاء، والتخلِّي عن فكرة السفر. الحق أنني حاولت النسيان والبقاء، لكني لم أستطع، كنت أشعر بنفس ثقيلة، ولم تعد اجتماعات الأماسي مع أبلة فوزية وصديقاتها الجديدات العمانيات اللاتي أصبحن كثيرات تثير فيّ أيّ بهجة رغم حُنُوِّها وعطفها البالغ كأني طفلتها، لا ترفض لي طلبًا، وتحضر لي ما لذ وطاب وتدفعني للخروج والتمشِّي والحديث، وكنت أقابل كل هذا بالصمت، وتجهم وابتسامات كأن فكَّي فمي أصابهما عجز يمنعهما عن الانفراج الطبيعي والابتسامة الوافرة.
تشابه الأيام جعل الذكريات كتنويعة على رأس مُحبَط يريد الهروب إلى أقصى حدّ، لذا أصررت على مقابلة ابتسام بعد انتقالها إلى منزل آخر تعده وتجهزه لاستقبال زوج المستقبل، حيث سيتم زفافها في إجازة منتصف العام، فذهبت إليها في فترة الراحة بين الدوامَين الصباحي والمسائي في عز الظهيرة، طلبت من سائق الباص أن يذهب بي إليها، طرقت الباب ولم أسمع ردًّا، فوقفت بجانب الباب ساكنة والشمس ترسل أشعتها اللافحة، فتضايقت من وطأة الحرارة على رأسي، لكنني انتظرت لأكثر من ثلث ساعة، حتى توقف سائق تاكسي ونزلت منه ابتسام وهي تأمره أن يحضر الساعة السادسة مرة أخرى. بمجرد أن رأتني تهللت تقول بفرح:
- تصدقي انتي بنت حلال! كنت هاتصل بيكي النهارده، لكن انتي سبقتيني وجيتي.
تجاهلت ترحيبها وقلت بحسم:
- أنا عايزة أتكلم معاكي في موضوع يا ابتسام.
ربتت على كتفي بحنو:
- وماله يا حبيبتي؟ تعالي أنا عازماكي على هاريس اللي بتحبيه في مطعم عمر أمك ولا أهلك كلهم ما دخلوه.
ولأنني أعرف أنها تمازحني لتستقي مدى الود والتباسط الذي بيننا فقد قلت بشيء من الضيق:
- وإيه اللي جاب سيرة أمي دلوقتي يا ابتسام؟
- ولا يهمك يا قمر بلاش أمك خليها أهلك بس.
استقللنا تاكسيًا إلى مطعم مدخله فاخر وأنيق ويشبه البيوتات الخشبية الصغيرة كل حجرة خشبية مكيفة وبها حمام وترابيزة طعام يقابلها أريكة وثيرة وعريضة على النمط الأمريكي وطاولة نحاسية مستديرة عليها إبريق قهوة عربي بكؤوسه الفضية المزخرفة للراحة والاسترخاء لشرب النارجيلة.
ويبدو أنها تعتاد الحضور إلى هذا المطعم بالذات، فما إن رآها الهندي رحب بها بشدة وقادها إلى حجرتها التي دائمًا ما تختارها إذا كانت فارغة، ظلت تتحرك بانبساط حتى إنها رحّبَت بي مرة أخرى وهي تخلع العباءة وتفكّ دبوس طرحتها لينسدل شعرها على ذراعيها أسود جميلاً لامعًا ينساب كليل عميق، واستطردت تقول كمن تذكر شيئًا هامًّا وهي تحتضنني:
- ياه! وحشتيني قوي يا فاطمة... كل دا يا جبانة ولا حتى اتصال؟!
تناولنا طعاما شهيًّا وجلسنا على الأريكة، تشرب هي الشيشة التي أحضرها لها الهندي بعد الغداء، وأخذت تنفث الدخان بتلذُّذ وأنا مشدوهة أنظر إليها باستغراب حتى خرج الكلام عفويًّا:
- من إمتى يا اختي بتشربي شيشة؟
- دي شيشة تفاح، معظم العمانيات بيشربوها، وفيه كل أنواع الفاكهة... أجيب لك واحدة؟ والنبي مش أحسن من السجاير؟
تجاهلت رأيها عن الشيشة والأفضل، وأحست بحاجتي إلى الحديث، وبنبرة ذكية ولَمَّاحة قالت على الفور:
- إنتي عايزة تسافري ليه يا فاطمة؟ ليكي إيه في مصر؟ أنا كمان مش هارجع مصر، هاتجوز هاني وأجيبه هنا يشتغل معانا، ما انتي عارفة انه مدرس زيك. هتحبيه قوي يا فاطمة، زيك بالظبط طيب ومخلص وبيحب الشغل زيك، وفوق دا كله بيموت في التراب اللي بامشي عليه.. ما أنا قلت لك قبل كده انه كان بيحبني من أيام ثانوي، بس أنا اللي كنت مش واخدة بالي.
أطرقت رأسي ناظرة إلى أرضية الحجرة اللامعة من شدة النظافة، واستأنفت هي كطبيب تناول مشرطًا ليفتح جرحًا غائرًا وأخذ يعبث فيه قائلة بقوة وحماس المغتاظ:
- كل ده علشان صاحبتك ماتت وأحمد ما حبكيش وسيف مشي وعبد العزيز سافر؟ كنتي بتحبيها قوي؟ ليه؟ هي فيها إيه أحسن مني؟ واحنا من بلد واحدة، إيه فاطمة؟ فيها سكر وأنا كخة؟!
اشتعل رأسي، وكادت الدموع تطفر من عيني وأمسكت أعصابي حتى لا تخذلني وتسقط وهي لا تكف، ثم قالت:
- انتي مالكيش ذنب في موتها يا فاطمة... دا قدر، انتي مش مؤمنة ولا إيه؟
وأخيرًا انسابت دموعي غزيرة، فأمسكَت بيدي واحتضنتني وشعرها الأسود الجميل يلفح أنفاسي بشهيق البكاء الذي هز جسدي كله، وغصت في حُمَّى الألم وهي تطبطب بباطن راحتَي يديها على ظهري حتى أهدأ وتتفوه بحديث الأحلام وترمي لي بطوق النجاة وهي تقول:
- تعرفي؟ لما ييجي هاني هنعيش مع بعض، عارفة ازاي؟ هاني ليه أخ اسمه صلاح مراته ماتت وعنده عيلين، إيه رأيك؟ أرمل وعنده العيال اللي ربنا حرمك منهم، هتكوني عليهم أحنّ من أمهم اللي ماتت.. أنا عارفة كده.
وانتزعتني من حضنها كمن يخرج من الجنة بغتة، وأمسكت بذراعيها كتفي:
- أنا عندي ليكي مفاجأة.. الكفيل هيفتح مدرسة جديدة في بركة وأنا هاكون المديرة وانتي الناظرة وهاني هيشتغل معانا... أنا خلاص زهقت من مسقط، والمعلِّمات اللي هنا.. هنروح مكان جديد مع بعض يا فاطمة.
استندت بظهري إلى الأريكة، وقد تباعدت كل الأحلام عنها وعني وقد جفت دموعي وناولتني مناديل ورقية لأتمخط وأبتلع لعاب فمي بدموع ولَّت، وقلت بكل هدوء وحسرة وعيناي ذابلتان من غزارة الدموع، وجسدي خامد ورخو بفعل الطعام الكثير وحديث ابتسام حتى قلت:
- أنا هاقضي معاكي رمضان لأنه قريب، وهاسافر بعد العيد، صرَّفي أمورك وهاتي بديل ليا في أقرب وقت.
واستأنفت أقول كأني أخاطب نفسي:
- عارفة اني طيبة وغبية وحمارة في نفس الوقت، بس مش هاقدر يا ابتسام، أنا فعلاً تعبانة وعايزة ارتاح، وراحتي في السفر، أمي هي أولى بيا دلوقتي.
جاء شهر رمضان بطقوسه المعتادة في كل البلاد العربية، العمل القليل، طهى أشهى المأكولات، الكسل والتراخي والنوم كثيرًا حتى يؤذن المغرب وتنحل ذمة البطون. اتفقت المعلِّمات أن يأكلن جميعًا معًا وأن تكون أبلة فوزية المسؤولة عن الطهي مع اختيار معلِّمة كل يوم لمساعدتها، ويكون مكان الالتقاء هو الصالة، يفرشن العديد من الجرائد ويتجمعن في شبه دائرة لتناول الإفطار، فالطعام هو أقوى لغة في قاموس الحياة المصرية في الأفراح والمآتم يأكلون، لكنني أحسست بسطحية تلك المشاعر القومية ومللت نظرات الشفقة التي يحدجون بها إليّ من بؤس حالي، وروحي هائم بالضياع. وعزمت على خوض تجرِبة لأول مرة في حياتي هي الاعتكاف في الجامع بعد الذهاب إلى العمل الصباحي الذي اكتفيت به، ولم أذهب إلى المساء. بعد العمل أتجه إلى الجامع ومعي غيار داخلي وعباءة سوداء ولحاف أسود أيضًا وأظل بعد قراءة القرآن والتسابيح حتى يؤذن الإمام للصلاة بعد أن يقرأ ما لا يقلّ عن جزأين من القرآن مع الصلاة المستمرة لأكثر من اثنتَي عشرة ركعة حتى الساعة الثانية عشرة ثم يكون التهجد إلى موعد السحور فيتوقف الشيخ لتناول السحور وراحة للاستعداد لصلاة الفجر حاضرًا، ثم أنتظر شروق الشمس لصلاة الضحى وأتأهب للذهاب إلى العمل، وهكذا دواليك، وأحسّ نفسي مملوءة بخشوع غامر يتلبس كل الدنيا مع صوت الشيخ العذب الندي، وعندما أشعر بالتعب من القيام والقعود أتكئ على الجدار أو أنام باسترخاء وقد حل بجسدي خدر يشبه ذلك الذي يشعر به الإنسان بعد رحلة طويلة، وفوهة تساؤلاتي الوجودية تتأمل وتسأل عن ذلك الكائن البشري المتحرك واللاهث تحت كل سماء وفوق كل أرض حول معنى حياتنا ووجودنا. يا إلهي! ما هذا الإنسان؟! كيف خُلق؟ ولماذا؟ وما معنى حياته؟ وما غايتها؟ بالخير والشر؟ ما مصدر الآلام وما غايتها؟ ما الطريق الذي يقود إلى السعادة، يشتد بي أنين موجع مكتوم بدموع مدرارة صامتة وأخيرًا الموت؟ لماذا يا ربي؟ لماذا ماتت فاطمة البلوشية ولما لم أكن أنا؟ لقد كانت تنتظر فستان زفافها، بينما أنا لا ينتظرني أحد! ما السر المطلق المتعالي عن كل مشاعر البشر، حتى يتعذر وصفه ويحيط بوجودنا من كل جانب، الذي منه نستمد أصل وجودنا وإليه تصير ونصير إلى رب السماوات السبع والأرض والبحار والأنهار والمحيطات، وكل الكائنات الحية؟ كم أشتاق إلى تلك المسيرة ليخبرني ما الموت، وما مصير الإنسان بعد الموت! هل هناك حساب وجزاء؟ وكيف ذلك؟ كيف؟! رفعت رأسي محدقة النظر إلى بهو الجامع المزخرف زخرفات إسلامية بديعة بأنواره الباهرة والساطعة سطوعًا ناعمًا ودافئًا إلى مشاعري الآن بين شعور لانهائي، وأبدي يمشيان معًا وأنا أبحث عن ذلك الكائن البشري المتسائل عن زمن لا ينتهي ولا يمر أبدا ليصبح الكون غير محدد، له حاضر واسع المدى، لا يدرك لغة الموت الذي ترقد معه كل أسرار الحياة والتأمل في كل اللقاءات لي مع الآخرين حتى تحولت إلى رباط من الحب والرغبة والفراق والغضب لم يجنِ لي إلاّ التعاسة والشك في مكنون الراحة والرضا، لكن يبدو أن وضعي سيِّئ مع عالم الأحياء الآن.
انتهى رمضان وجاء العيد الصغير وعدت إلى العمل صباحًا ومساءً مع أبلة فوزية، وانتظرت أي رد أو أخبار عن سفري ولا يأتيني شيء وابتسام مشغولة تمامًا بالتجهيز لعرسها في نصف العام، ففعلت ما لا بد منه، وانقطعت عن الذهاب إلى العمل، مهما حاولن إقناعي، ومكثت في السكن حتى كان لي ما أريد، وإن حدث بعد فترة من الوقت.
فاجأنا الكفيل بدعوته إيانا جميعًا لقضاء العيد الكبير في مزرعته في الرستاق لرؤية الذبائح والتضحية وتناول الشواء اللذيذ، والأرز المحشو بالصنوبر واللوز والجوز، كما فاجأني إعدام صدام حسين في صباح ليلة العيد، بفتح جوّال أي أحد ليريك مشهد إعدامه الذي يتراسلونه على الهواتف وهم يشعرون بالشفقة والتعجب والصمت، فشعرت بسخافة الأحزان وحقارة الأفكار وأنا أنظر إلى المشهد القاتل حزينة لاهثة.
وبعد يومين من عودتنا إلى مسقط، تسلمت كل أوراقي وتذكرة السفر من أبلة فوزية، وقد خاصمتني ابتسام لعنادي وتجاهلي مشاعرها ولم تأتِ حتى لتوديعي، كنت الوحيدة التي تسافر في هذا الموعد الغريب، فلا هو نصف العام ولا نهاية العام.
وأنا أرتب حقائبي عمَّني سلام عميق، وأخيرًا أحسست أن كل المشاعر السلبية خرجت إلى السطح، مشاعر ظلت مختبئة لليالٍ طويلة داخل روحي دون وعي منِّي، فشعرت الآن أنها لم تعد لها ضرورة وقد غادرتني، كما غادرتني البيوت البيضاء وأنا أرى عينيها السوداوين، وشعرها الأسود ووجهها الطفولي الخمري بثغره الباسم وجمالها الوضاء، خمسة وعشرون عامًا فقط، قضيت معها نحو سنتين فقط وفارقتني إلى الأبد. آه يا فاطمة البلوشية! كم سأشتاق إليك! بل آه يا فاطمتين! كم سنوات وسنوات تستمرّ لتسقيني الألم العظيم على فراقكما، وقد اندمجت اليقظة في السحر، وأصبحت الحكاية مع حلول السفر هي الواقع الذي تحول إلى عبث عقيم يملأ المكان بذكريات حياة لم تعُد حياتي وقد انقطعت الحكاية، وسيحلّ غد جديد في وطن آخر، لأواصل أعجوبة التحليق إلى عوالم سحرية أخرى مختلفة تمامًا عما كان وصار وأمسى زائلاً، كل ما أتلهف عليه الآن هو شيء واحد، الرحيل لأعود إلى حضن منزل أمي القديم وأنام نومًا عميقًا دون صراع ولا تقلب في الفراش، مختنقة وجوعانة إلى معرفة الحقيقة، ولن أشكو من الفراغ الكئيب الذي كان يجثم على صدري وينتشر في رأسي الدقيق ويهزّ توازني، ويجمِّد مشاعري كالصنم، ولكن هل سيتحقق هذا في الوطن الأم، أم أنه بداية لضياع واغتراب آخر أكبر وأوسع مدًى...؟ لا أعرف...
التقطت رسالة أماني من مذكراتي، التي هجرتها من وقت طويل، فكدت أمزقها، لكنني آثرت الاحتفاظ بأوراق وكلمات الماضي، واكتفيت بتمزيق رسالة أماني وقلت لنفسي في أثناء تمزيقي الرسالة:
-أنا أيضًا جزء من ماضيها الأسود، وعليها أن تنساه، وتسير في حياتها دون منغِّصات.
دوَّنت برغبة ملحَّة في مذكراتي تاريخ عيد الأضحى الذي زامن إعدام صدام حسين 3/12/2006 الموافق السبت، حتى لا يتسلل إليه النسيان والصدأ في أثناء عبوري الطريق، لكني اكتشفت أن هذا يحتاج إلى قلم غير كل الأقلام، لذا عليّ عندما أريد أن أكتب أن آخذ قلمي المعدني إلى أكثر السَّنَّانين قوة وأذهب به إلى أكثر الحدَّادين نارية... حيث يقوم قلمي على آلته النارية الشرارية حتى يصبح أكثر بريقًا... أكثر تعبيرًا... عندما أريد أن أكتب إن ذلك يجهدني قليلاً.
لكني بعد هذا أستطيع أن أجلس لأكتب... هناك على قمم الجبال الصنمية العالية... حيث يصبح العالم بعيدًا... صغيرًا.
أضع الورقة أمامي مباشرة، وأستلّ قلمي كما لو أني أستلُّ خنجرًا أقربه من الورقة البيضاء جدًّا... فترتعش راغبة في ملامسته، تشتد رغبتي، فأرتجف، إذ يثير ذاك قلمي كثيرًا... يلمسها، يفضّ... بكارتها في الحال، أنظر إلى قلمي البراق، فأراه محتضنًا الورقة، والدماء تملأ المكان... يرتجف عقلي... وأغمض عيني بسرعة.
لذا دعونا نسمح لفاطمة البلوشية، وفاطمة عبد الناصر، أن تغادرا هذا المكان إلى الأبد، ونذهب إلى القصة الأولى التي بدأت الحكي عنها وكانت مُلهِمًا لشهوة القلم... هل تتذكرونها؟ إنها صديقتي السرية المفضلة التي عليّ أن أسرع بالذهاب إليها وقد هاتفتني بعد خروجها من السجن، فهي تشكو تروجان (طروادة) يهاجمها وهي جالسة على الكمبيوتر، وقد أحضرت لها المجلة لنرى كيف سأقتل التروجان وأشاهد أفلامي المفضلة مع صديقتي السرية المفضلة.
التعليق
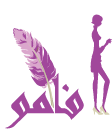

 من نحن
من نحن أشواك الورد
أشواك الورد قصاصات.كوم
قصاصات.كوم متابعات
متابعات فضاء للبوح
فضاء للبوح سرديات
سرديات قصائد
قصائد آراء حرة
آراء حرة في المرآة
في المرآة الأسوأ
الأسوأ دليل فامو
دليل فامو Boutique FaMoh
Boutique FaMoh Café FaMoh
Café FaMoh إتصل بنا
إتصل بنا