سرديات عودة
مقطع من رواية "غرفة الذكريات" للكاتب الجزائري بشير مفتي (الخميس 6 ت2 2014)
التعليق
كثيرًا ما خلقت فيّ الخمارة هذا الشعور الغريب بالانتماء إلى ناس مختلفين، ناس لا يربطهم بالحياة إلا خيط واهن كخيوط بيت العنكبوت، خيط سحري يجعلهم عبر الحانة يستعيدون أوهامهم الجميلة عن أنفسهم، ويسقطون عنهم الأوهام السوداء لغيرهم.
الحياة هي كما قال لي جمال كافي:
"نسيان كامل للحياة".
صرت مع الوقت أحس أنني أنتمي إلى هذه الفئة التي لا تحب أن تصحو أبدًا، أو كأنها ترغب في نسيان العالم والعيش في لحظة بين الحياة والموت.
هل هي رغبة هروب مضمرة تفصح عن نفسها بهذا الشكل؟ شعور لا تفسير له بالكآبة التي يحبها الشعراء؛ لأنها تسقي أرواحهم الميتة بنور الشعر وأكاليل الكلمات الساحرة. نوع من العدمية التي لا يتقبلها الذين يؤمنون بإيجابية الحياة، وبالمستقبل الخير للبشرية.
لم أكن لا عمر خيام أو أبا نواس جزائري جديد، حتى أعطي لتلك الحانات والشرب الصورة التي تعبر عنهما بفتنة وشاعرية مدهشة، أو أملك القدرة على أن أستخرج من ذلك الكأس الشهي كل ما فيه من روح جبارة، تأسر وتسلب كل من يقترب منها.
كنت ذلك الشاب الذي يبحث في تلك الفوضى القادمة عن طريقه، وهو يشعر أنه مظلم من البداية.
تركت الكونتوار عندما فرغت طاولة، فسارعت للفوز بها، ورحت أعد النقود التي في محفظتي فوجدتها ستسعفني لشرب ثلاث بيرات أخريات، وأكل سندويتش بطاطا مع بيض مقلي، وشراء تذكرة حافلة للبيت.
كنت أكره عندما أشرب أن أعود إلى البيت. لو كانت عندي نقود كافية لاستأجرت غرفة في فندق حقير بحيّ طنجة خلف شارع العربي بن مهيدي، أو "لا رُوديزلي" كما بقينا ننطقه بالفرنسية، حيث تكتظ الفنادق الرخيصة مع مطاعم السردين المشوي والمقلي واللوبيا والحمص، والكسكس بالزبيب واللبن، وغيرها من المأكولات الشعبية التي تصلك روائحها وأنت تقترب من ذلك الحيّ الشعبي، فتشعرك بالجوع والرغبة في الأكل السريع.
لو كانت عندي بعض النقود الكافية لذهبت لذلك الفندق الذي اسمه "رِيجينيا" ونمت فيه حتى الصباح. لقد فعلتها مرتين، وكانت نومة معتبرة بعد سهرة شرب فاتنة ومدوخة. وهكذا لن أشعر أنني أرتكب جريمة في حق عائلتي التي تظنني أعقل أبنائها، أو لا تعتقدني أبدًا أشرب الخمر، وأمارس الموبقات التي حرمتها السماء، ولا يضطرني أي أحد منهم لممارسة النفاق الذي أمقته، وإن كنت ألجأ إليه فتلك هي حقيقة الوضع الاجتماعي المعقد الذي أعيش فيه، فلا مناص من الكذب، ولا مناص من عدم قول الحقيقة.
منذ أن دخلت الجامعة شعرت أنني انفصلت ذهنيًّا وروحيًّا عن عائلتي، ولم يعد يربطني بهم إلا مشاعري، وذلك الفضاء الذي يجمعني بهم صباح مساء.
كان سبب الانفصال الذهني أنني لم أعد أستطيع محاورتهم في أي شيء، فهم لا يقرؤون وأنا أقرأ كثيرًا، وكانوا لا يفهمون ماذا أقرأ، ويخافون عليّ مما أقرأ، وكانوا يرون قراءاتي كلها ضدهم بالدرجة الأولى، وضد الدين بالدرجة الثانية.
أذكر تلك السنة التي بدأت أطالع فيها بجدية وشغف، أو ذلك اليوم الذي استعرت فيه رواية من المكتبة العامة لبلدية الجزائر الوسطى، والتي كانت تقع تحت مبنى رئاسة الحكومة. كانت واسعة وجميلة، وكنت كلما مررت بها أشعرتني بالرهبة والذهول. كانت تلك الرواية هي "الجلد المسحور" لبلزاك، وغرقت معها كما يغرق عاشق في ملذات عشقه دون أن ينتبه لأي شيء آخر من حوله. نسيت الوقت والمكان وكل شيء، وظننت نفسي انتقلت بخيالي إلى ذلك الزمن الباريسي العتيق، بكل ما فيه من سهر ومرح ومغامرات جذابة آسرة لخيال طفل تتكشف له صورة أخرى من الحياة.
كان عمري اثنتي عشرة سنة، ووجدت صعوبة في ترك تلك الرواية من يدي حتى أنهيتها، ثم أعدت قراءتها مرة ثانية وثالثة حتى كدت أحفظها عن ظهر قلب.
في البداية شعر الجميع بالدهشة وهم يشاهدون هذا السلوك الغريب يصدر مني، ثم تحولت دهشتهم إلى فرح واعتزاز بهذا الابن الذي يفضل القراءة على اللعب، (لأنني قبلها كنت أحب اللعب في الشارع على أي شيء آخر). ثم إلى استفهام وأسئلة من نوع: ولكن ماذا يقرأ؟ وهل هي كتب مفيدة؟ أليس الأحسن لك أن تقرأ كتبك المدرسية، التي تجعلك تنجح وتتقدم في الدراسة؟ لكنني صحيح لم أكن أعشق قراءتها، فلقد كانت تبدو لي أقل من مستواي الحقيقي.
ثم صار الأمر مخيفًا لهم ومثيرًا لكل أنواع الشكوك والريبة، عندما لم أعد أذهب إلى الصلاة في المسجد على غرار جميع إخوتي. لقد كانت الصلاة شبه مفروضة بالبيت، أو كأننا لا نستطيع أن ننسجم في بيتنا إن لم نكن نصلي جميعنا.
والحق أنني كنت أحب الصلاة إلى غاية تلك السنة التي بدأت فيها المطالعة. ربما الأمر يبدو غريبًا بعض الشيء، أو هكذا يمكن أن يتساءل أي شخص يؤدي الصلاة بشكل عادي، لكن بالنسبة لي كان الأمر على قدر كبير من البساطة..
شعرت أنني عندما كنت أذهب معهم إلى المسجد وأصلي، كنت فقط أقلد أبي وإخوتي وأخواتي؛ ذلك أنني كنت عندما أراهم يصلون أحب أن أكون مثلهم، جزءًا من تلك الروح التي تجمعهم بالخالق والسماء. لم أكن أرغب أن أكون مختلفًا أو نشازًا عن محيطي الذي أعيش فيه، ثم كانت الصلاة تعني لي أن يُكبروني في عيونهم، أن ينظروا لي على أنني فرد كامل مثلما هم أفراد كاملون في نظري.
لكن لأقل الحقيقة لم تلمسني قط أشعة السماء السعيدة، ولم يهتز قلبي لشيء خارق، ولم أشعر أنني في صلاتي كنت أخشع بحق كما يقولون هم عن الشعور الذي يسكنهم أثناء تأدية العبادة. كنت صغيرًا ولهذا لم أطرح أسئلة كثيرة، ولكن كنت أحس عميقًا بداخلي أنني لا أحس بشيء مما يحسون، وأنني فقط أقوم بدوري كما يقومون به أمامي، وأن هذه الصلاة لم يكن لها من غاية غير أن توحدنا مع بعض ومع الخالق الذي في السماء، وتجعلنا لأسباب أو لأخرى ننتمي إلى فئة معينة، أو ثقافة محددة، ولكن أن أحس أن يكون في تلك الصلاة خيط يربطني بالأعلى، فهذا لم أجده أو أشعر به. وكنت أتصور الله في تلك السن مثل أي شخص طيب في هذا الكون، وهو يسكن في مكان بعيد لا نستطيع أن نصل إليه، وأنه الوحيد الذي يستطيع أن يصل إلينا جميعنا.
ثم عندما بدأت أطالع الروايات ظهرت لي تلك المتعة الخالصة التي لم أشعر بها في الصلاة، أي ذلك الإحساس النادر والعميق أن سحرًا يتغلغل في مسامات روحي، ويشدني بقوة إليه، ويأسرني من كل جوانحي. حتى إنني تساءلت داخليًّا: لماذا الصلاة لا تشعرني بذلك؟ وفكرت أنه ربما عندما أكبر سأحس بهذا السحر مثلما يحس به الكبار حتمًا، وإلا فما فائدة حركاتهم الآلية الروتينية تلك؟
انقطعت عن الصلاة فجأة، فبدا الأمر للعائلة كلها مثيرًا للاستغراب، وأحسوا أن لتلك الكتب التي أقرأها تأثيرًا سيئًا عليّ، أو هي بشكل ما تجعلني أنحرف عن الطريق المستقيم.
كان لسان حالهم: "كل شيء إلا الانحراف عن الطريق المستقيم".
----------------------------------------------------------------
"غرفة الذكريات" رواية جديدة للروائي الجزائري بشير مفتي، صدرت عن منشورات "ضفاف" و"الاختلاف"
التعليق
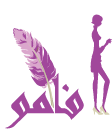

 من نحن
من نحن أشواك الورد
أشواك الورد قصاصات.كوم
قصاصات.كوم متابعات
متابعات فضاء للبوح
فضاء للبوح سرديات
سرديات قصائد
قصائد آراء حرة
آراء حرة في المرآة
في المرآة الأسوأ
الأسوأ دليل فامو
دليل فامو Boutique FaMoh
Boutique FaMoh Café FaMoh
Café FaMoh إتصل بنا
إتصل بنا