سرديات عودة
فصل من رواية : أسياد بلا جياد للروائي مصطفى سعيد (الإثنين 29 أيلول 2014)
دغدغ وجنتي انبثاقُ الشمس الخجولة تخفي نفسَها خلفَ الغيوم تارةً, وتظهرُ في كبدِ السماءِ الشاحبةِ تارةً أخرى, كأنّ شيئاً لم يكنْ, ينكبُّ شعاعُها الخافتُ مثل آمالنا, من ستارةِ بيتنا القديمة, مزركشة بألوان غير متجانسة، كأحلامي تلك الليلة.كابرت على نفسها, لتكسو النافذة ككسوة عروسٍ ثكلى بثياب سوداءَ بالية, قلبُها حزينٌ, لكنْ, مَنْ يرَها يحسبْ تطايرَها معَ هباتِ النسيم مِنْ هول فرحها.
فتحتُ عيني وأنا أخدعُ نفسي, بأنّ النومَ لا يزالُ يطرحُ جسدي, وسواسٌ ثائرٌ ينتابني من ملائكة الحنين كأني بحاجةٍ إلى نومٍ سرمديّ, لا أستيقظ منه إلا فوقَ ترابِ قريتي. نبضاتُ قلبي تلعنني, تدقُّ في شغفٍ كقرع طبول قبائل سوبارتو, حزينةً لا تريدُ تركَ جثتي التي رافقتها عدداً من السنين, لتزيدَ من خفقانها وترسمَ ألوانَ لومِها لعدم يقظتي وطردِ الضيف الثقيل عني.
بينَ حيرتي ولوعتي, قررتُ أنْ أكونَ رسولَ خيرٍ بينها وأظلّ ممدداً في فراشي الملطخ بأحرفٍ متناثرةٍ مبلولةٍ بماء الأسى, علني أرضي في أسوأ احتمالٍ حواسي.
أطلقتُ العنانَ لناظري, تأملتُ الغرفة الحزينة التي لم أعهدِ الاستيقاظَ فيها, أصبحتُ أرتادُها وأنامُ فيها قبلَ رحيلي, لأختصرَ رحلتي عندَ احتضاري, لأنَ الجثمانَ يُوضعُ في أكبر غرفِ البيتِ عندَ النحيب عليه, أملاً في أنْ أجدَ نفسي مقتاداً لقريتي, جثةً هامدة, كهلاً, عاجزاً, شجرةً, صخرةً, لا فرقَ عندي, المهمُّ أنْ أكونَ في مهدي ولحدي.. وأنْ أدفنَ بينَ عظام أجدادي.
تسلل طيفُ جَدي إلى ساحةِ نزالٍ بينَ أفكاري و ذكرياتي.. بعدَ نصرة الذكرى سبقتها دمعةٌ صامتة خرجتْ من طرفِ جفني, شقتْ طريقها إلى ما وراء أذني، كأسيرة كانتْ ولم تصدقْ أنه فُكّ أسرُها بهذه السهولةِ والرجولة, فالأسيرُ بجسدِه يأتي يومٌ, تُعطى له مفاتيحُ أغلالهِ ويساقُ لِمَنْ يبت بحالهِ, أمّا أسيرُ الروحِ مثلي فيظلُّ مكبلاً إلى أنْ يشرقَ نورُ الحريةِ القريبةِ البعيدة. حتى تقاسيمُ وجهي استغربتْ قدومَ طيفِ تلك الدموع السابحة والهاربةِ من شبح السّفر. فبحسب العاداتِ الشرقيةِ البائسة, فإنّ الدموعَ لا تذرفُ من الرجال، صنعتْ لتذرفها النساءُ على الرجال.
تذكرته عندما كانَ يبحثُ بينَ حباتِ العنبِ التي أكلتْ منها الطيورُ وأحدثتْ فجوةً فيها وتمايلتْ لذبولها, كانَ يبحثُ عن تلك الحباتِ, يلتقطها, يأكلها بنهم ٍ,كأنّ أحداً سوف ينتزعُها منه, ويقطف لأحفادِه أشجعَ وأكبرَ عنقودٍ في القرية, قد فاحتْ بعضٌ من صفاتِه, كما تفوحُ رائحة النعجة المختنقة, إنّ البخلَ من خصالِهِ, يحرسُ الكرمَ من شدّةِ حرصِهِ, لكنْ ما أذكرُه أنه لم يبعْ في يومٍ من الأيام حبةَ عنبٍ لأحدٍ, بل كانَ كثيرَ السخاءِ معَ الكلِّ بغيرِ حدود.
أشعلتْ فيّ لهيباً تلك الحادثةُ التي جرتْ عندما أقبلَ على داليةٍ كانتْ قد هُشمتْ وتناثرتْ عناقيدُ العنب على طولِ الطريق وعرضِهِ, ينظرُ إليها بحزنٍ معَ عقدةِ التبرّم في خارطةِ وجههِ, ويقولُ: وهل طلبَ مني أحدُهم يوماً ما اشتهتْ نفسُه أنْ تقطفَ وتأكلَ, أو يأخذَ منها ما يطيبُ له ومُنعتْ عنه؟ إنّ كرمَ العنبِ يكفي القرية والقرى الباقية ويفيضُ, لكنّ ما يحزُّ في نفسي السرقةُ في الجهر لينالوا مبتغاهم دونَ ذرفِ قطرةِ عرقٍ. أدركتُ بعدئذٍ أنّ جَدي سريالي, فيلسوف من المدرسة الفطرية,يبحثُ عن اليقين في أصغر الأشياء, يريدُ أنْ يعبرَ عن آرائِه بقدر ما يستطيعُ, لو عاشَ لعلِمَ أنه أخطأ عندَما ظنَّ أننا سنبقى على تلك البركة, ليتنا بقينا, وويحنا إنْ لمْ نعدْ ونبقَى.
كانَ -رحمه الله - يملكُ ما فقدناه نحن: القناعة, العطاءَ في محلهِ ومكانهِ. بساطته غلبتْ عليه, لم يكنْ يدري أننا نعيشُ وسط أناسٍ حسب المقولة: مثل الديوك تعتقدُ بأنّ الشمسَ لم تشرقْ إلا لتسمعَ صياحَها, ونحن مَنْ أصابتنا الرجفة من صياح الديك, بعدَما كنا نصطادُ الذئابَ بأيدينا ونقتلعُ رأسَ الأفعى بأسناننا. تحولَ الصياحُ بين ليلةٍ وضحاها إلى تنين ٍيملأ بهيجانه أرجاءَ المعمورة، كما في الأساطير اليابانية, لأننا نحن مَنْ صنعناه وألبسناه ذاك الثوبَ, صرنا نسجدُ له, مؤمنين كلَّ الإيمانِ بقوّتِه التي اكتسبها من خوفِنا وجبننا, بأنه يخرجُ النارَ من فمِهِ ليحرقَ قرانا وأرضنا, التي أصلاً لم يبقَ فيها شيءٌ يحزنُ على زوالِه. تكلمْ وثرثرْ على الربِ, ولا تقربْ من خيال التنين.
لم نعدْ نجابه ولا نقوى إلا على أنفسِنا, تناثرتْ بركة جَدي أمامَ رياح الشحّ, صارَ لا همّ لنا إلا أنْ نصعدَ على أكتافِ بعضِنا, نشي بهذا وذاكَ, حسدٌ قاتلٌ حديثُ الولادةِ بيننا وفسادٌ استفحلَ , صارَ يرقدُ على وسائدِنا بعدَما كنا نسمعُ في الماضي عن رجالِ الدولةِ, لم يكونوا ليجرؤوا أنْ يلامسَ لسانَ أبنائِهم طعامٌ وشرابٌ ابتاعوه بمالٍ متسخ, مدُّ اليد صارَ عادة, اشتهرنا بها من دمشقَ إلى قرطبة, يضربُ بضمائرنا عرضَ الحائطِ, لنبيعَ شبابنا وكياننا من أجل حفنةٍ من دراهمَ لا تدومُ, بل تديمُ الفجوة بيننا, تطفئ الدمعَ الذي كانَ ينهمرُ من داخلِنا على ماضي الأجدادِ الذي لسنا جديرين بهِ, لا يدركونَ البعدَ الذي ترسُمه أيدٍ خفيةٌ , ليكونَ كلُّ الشعبِ مخطِئاً, ولكي لا يتعالى أحدُهم و يطلب الصلاحَ, حتى يغرسوا في عينيه ما بَلع من فتات يوماً, وتُطبّقَ كلُّ قوانين الأرضِ على رأسِه. والتنينُ يتفرّجُ, يضحكُ علينا, يعتبرنا قد خنّا القريبَ منا , ولن يستطيعَ أنْ يثقَ بنا, مثلُ الخائنِ الذي قالَ عنه (نابليون بونابرت): سرقَ المالَ من أبيه ليعطيَه بيدِه للسارقِ, فلا السارقُ يشكرُه, ولا الأبُ يغفرُ له ما اقترفتْ يداه.
مِن فعلِ أيدينا صنعْنا الهمّ, وابتلعنا العلقمَ كسيفٍ وصلَ إلى أسفلِ ظهرِنا، والهمُّ لم يتجرعْ منا, حكمنا على أنفسِنا بأنْ نكونَ بمعزلٍ عن الناجحين, أقنعنا أنفسَنا بأنّ أناملنا لا تصلحُ إلا لقطافِ الزيتونِ, وحمل لفافة التبغ، أو لسرقةِ الفتات, وأنّ الأناملَ التي رسمتْ لوحة عبادِ الشمس, نحتتْ تمثالَ موسى, ووضعتْ أحجارَ سور الصّين، هي أناملُ أناسٍ من عالمٍ آخرَ , والعقولُ التي درست الطبَّ والكيمياءَ وصنعت الثوراتِ وحركاتِ التحرر والانفتاح هي عقولٌ مستوردة, سجنا أنفسَنا في سجنِ التحسّرِ دونَ سجّانٍ, وأنّ الأوانَ قد فاتنا , وابتلعنا المفتاحُ لكي لا نرى نورَ الشّمس الساطعةِ التي تصبُّ العرقَ على جباهِ الأحرار, شُلتْ أيدينا, صارتْ هشةً, كالبركةِ الصادقةِ التي كانتْ تجمعُنا, صارتْ عاجزة عن حفر كوةٍ صغيرةٍ لينبثقَ منها شعاعُ نورٍ ضئيل على مسرحِ حياتِنا, وخرجْنا من ديارنا بكلماتِنا, ليسَ من بابٍ مفتوح أمامَنا إلا الهروبُ والهجرة.. هو الحلُّ الذي سينجينا من لهيبِ التنين الزائفِ, وأنّ الترابَ الذي نعيشُ عليهِ لا ينبتُ فيه الأبطالُ.
كنتُ أظنُّ خطأًً في بدايةِ أيام شبابي أنّ الطاقة التي بداخلي قادرةٌ على أنْ تهدَّ جداراً وتثني كومةً من الحديد، معتقداً أني سأعملُ دونَ يأسٍ لأخدمَ وطني الذي حناني له يغطي كلَّ بقاع الأرض, ولن تلهيني لقمةُ العيش عن أهدافي السامية, لكن, حدثَ عكسُ ما أريدُ, فابتعدتُ كلَّ البعد عن كلّ ما يصادفُ طريقي, لأنّ ما سأفعله ليسَ إلا صلواتٍ وثنية لا تلقى عندَ الإلهِ أيَّ حسناتٍ, ليذكرني بأني كرديٌّ, مسلوبٌ من أدنى حقوقي، سببُها حرقة كانتْ تلدغُ كبدي من أحوالِ الكردِ, تناثرُهم مثلُ غبار الطلع في الهواء, حدثَ ما يُسمّى في الفلسفةِ ردة الفعل العكسية, ونمتْ بذرة الأجداد بي, سقاها ماءُ أفعالهم وكلامهم. لا يهمني الشعارُ الثلاثي, فأنا أريدُ أنْ أشعرَ بحريتي من ذاتي, وعالم القمع لطالما ستسعى البشرية لاقتلاعِه, لأنها الطبيعة الإنسانية.
لكنها طامةٌ كبرى, إنْ شعرتُ أنّ المعظمَ صارَ يستنكرُ وجودَك, لتصبحَ محارباً دونَ أنْ تشعرَ-حتى من أقربِ الناس منكَ, ليقحموا في رأسِك أنّ الهجرة مكتوبةٌ على جبينكَ من أوّلِ يوم وطِئْتَ به هذه الدنيا, لتكونَ غريباً في الغربةِ، وغريباً في وطنكَ، وغريباً حتى في قبرك ومماتك.
شعورٌ زائفٌ ملكته عندَما كنتُ أرى (خضر) قادماً إلى المدرسة بسيارةٍ مرفهة بارحة يقودُها سائقه الخاصُّ, الدمُ يجري بينَ عينيهِ، كرشه المستديرُ, كأنّ ازدحامَ المخابز كانَ وما زالَ بسببِ التهامِهِ كلَّ رغيفٍ بطريقهِ, يتدلَّقُ كرشه على المقود، وسوارٌ من الذهب الثقيل يزينُ معصمَه، ليعبّر بكلّ الطرقِ أنّ التخمة أصابته في كلِّ شيءٍ, الأحلامُ لا مكانَ لها بينَ جدرانِ حياتهم لأنها سهلة المنال في أصعبِ الأشياءِ, وما معناها إنْ كانتْ تتحقق بلا تفاصيل باهظةٍ مثلَ التي ندفعُها ولا نبلغُ عتبة بابها.كنتُ أواسي نفسي بأني أعلوه بتفكيري ونظرتي المتفائلة لمستقبلي, أحملُ أحلاماً سأستلذُ بكفاحي لتحقيقها, أنظرُ له بشفقةٍ, تبينُ أنه كانَ شعوراً متبادلاً, وطريقُه الأقصرُ والأنفع، هو برأي المجتمع الهشّ وبرأي أبي, الأذكى والأفضل, يخدعون أنفسَهم ويخدعون حتى أحاسيسَ ألسنتهم، كانَ من دونِ المتفوقين يدبُّ الرعبُ بكلِّ الرسل, لم أكنْ أعلمُ أنّ هناكَ غيرَ اللهِ يهابُه الرسلُ, أصحابُ الرسالةِ وملقنو العلم, لكنْ كيفَ درسَ الهندسة؟ هذا ليسَ بالسرّ, يعرفه الجميعُ, بظنهم أنه مكانهم, يفعلون ما يريدون ونحن مَنْ ليسَ له مكانٌ إلا خارجَ البلادِ, أو أنْ نهتفَ لهم ونصفقَ على ما يفعلونه بنا ونرضى, معتقدين أنّ لا زوالَ لنعمتهم،كما آمنَ ( ستالين ) وظنّ ذلك (هتلر)، والعدالة الإلهية لن تصلَ لبابِ بيتهم ما دامَ أنهم يقتلعون كلَّ رأسٍ يخالفُ آراءَهم, لا يفكرون لثوانٍ, عندما نقمعُ الناسَ, لنضعَ أنفسَنا دقائقَ وننظرَ للحياةِ بعدسةِ عيونهم التي يرونَ بها العالمَ من حولهم، لنرى ما سيكونُ موقفنا وشعورَنا من أنفسِنا. القانونُ والدستورُ المقدسُ مخلوقٌ لنا وليسَ لهم, المخطِئُ يجبُ أنْ يُحاسَبَ، لا شيءَ فوقَ القانون, إلا هم، يُحاكُ كالثوبِ على حجم أردافِهم، متناسين جميعَ القوانينِ والأنظمة الوضعيّةِ والسماويّةِ التي لا تغتالُ الآمالَ. لا أنسى أستاذي عندما استرقتُ السمعَ عليه وهو يجلسُ معَ زميلِهِ، يُراقبُ مسيرةً إلزاميةً حاشدة, خرجتْ تؤيّدُ وتهتفُ، ظانّاً أنَّ المدرسة قد خلتْ، وأخذَ مجدَه في تفوهِهِ بتلك العباراتِ:
- اهتفوا. واهتفوا, باسمهِ ومجدِه. اهتفوا, تظاهروا، لأنّ النعيمَ الذي أنتم فيه سيزولُ بزوالِ هتافِكم, كسرة الخبزِ والخوفِ من الجوع هي ثمنٌ بخسٌ لوطنِكم, تناسيتم حكمةَ اللهِ أنه لم يخلقْ فماً إلا وأطعمَه، ولم يتركْ ظالماً إلا وقهرَه، ولا مظلوماً إلا ونصرَه. وعندما علمَ أني أسترقُّ السمعَ, سكتَ وابتسمَ، وما زالَ إلى يومِنا هذا عندما أراهُ مصادفةً, يبتسمُ في وجهي وأبتسمُ له, لا يعرفُ سرَّ تلك البسمةِ سوانا, إنه كانَ يعلمُ الخطيئة كالملايين غيرِه, لكنه حرمَ مثلي أنْ ينادي بها جهراً.
يقولُ غاندي: لا يستطيعونَ أنْ ينتزعوا منا احترامَنا لأنفسِنا ما لم نتنازلْ لهم عنه, إنّ موافقتنا على ما يحدثُ لنا وسماحَنا به هو الذي يؤذينا أكثرَ بكثير مما يحدثُ لنا.
الفصل الثاني
قطعتْ أفكاري طرقةٌ على البابِ. مثلما تقطعُ زخاتُ المطر صفوةَ رسّامٍ في الطبيعةِ, فخيرُها هو كرسامٍ يحبُّ المطرَ ويعشقُه، وشرُّها أنّ لوحته إذا تركَها تتحولُ بلمساتِ الطبيعةِ إلى لوحةٍ تشكيليةٍ, تجريديةٍ, مثلي تماماً, أردتها أنْ تأتيَ ولا تأتي, كانتْ أمّي تلبسُ زِيَّ صلاتها, شالُها الأبيضُ المسدلُ أكثرُ من حدودِ كتفيها. لا رابطةَ قوية بينَنا, ربما لأني أفرغتُ نهرَ حناني في بحرٍ آخرَ, عوضتُ عن حنانها بهواءٍ عميقٍ أستنشقه من عبقِ طفولتي, بعدَما لمستُ بأنها لن تستطيعَ كباقي الأمهاتِ أنْ تفهمَني, ربما كانَ شعوراً فلسفيّاً دراماتيكيّاً بأنها هي من جاءَتْ بي لهذهِ الدنيا.
دلفتْ لتبلغني بأنّ الساعة أصبحتْ السابعة, حاولتْ إيقاظي بعدَ الفجر لكني لم أستيقظ, فقلتُ لها:
- طالما تأخرتُ دعيني أنمْ قليلاً وسأستيقظ بنفسي. فعادتْ وأعادتْ قولها:
- بنيّ إذا تركتُكَ أعرفُ أنكَ لن تنهضَ, ستعودُ للنظر للأعلى مثل عادتِكَ وتسرحُ بخيالِكَ للأفق. وتلفظتْ بتلك المقولةِ التي مراراً ما تذكّرَها، ذلك المثلُ الكردي.. فحواه أنّ " الفلاحَ ينامُ بينَ روثِ الخيل ويحلمُ بإسطنبول "
خرجتْ من عيوني نظرة تمادتْ بالقسوةِ عليها, انقبضتْ على تمردها, أرغمتْ هذا العقلَ على أنْ يُسبلَ تلك العيونَ بنظرةِ عطفٍ إلى مَنْ فتحَ برمشِها للدنيا، وليس ذنبُ الأمِ القسوة التي بها, تركتُ تلك العيونَ تخاطبُ عظمتَها التي ستفوتني ببعدِي عنها.
أي إسطنبول؟. يا أمّي ليتكِ تعرفينَ, يا مَنْ لم ترأفي بحالي, كنتِ دائماً تذكرينني بفشلي وعدم إتمامِ دراستي, كنتم دائماً تلقونَ بخيوطِ الملامةِ والحرقةِ من أيّ شيءٍ على شواطئ أحزاني, كم حاولتُ الحوارَ معكم؟ كم جاهدتُ في سبيل إفهامِكم أني وهمومي و أحزاني أكبرُ من الذي يجولُ في بالِكم؟ تعتقدونَ أني سأهدمُ البيتَ على رؤوسِكم. وهل بقي بيتٌ في الوطن عامر، و لم يُهدمْ, إلا بيوتَ العناكبِ والدبابير؟. وحسبُكم الهدمُ والردم.
ليتكِ تفهمين يا أمي بأني رفضتُ أنْ أدرسَ تاريخاً مزيفاً, قد كتبوه كما مالَ بهم هواهم، لقد أبيتُ. ما أذكره أنه أولُ رفضٍ لي, أنْ أحفظ خطاباتٍ وشعاراتٍ وأقوالاً خالدة أكثرَ من حفظي لكلام الإلهِ سُبحانه, لم أكملْ تعليمي لكي لا يحشوا عقلاً كانَ بكراً في حينهِ. قررتُ أنْ أنهلَ من العلم الذي لا ينتهي في بحار الدنيا عندَ حدٍّ, أقرأ ما أريدُ وقتما أريد, أعلّمُ نفسي وأولادي تاريخَ الكرد. لن أناقشَكِ يا أمي بأنّ البطلَ (سليمان الحلبي ) هو سليمان محمد أمين أوس قوبار, كردي من قرى عفرين، نسبوه وأسموه مثلما أرادوا مثل الآلاف غيره, ( عبد الرحمن الكواكبي ) أيضاً من ملتنا, ذكر كثيراً وأفردَ طويلاً عن الاستبدادِ والظلم, ولن أخيّبَ ظنّكِ بمثلكِ الأعلى بإسطنبول وقادتها الذين كانتْ ستكسرُ شوكتهم, عندما أعلنتْ بريطانيا في الخامسِ من نوفمبر سنة 1914رسميّاً الحربَ على تركيا واحتلت البصرة في 22من ذلك الشهر. إنه تاريخٌ لا أنساه يا أمي, عرفته وأنا في عمر التاسعة, حفرَ كعمقِ البئر في أعماقي,كيفَ أنّ القبائلَ الكردية تصدتْ للإنجليز قبلَ أنْ تصلَ إلى حدودِ لواء الكوت.كانَ يقودُ الجيوشَ الكردية الشيخ ( محمود البرزنجي ) قُتلَ واستشهدَ العديدُ من الأكراد البارزين مثل رشيد باشا من السليمانية وغيرِهِ كثيرين.
حاربوا الإنجليز ليزيدوا حقدَهم حقداً, لأنّ جدَّنا صلاح الدين, ومازالتْ جراحُهم لم تندملْ, عندما أوقفَ أطماعَ الإمبراطورية الأوروبية تحتَ غطاءِ المسيحية لتتمَّ تصفيةُ الحضارةِ العربية والإسلامية من كلِّ القيم التاريخية, فعلوا وانتقموا وقسّموا بهدية كبرى لنا دونَ وطن, ولتلك الدول التي دافعْنا عنها و ذرفت دماءُ أجدادِنا على مشارفِها, أنها اقتسمتْ زادَنا وبقاءَنا, وهبنا لهم سلاحاً بيدِهم ضدّ بعضِهم بعضاً, ونحن عندما نطلبُ أدنى حقٍّ لنا تتحدُّ كلُّ تلك الدولِ والشرقِ بأكملِه ضدنا, يشتمون ويهتكون عرضَ وطولَ الحدودِ ولا يعترفون بما صنعه الاستعمارُ, عندما يكون الشأنُ خاصاً بهم, وعندما يكونُ الشأنُ عن الأكراد تصبحُ الحدودُ منـزَّلةً ومقدَّسة من آلهةٍ جليلةٍ ومبجّلة..
لا يا أمي لا أنظرُ إليك لأودّعك، لكني أخاطبك من قلبي لتتركيني بهمي. الذي لا أعرفُ هل حملته اختياراً أم اضطراراً. رجعت للحديثِ معي. ربما ظهرتْ عليّ معالمُ الحدّةِ وهدأتْ. كبركانٍ ثارَ وانفجرَ داخلَ نفسِه، حتى سكان القرية الذين يقطنون على سفحِه لم يغادروا البتة. تمتمتْ وهي تُمسكُ سبحتها الخشبية التي طالما حلمتُ بأنْ أستبدلَ بها أخرى من الأحجار الكريمة, أقلّ ذكرى من ولدِها الذي سيرحلُ عنها في أزقة الغد المجهولة. طقطقة حباتها تصدرُ رنيناً كموسيقا الطفل الإلهيّ موزارت لطالما حُببَ إلى سمعي صوتها.
- هذا كلامُك بأنك تحبُّ الذهابَ للقرية والجوُّ باكرٌ وممطرٌ, اليوم هو مرادُك, هيا. هيا انهضْ وكفى لذهنكَ أحلاماً.
- لا بأس أمي أعطيني بعضَ الوقت، واذهبي للنوم، لم تنامي بعدَ الفجر.
رحلتْ وغادرتْ ولحقها تأملٌ مني وراءَها, لأنها تعرفُ أنّ ثالثَ مطلبها سيكونُ جدالاً. فقبضت على لحافي القطني الذي اخترقَ رأسي عبقُ رائحتهِ القروية, كأني أعيشُ الفصولَ الأربعة في اللحظةِ ذاتها ولففته حولَ رأسي, تعرى أسفل جسدي, كمستاءٍ جدّاً من نفسِه, أطفأتُ المذياعَ بحركةٍ من أطرافِ أصابع قدمي وعدتُ لخيالي. لكنْ هذه المرة ليسَ لجدي. إنما إلى شيروان الكردي. (كروبيون). رجلٌ من صلبِ ثنايا الجبال, لم أستطعْ في ليل البارحة البارد الكئيب أنْ أستغلَّ سكونَه لأعيدَ ترتيبَ الكلماتِ التائهة التي كانتْ في لقائِنا, جمعت ثلاثي المآسي على طاولةٍ نحاسية مستديرة.
هذا الذي لبسَ تاجَ فرعون وثوبَ موسى في آنٍ واحد, وجمعَ بينَ نسماتِ فكره وعقله الدهاء والتحرر, مزجَ في كأس حياتِه الحكمة والبوذية والليبرالية ومعاني سامية عن حبّ السلام والإسلام, وإيمانهِ الراسخ بحوار الأديان, وطنيته، اعتزازه الذي لم أرَ له مثيلاً في العصور وكتبِ التاريخ القديمة والحديثة, عاشَ في جسدِه وذهنه كلّ نقيضٍ في هذه الدنيا, لأنّ ما كان يشغله كيفَ يجعلُ شعوبَ العالم تتلاحمُ بمحبةٍ وسلام, دونَ أحقادٍ وكراهية, أحلامُه أكبرُ منه, فكرة اقتناعِه بأنّ السلامَ صعبٌ أنْ يعمَّ بينَ شعبين تقاتلا وسالتْ دماءُ كليهما، كانتْ صعبة, ربما كانَ يظنُّ أنّ الناسَ يحبون ويعشقون السلامَ مثله. لأنه تناسى آلامَه وآلامَ أجداده وتخلى عن أيّ مطلبٍ وثأر, وحلمَ ورضيَ بحياةٍ بسيطةٍ تسودُها الحرية وأجزاءٌ لا تذكر من حقوقهِ، ليقنعَ غيرَه بأنه راضٍ عن أيّ شيءٍ رغم كلّ شيءٍ, لكنْ حتى تلك التي تُسمى أيّ شيء احتاجتْ لانضمامه لنا, لكي يسعى في أنْ يحصلَ مثلنا على أدنى وجودٍ له..
تُذكرني تقاطيعُ وجهِه, حزنُ عينيه, شعرُه الطويلُ الذي يجاهدُ ليصلَ لأكتافهِ, لحيته الكثة بخيال المسيح الذي تناثرتْ صورُه داخلَ الكنيسة, يوم تجمعنا بها في إحدى القرى النائية ووارينا بها الثرى صديق أبي رحمه الله أبا يعرب.
لاقيته في دمشق البارحة, كنتُ هناك لأنهي أوراقَ السفر, لأودّعَ شوارعَها وحواريها, أصدقاءَ الجيش الذي قطفَ من زهرة شبابي عنوةً قرابة ثلاث سنوات. عندما بدأتُ لم أكن لأتخيل أبداً أنه سيأتي يومٌ أنهي فيه خدمتي, وأزور دمشقَ مودعاً وأرحل عنها كما الذي يعودُ محبطاً من الحربِ قاتلَ ودافعَ ورمى بكلّ ثقل جسدِه, ثم تعودُ له قرابينه خاسئة مرفوضة، ويُتوّجُ غيرُه بأوسمةِ النصر رغم أنه لم يسمعْ عن تلك المعركة لكنه حظي بحبٍّ واحتضانٍ لا مثيلَ لهما, عين في وظيفةٍ من تلك الوظائف التي خصصتْ للذين عناهم جدي, لم يعرقوا.
كما قالَ لي العمّ (حميد) ابن عم أبي وهو يضعُ داخلَ يدي نقوداً أسعفتني تلك الأيام حينما قابلته في أحدِ الأحياء مصادفةً في دمشقَ, وأنا لا أملكُ قرشاً واحداً, جائعاً, حائراً، ما كنتُ أملكه أملي بالله الذي قادني بإلهامِه أنْ أمشي في شوارع لا أدري أين تقودني, إلى أين ستوصلني، ربما إلى رحمة الله التي تجلتْ بشخص العمّ حميد ( أبي رشيد) ودونَ أنْ أطلبَ منه أعطاني ما أبتغيه ويفيض, وهو يقول لي:
- لا يدومُ إلا وجهُ الله, كلّ شيءٍ إلى زوال, ستنهي الخدمة وتجد هذه الأيام صارتْ من الماضي.كانَ كلامُه زبد الصواب, أنهيتُ خدمة الجيش, لكن, لم أستطعْ أنْ أنهي كلامي معَه وأجتمعَ به ثانية بموعدٍ أو مصادفةً, لأنّ لقاءَه صارَ أبعدَ من حلم, لكنْ, كنتُ شديدَ الحرص على أنْ لا أنسى ذاكَ المعروفَ الذي زرعه معي، وأحرص كلما ذهبتُ لزيارة أبيه (بافيه خالوه) أن أعطيه ما يقدرني الله عليه جزءاً من ردِّ الجميل, لأنّ الإنسانَ أحياناً يشعرُ بأنه عاجزٌ أمامَ فعل مهما يكنْ بسيطاً لم يلقه من أقربِ الناس منه, لأنه أعطي بسخاءٍ من شخصٍ هو بأمس الحاجة لما عندَه, رغم علمي بأحوالهِ, لكنه لم يترددْ أنْ يقدمَ لي العونَ الذي تجلى بالعطاءِ الحقيقيّ منه, هو عينه الذي قصدَه جبران وقال عنه: (جميلٌ أنْ تعطي مَن يسألك, وأجمل منه أن تعطي من لا يسألك وقد أدركتَ عوزَه).
تلك كقصة الكُرد-لم يلتمسوا العطاءَ حتى من أقربِ الناس منهم, لو أعطوا لكانوا دونَ أدنى شكٍّ مثلي لا ينسون العطاءَ، وإنْ كانَ ذاك العطاءُ الذي سيهبونه لهم ليسَ مما يحتاجونه كما حاجة العمّ حميد لما أعطاني إياه, إنه عطاءٌ من كنوزنا وحقوقِنا ولا نملك إلا كلمة شكرٍ لنقولها, والتي حرمتني الدنيا من ذكرها للعمّ حميد.. لأنه انتهى هو من هذه الضوضاء, رقدَ بسلامٍ فجأة, مبكراً مثلَ العم ( أبي يعرب )..والخال (عبدالله).. وجَدي, كُثر كانوا مَن أخذهم الموتُ, انتزعهم من فم الحياة وهم في عز عطائِهم, ومطرقة العطاء التي ينهالُ بها الحدادُ ليكسبَ عيشه ما زالتْ بيدهم..
كنتُ في طفولتي أحملُ شبقَ التعلق بهم, أحاورُ دائماً نفسي, سيأتي اليومُ الذي أحادثهم بعدما أكونُ نضجتُ وأصبحتُ يافعاً بنظرهم, لأتذكرَ معَهم بعضَ العبارات والأحداث التي مرّتْ علينا, سيكونُ الشيبُ بدا على فروة رؤوسِهم, لكنْ, حتى الشيب استكثرَ أنْ يطولَ بقاؤه عليهم, كم كنتُ تواقاً في صغري للحديث معهم, كم تعلمتُ من حديثهم وصمتهم الكثيرَ وفاتني الأكثرُ منه, لكنّ الزمنَ لا ينتظرُ الأماني والأحلامَ, لا كبيرَ معَ الموت, إنّ الإنسانَ مردُّه إلى مَنْ فطرَه, رحمهم الله. ذهب كل في طريقه, كان آخر مكان أجاهد وألهث لأصل له ذاك القبر الذي نُصب من عبق تراب وصخرتين ترسم مسقط الرأس ونهاية خطوط الأقدام التي جالت الدنيا بنقطةٍ من حلوها وجبلٍ من مرها, الذي قادهم للجنة ونعيمها, وأنا لجهنم التي على الأرض, تركوا شوكةً في القلب لتعصر مر الحياة دون سبب ٍعلى كل برعم ٍ يحاول الانشقاق.
إنَّه قطارُ الحياة يمشي دونما توقفٍ, لا بدّ لكل واحدٍ أنْ ينـزلَ منه, لا بدّ من وصولك إلى المحطة المعيّنة لنـزولك, سينـزلُ غيرُك في محطةٍ أخرى, منهم مَن نزلوا قبلك, لا تستطيعُ أنْ تختارَ متى ومعَ مَن ستنـزل, لتلوّحَ بيدك لجموع الناس الغفيرة ممن ظلّوا في القطار, تودعهم, تذوبُ وسط الزحام, بانتظار الحشر, معَ حزنٍ يبدأ كبيراً داخلَ أعماق محبيك، ثم ما يلبثُ أنْ يصغرَ شيئاً فشيئاً, مثل تلال القرية التي تبتعدُ وتتضاءلُ عندما نغادرُها قاصدين المدينة..
" إنّ سرّ الحياة والموت كانَ ولا يزالُ وسيبقى بيدِ الله, هذه حقيقة, لا تشوبها شائبة ". ألم ترَ أنك تُلف بقماط أبيضَ لحظة ميلادك, وتُلفّ بكفنٍ أبيضَ مثله عند الممات؟ ستجدُ بعدها أنّ الحياة كلها ما هي إلا لحظاتٌ، بضعُ لحظاتٍ آنَ لها أنْ تتبخر.
لم أكنْ أرغبُ في أنْ أترجلَ من القطار دونَ أنْ أعطي للدنيا ولنفسي حقَّها, أنْ أنتزعَه من فم الحياة أو أنْ تنتزعَه الحياة مني لا فرق, آمالي كأيةِ آمال, وأبنائي يجبُ أنْ يكونوا كأي أبناء, عالمٌ كبير يحيط بنا, آفاقٌ نيرة وأخرى مظلمة. عظماء, رؤساء, سلاطين, ملوك،رحلوا، ترجَّلوا من القطار. يُذكر حسنُ فعل بعضهم ويذكر ظلمُ وقبحُ أغلبهم, سجل العمر فيه صفحات يجبُ أنْ تُملأ, أهداف يجبُ أنْ تقطف. ثمة رجال خُلقوا لتُزرع قاماتهم في جبال الصعاب, ما دفعني أنْ أنشئ جمعية (الحزام) لخدمةِ الكرد والإنسانية, والحياة ليستْ إلا أمانة في أعناقنا سنسألُ فيمَ أضعناها إنْ كانَ خيراً لنا ولأبنائنا وإن شرّاً لنا ولأبنائِنا ولعذابنا.
جلستُ مع (شيروان) في مقهى النوفرة, في دمشق العتيقة, كنتُ جديدَ العهد مع الغليون الذي لم أكن أظهره للناس والملأ إلا بعدَ تحرري من العبودية, أظهرته برأيي شعاراً خاصّاً يعبرُ عن جزءٍ مفقود من الحرية, أشعلته ودخانه شكلَ غيمةً وهمية من عبقه، تلاشتْ بسرعة في الهواء, اختفتْ في المجهول كما ضاعتْ نفسي بعدَها في حواشي الغيوم.
جلسَ كعادته السيئة, يلاعبُ لحيته الكثيفة, يستنشقُ من أنفه ليشتمَّ رائحة التبغ التي كانتْ تحلو له من غليوني, والهواءُ يدفعُ بها لترتطمَ بقاياها بوجهِه الصبور, زيّنَ عنقه بسلسلةٍ فضية, وضعَ فيها حرفَ الكاف باللاتينية لتدلَّ على (كردستان) لأنّ ذلك أقصى درجة من الحرية المخفاة التي نمنحها لأنفسِنا, حتى لو علموا ما يرمزُ له ذاك الحرفُ الوحيد لاقتيد وزجَّ به في السّجن.
ينظرُ إلي باستغرابٍ, غيرَ مصدقٍ أني أنهيتُ خدمتي وسأرحلُ بعدَ عدةِ أيام إلى الخليج, كانَ يعتبرُها مزحة مني لأني كنتُ كثيرَ التذمّر عليه, وعلى الإخوة في الآونةِ الأخيرة, كنتُ أطلقُ دائماً عباراتِ التهديد بالانسحاب والتخلي عن كلّ شيءٍ إذا ظلّ تقدمُهم كالسلحفاة, لكنه أيقنَ عندما رأى التأشيرة ألصقتْ على جواز السفر أنّ الموضوعَ خرجَ من قدم السخرية، وتدحرجَ إلى ملعب الجدية, ما ينقصُه صافرة البداية التي ستربكه.
تأهبَ للحديث ومن ثم ضجّ. اتسعتْ قزحيتا عينيه, التقط أنفاسَه, كأنه مصارعُ ثيران يريدُ أنْ يجمعَ قواه في شهيقه, ثم أخرجه بقوّةٍ عارمة لدرجة أني شعرتُ برائحةِ نفَسِه المخلوط معَ عطره.
- أين ستذهبُ ؟ ولماذا؟
- إلى بلاد اللهِ الرحبة. إلى البلاد المقدسة.
- وأحلامك؟. وآمالك؟
كم كنتُ أبله عندما أخفيتُ عليه وآثرتُ ألا أقولَ تلك الحقيقة التي كانت السببَ الرئيسَ وراءَ سفري, وأنّ الحبلَ الذي مددته بيني وبينَ الوسيط مع النظام ( أبي مهران ) التفَّ حولَ عنقي, فهمتُ منه في لقائنا الأخير: اخرج من البلاد سالماً قبلَ أنْ يصيبَ عائلتك أيُّ مكروه, تلك الرسالة,كانت الجوابَ الذي وصلني عندما طلبتُ بكلّ وضوحٍ مقرّاً تدريجيّاً لجمعيتنا, نسي كيفَ أنه حبك مَكرَهُ وتظاهرَ بالتأييد والرضا في البدء, وأخذ يفردُ لي ويلهجُ بحمدِ الكرد, أنّ رؤساء سوريا السابقين (أديب الشيشكلي) و(حسن الزعيم) و(فوزي سلو) هم أكراد, وأنه كانَ معجباً بالزعيم (كمال جنبلاط) ذي الأصول الكردية, وتحدثَ مطولاً عن حرب تشرين التحريرية عندما استخدمَ الجيشُ السوري للتحدث في اللاسلكي اللغة الكردية في الجبهة, حتى لا تلتقط الرادارات ولا يقدر العدو على فهمهم, وأنّ أولَ طلقة كانت ضدّ الاستعمار الفرنسي كانتْ من المناضل الكردي ( محمد أيبو ) من منطقة عفرين. ظلَّ يحفرُ لي إلى أنْ أمسك بخناقي وشد الاعتراف من لساني عمَّا يجولُ في قلبي, سياسة سافلة جوفاء.
التعليق
دغدغ وجنتي انبثاقُ الشمس الخجولة تخفي نفسَها خلفَ الغيوم تارةً, وتظهرُ في كبدِ السماءِ الشاحبةِ تارةً أخرى, كأنّ شيئاً لم يكنْ, ينكبُّ شعاعُها الخافتُ مثل آمالنا, من ستارةِ بيتنا القديمة, مزركشة بألوان غير متجانسة، كأحلامي تلك الليلة.كابرت على نفسها, لتكسو النافذة ككسوة عروسٍ ثكلى بثياب سوداءَ بالية, قلبُها حزينٌ, لكنْ, مَنْ يرَها يحسبْ تطايرَها معَ هباتِ النسيم مِنْ هول فرحها.
فتحتُ عيني وأنا أخدعُ نفسي, بأنّ النومَ لا يزالُ يطرحُ جسدي, وسواسٌ ثائرٌ ينتابني من ملائكة الحنين كأني بحاجةٍ إلى نومٍ سرمديّ, لا أستيقظ منه إلا فوقَ ترابِ قريتي. نبضاتُ قلبي تلعنني, تدقُّ في شغفٍ كقرع طبول قبائل سوبارتو, حزينةً لا تريدُ تركَ جثتي التي رافقتها عدداً من السنين, لتزيدَ من خفقانها وترسمَ ألوانَ لومِها لعدم يقظتي وطردِ الضيف الثقيل عني.
بينَ حيرتي ولوعتي, قررتُ أنْ أكونَ رسولَ خيرٍ بينها وأظلّ ممدداً في فراشي الملطخ بأحرفٍ متناثرةٍ مبلولةٍ بماء الأسى, علني أرضي في أسوأ احتمالٍ حواسي.
أطلقتُ العنانَ لناظري, تأملتُ الغرفة الحزينة التي لم أعهدِ الاستيقاظَ فيها, أصبحتُ أرتادُها وأنامُ فيها قبلَ رحيلي, لأختصرَ رحلتي عندَ احتضاري, لأنَ الجثمانَ يُوضعُ في أكبر غرفِ البيتِ عندَ النحيب عليه, أملاً في أنْ أجدَ نفسي مقتاداً لقريتي, جثةً هامدة, كهلاً, عاجزاً, شجرةً, صخرةً, لا فرقَ عندي, المهمُّ أنْ أكونَ في مهدي ولحدي.. وأنْ أدفنَ بينَ عظام أجدادي.
تسلل طيفُ جَدي إلى ساحةِ نزالٍ بينَ أفكاري و ذكرياتي.. بعدَ نصرة الذكرى سبقتها دمعةٌ صامتة خرجتْ من طرفِ جفني, شقتْ طريقها إلى ما وراء أذني، كأسيرة كانتْ ولم تصدقْ أنه فُكّ أسرُها بهذه السهولةِ والرجولة, فالأسيرُ بجسدِه يأتي يومٌ, تُعطى له مفاتيحُ أغلالهِ ويساقُ لِمَنْ يبت بحالهِ, أمّا أسيرُ الروحِ مثلي فيظلُّ مكبلاً إلى أنْ يشرقَ نورُ الحريةِ القريبةِ البعيدة. حتى تقاسيمُ وجهي استغربتْ قدومَ طيفِ تلك الدموع السابحة والهاربةِ من شبح السّفر. فبحسب العاداتِ الشرقيةِ البائسة, فإنّ الدموعَ لا تذرفُ من الرجال، صنعتْ لتذرفها النساءُ على الرجال.
تذكرته عندما كانَ يبحثُ بينَ حباتِ العنبِ التي أكلتْ منها الطيورُ وأحدثتْ فجوةً فيها وتمايلتْ لذبولها, كانَ يبحثُ عن تلك الحباتِ, يلتقطها, يأكلها بنهم ٍ,كأنّ أحداً سوف ينتزعُها منه, ويقطف لأحفادِه أشجعَ وأكبرَ عنقودٍ في القرية, قد فاحتْ بعضٌ من صفاتِه, كما تفوحُ رائحة النعجة المختنقة, إنّ البخلَ من خصالِهِ, يحرسُ الكرمَ من شدّةِ حرصِهِ, لكنْ ما أذكرُه أنه لم يبعْ في يومٍ من الأيام حبةَ عنبٍ لأحدٍ, بل كانَ كثيرَ السخاءِ معَ الكلِّ بغيرِ حدود.
أشعلتْ فيّ لهيباً تلك الحادثةُ التي جرتْ عندما أقبلَ على داليةٍ كانتْ قد هُشمتْ وتناثرتْ عناقيدُ العنب على طولِ الطريق وعرضِهِ, ينظرُ إليها بحزنٍ معَ عقدةِ التبرّم في خارطةِ وجههِ, ويقولُ: وهل طلبَ مني أحدُهم يوماً ما اشتهتْ نفسُه أنْ تقطفَ وتأكلَ, أو يأخذَ منها ما يطيبُ له ومُنعتْ عنه؟ إنّ كرمَ العنبِ يكفي القرية والقرى الباقية ويفيضُ, لكنّ ما يحزُّ في نفسي السرقةُ في الجهر لينالوا مبتغاهم دونَ ذرفِ قطرةِ عرقٍ. أدركتُ بعدئذٍ أنّ جَدي سريالي, فيلسوف من المدرسة الفطرية,يبحثُ عن اليقين في أصغر الأشياء, يريدُ أنْ يعبرَ عن آرائِه بقدر ما يستطيعُ, لو عاشَ لعلِمَ أنه أخطأ عندَما ظنَّ أننا سنبقى على تلك البركة, ليتنا بقينا, وويحنا إنْ لمْ نعدْ ونبقَى.
كانَ -رحمه الله - يملكُ ما فقدناه نحن: القناعة, العطاءَ في محلهِ ومكانهِ. بساطته غلبتْ عليه, لم يكنْ يدري أننا نعيشُ وسط أناسٍ حسب المقولة: مثل الديوك تعتقدُ بأنّ الشمسَ لم تشرقْ إلا لتسمعَ صياحَها, ونحن مَنْ أصابتنا الرجفة من صياح الديك, بعدَما كنا نصطادُ الذئابَ بأيدينا ونقتلعُ رأسَ الأفعى بأسناننا. تحولَ الصياحُ بين ليلةٍ وضحاها إلى تنين ٍيملأ بهيجانه أرجاءَ المعمورة، كما في الأساطير اليابانية, لأننا نحن مَنْ صنعناه وألبسناه ذاك الثوبَ, صرنا نسجدُ له, مؤمنين كلَّ الإيمانِ بقوّتِه التي اكتسبها من خوفِنا وجبننا, بأنه يخرجُ النارَ من فمِهِ ليحرقَ قرانا وأرضنا, التي أصلاً لم يبقَ فيها شيءٌ يحزنُ على زوالِه. تكلمْ وثرثرْ على الربِ, ولا تقربْ من خيال التنين.
لم نعدْ نجابه ولا نقوى إلا على أنفسِنا, تناثرتْ بركة جَدي أمامَ رياح الشحّ, صارَ لا همّ لنا إلا أنْ نصعدَ على أكتافِ بعضِنا, نشي بهذا وذاكَ, حسدٌ قاتلٌ حديثُ الولادةِ بيننا وفسادٌ استفحلَ , صارَ يرقدُ على وسائدِنا بعدَما كنا نسمعُ في الماضي عن رجالِ الدولةِ, لم يكونوا ليجرؤوا أنْ يلامسَ لسانَ أبنائِهم طعامٌ وشرابٌ ابتاعوه بمالٍ متسخ, مدُّ اليد صارَ عادة, اشتهرنا بها من دمشقَ إلى قرطبة, يضربُ بضمائرنا عرضَ الحائطِ, لنبيعَ شبابنا وكياننا من أجل حفنةٍ من دراهمَ لا تدومُ, بل تديمُ الفجوة بيننا, تطفئ الدمعَ الذي كانَ ينهمرُ من داخلِنا على ماضي الأجدادِ الذي لسنا جديرين بهِ, لا يدركونَ البعدَ الذي ترسُمه أيدٍ خفيةٌ , ليكونَ كلُّ الشعبِ مخطِئاً, ولكي لا يتعالى أحدُهم و يطلب الصلاحَ, حتى يغرسوا في عينيه ما بَلع من فتات يوماً, وتُطبّقَ كلُّ قوانين الأرضِ على رأسِه. والتنينُ يتفرّجُ, يضحكُ علينا, يعتبرنا قد خنّا القريبَ منا , ولن يستطيعَ أنْ يثقَ بنا, مثلُ الخائنِ الذي قالَ عنه (نابليون بونابرت): سرقَ المالَ من أبيه ليعطيَه بيدِه للسارقِ, فلا السارقُ يشكرُه, ولا الأبُ يغفرُ له ما اقترفتْ يداه.
مِن فعلِ أيدينا صنعْنا الهمّ, وابتلعنا العلقمَ كسيفٍ وصلَ إلى أسفلِ ظهرِنا، والهمُّ لم يتجرعْ منا, حكمنا على أنفسِنا بأنْ نكونَ بمعزلٍ عن الناجحين, أقنعنا أنفسَنا بأنّ أناملنا لا تصلحُ إلا لقطافِ الزيتونِ, وحمل لفافة التبغ، أو لسرقةِ الفتات, وأنّ الأناملَ التي رسمتْ لوحة عبادِ الشمس, نحتتْ تمثالَ موسى, ووضعتْ أحجارَ سور الصّين، هي أناملُ أناسٍ من عالمٍ آخرَ , والعقولُ التي درست الطبَّ والكيمياءَ وصنعت الثوراتِ وحركاتِ التحرر والانفتاح هي عقولٌ مستوردة, سجنا أنفسَنا في سجنِ التحسّرِ دونَ سجّانٍ, وأنّ الأوانَ قد فاتنا , وابتلعنا المفتاحُ لكي لا نرى نورَ الشّمس الساطعةِ التي تصبُّ العرقَ على جباهِ الأحرار, شُلتْ أيدينا, صارتْ هشةً, كالبركةِ الصادقةِ التي كانتْ تجمعُنا, صارتْ عاجزة عن حفر كوةٍ صغيرةٍ لينبثقَ منها شعاعُ نورٍ ضئيل على مسرحِ حياتِنا, وخرجْنا من ديارنا بكلماتِنا, ليسَ من بابٍ مفتوح أمامَنا إلا الهروبُ والهجرة.. هو الحلُّ الذي سينجينا من لهيبِ التنين الزائفِ, وأنّ الترابَ الذي نعيشُ عليهِ لا ينبتُ فيه الأبطالُ.
كنتُ أظنُّ خطأًً في بدايةِ أيام شبابي أنّ الطاقة التي بداخلي قادرةٌ على أنْ تهدَّ جداراً وتثني كومةً من الحديد، معتقداً أني سأعملُ دونَ يأسٍ لأخدمَ وطني الذي حناني له يغطي كلَّ بقاع الأرض, ولن تلهيني لقمةُ العيش عن أهدافي السامية, لكن, حدثَ عكسُ ما أريدُ, فابتعدتُ كلَّ البعد عن كلّ ما يصادفُ طريقي, لأنّ ما سأفعله ليسَ إلا صلواتٍ وثنية لا تلقى عندَ الإلهِ أيَّ حسناتٍ, ليذكرني بأني كرديٌّ, مسلوبٌ من أدنى حقوقي، سببُها حرقة كانتْ تلدغُ كبدي من أحوالِ الكردِ, تناثرُهم مثلُ غبار الطلع في الهواء, حدثَ ما يُسمّى في الفلسفةِ ردة الفعل العكسية, ونمتْ بذرة الأجداد بي, سقاها ماءُ أفعالهم وكلامهم. لا يهمني الشعارُ الثلاثي, فأنا أريدُ أنْ أشعرَ بحريتي من ذاتي, وعالم القمع لطالما ستسعى البشرية لاقتلاعِه, لأنها الطبيعة الإنسانية.
لكنها طامةٌ كبرى, إنْ شعرتُ أنّ المعظمَ صارَ يستنكرُ وجودَك, لتصبحَ محارباً دونَ أنْ تشعرَ-حتى من أقربِ الناس منكَ, ليقحموا في رأسِك أنّ الهجرة مكتوبةٌ على جبينكَ من أوّلِ يوم وطِئْتَ به هذه الدنيا, لتكونَ غريباً في الغربةِ، وغريباً في وطنكَ، وغريباً حتى في قبرك ومماتك.
شعورٌ زائفٌ ملكته عندَما كنتُ أرى (خضر) قادماً إلى المدرسة بسيارةٍ مرفهة بارحة يقودُها سائقه الخاصُّ, الدمُ يجري بينَ عينيهِ، كرشه المستديرُ, كأنّ ازدحامَ المخابز كانَ وما زالَ بسببِ التهامِهِ كلَّ رغيفٍ بطريقهِ, يتدلَّقُ كرشه على المقود، وسوارٌ من الذهب الثقيل يزينُ معصمَه، ليعبّر بكلّ الطرقِ أنّ التخمة أصابته في كلِّ شيءٍ, الأحلامُ لا مكانَ لها بينَ جدرانِ حياتهم لأنها سهلة المنال في أصعبِ الأشياءِ, وما معناها إنْ كانتْ تتحقق بلا تفاصيل باهظةٍ مثلَ التي ندفعُها ولا نبلغُ عتبة بابها.كنتُ أواسي نفسي بأني أعلوه بتفكيري ونظرتي المتفائلة لمستقبلي, أحملُ أحلاماً سأستلذُ بكفاحي لتحقيقها, أنظرُ له بشفقةٍ, تبينُ أنه كانَ شعوراً متبادلاً, وطريقُه الأقصرُ والأنفع، هو برأي المجتمع الهشّ وبرأي أبي, الأذكى والأفضل, يخدعون أنفسَهم ويخدعون حتى أحاسيسَ ألسنتهم، كانَ من دونِ المتفوقين يدبُّ الرعبُ بكلِّ الرسل, لم أكنْ أعلمُ أنّ هناكَ غيرَ اللهِ يهابُه الرسلُ, أصحابُ الرسالةِ وملقنو العلم, لكنْ كيفَ درسَ الهندسة؟ هذا ليسَ بالسرّ, يعرفه الجميعُ, بظنهم أنه مكانهم, يفعلون ما يريدون ونحن مَنْ ليسَ له مكانٌ إلا خارجَ البلادِ, أو أنْ نهتفَ لهم ونصفقَ على ما يفعلونه بنا ونرضى, معتقدين أنّ لا زوالَ لنعمتهم،كما آمنَ ( ستالين ) وظنّ ذلك (هتلر)، والعدالة الإلهية لن تصلَ لبابِ بيتهم ما دامَ أنهم يقتلعون كلَّ رأسٍ يخالفُ آراءَهم, لا يفكرون لثوانٍ, عندما نقمعُ الناسَ, لنضعَ أنفسَنا دقائقَ وننظرَ للحياةِ بعدسةِ عيونهم التي يرونَ بها العالمَ من حولهم، لنرى ما سيكونُ موقفنا وشعورَنا من أنفسِنا. القانونُ والدستورُ المقدسُ مخلوقٌ لنا وليسَ لهم, المخطِئُ يجبُ أنْ يُحاسَبَ، لا شيءَ فوقَ القانون, إلا هم، يُحاكُ كالثوبِ على حجم أردافِهم، متناسين جميعَ القوانينِ والأنظمة الوضعيّةِ والسماويّةِ التي لا تغتالُ الآمالَ. لا أنسى أستاذي عندما استرقتُ السمعَ عليه وهو يجلسُ معَ زميلِهِ، يُراقبُ مسيرةً إلزاميةً حاشدة, خرجتْ تؤيّدُ وتهتفُ، ظانّاً أنَّ المدرسة قد خلتْ، وأخذَ مجدَه في تفوهِهِ بتلك العباراتِ:
- اهتفوا. واهتفوا, باسمهِ ومجدِه. اهتفوا, تظاهروا، لأنّ النعيمَ الذي أنتم فيه سيزولُ بزوالِ هتافِكم, كسرة الخبزِ والخوفِ من الجوع هي ثمنٌ بخسٌ لوطنِكم, تناسيتم حكمةَ اللهِ أنه لم يخلقْ فماً إلا وأطعمَه، ولم يتركْ ظالماً إلا وقهرَه، ولا مظلوماً إلا ونصرَه. وعندما علمَ أني أسترقُّ السمعَ, سكتَ وابتسمَ، وما زالَ إلى يومِنا هذا عندما أراهُ مصادفةً, يبتسمُ في وجهي وأبتسمُ له, لا يعرفُ سرَّ تلك البسمةِ سوانا, إنه كانَ يعلمُ الخطيئة كالملايين غيرِه, لكنه حرمَ مثلي أنْ ينادي بها جهراً.
يقولُ غاندي: لا يستطيعونَ أنْ ينتزعوا منا احترامَنا لأنفسِنا ما لم نتنازلْ لهم عنه, إنّ موافقتنا على ما يحدثُ لنا وسماحَنا به هو الذي يؤذينا أكثرَ بكثير مما يحدثُ لنا.
الفصل الثاني
قطعتْ أفكاري طرقةٌ على البابِ. مثلما تقطعُ زخاتُ المطر صفوةَ رسّامٍ في الطبيعةِ, فخيرُها هو كرسامٍ يحبُّ المطرَ ويعشقُه، وشرُّها أنّ لوحته إذا تركَها تتحولُ بلمساتِ الطبيعةِ إلى لوحةٍ تشكيليةٍ, تجريديةٍ, مثلي تماماً, أردتها أنْ تأتيَ ولا تأتي, كانتْ أمّي تلبسُ زِيَّ صلاتها, شالُها الأبيضُ المسدلُ أكثرُ من حدودِ كتفيها. لا رابطةَ قوية بينَنا, ربما لأني أفرغتُ نهرَ حناني في بحرٍ آخرَ, عوضتُ عن حنانها بهواءٍ عميقٍ أستنشقه من عبقِ طفولتي, بعدَما لمستُ بأنها لن تستطيعَ كباقي الأمهاتِ أنْ تفهمَني, ربما كانَ شعوراً فلسفيّاً دراماتيكيّاً بأنها هي من جاءَتْ بي لهذهِ الدنيا.
دلفتْ لتبلغني بأنّ الساعة أصبحتْ السابعة, حاولتْ إيقاظي بعدَ الفجر لكني لم أستيقظ, فقلتُ لها:
- طالما تأخرتُ دعيني أنمْ قليلاً وسأستيقظ بنفسي. فعادتْ وأعادتْ قولها:
- بنيّ إذا تركتُكَ أعرفُ أنكَ لن تنهضَ, ستعودُ للنظر للأعلى مثل عادتِكَ وتسرحُ بخيالِكَ للأفق. وتلفظتْ بتلك المقولةِ التي مراراً ما تذكّرَها، ذلك المثلُ الكردي.. فحواه أنّ " الفلاحَ ينامُ بينَ روثِ الخيل ويحلمُ بإسطنبول "
خرجتْ من عيوني نظرة تمادتْ بالقسوةِ عليها, انقبضتْ على تمردها, أرغمتْ هذا العقلَ على أنْ يُسبلَ تلك العيونَ بنظرةِ عطفٍ إلى مَنْ فتحَ برمشِها للدنيا، وليس ذنبُ الأمِ القسوة التي بها, تركتُ تلك العيونَ تخاطبُ عظمتَها التي ستفوتني ببعدِي عنها.
أي إسطنبول؟. يا أمّي ليتكِ تعرفينَ, يا مَنْ لم ترأفي بحالي, كنتِ دائماً تذكرينني بفشلي وعدم إتمامِ دراستي, كنتم دائماً تلقونَ بخيوطِ الملامةِ والحرقةِ من أيّ شيءٍ على شواطئ أحزاني, كم حاولتُ الحوارَ معكم؟ كم جاهدتُ في سبيل إفهامِكم أني وهمومي و أحزاني أكبرُ من الذي يجولُ في بالِكم؟ تعتقدونَ أني سأهدمُ البيتَ على رؤوسِكم. وهل بقي بيتٌ في الوطن عامر، و لم يُهدمْ, إلا بيوتَ العناكبِ والدبابير؟. وحسبُكم الهدمُ والردم.
ليتكِ تفهمين يا أمي بأني رفضتُ أنْ أدرسَ تاريخاً مزيفاً, قد كتبوه كما مالَ بهم هواهم، لقد أبيتُ. ما أذكره أنه أولُ رفضٍ لي, أنْ أحفظ خطاباتٍ وشعاراتٍ وأقوالاً خالدة أكثرَ من حفظي لكلام الإلهِ سُبحانه, لم أكملْ تعليمي لكي لا يحشوا عقلاً كانَ بكراً في حينهِ. قررتُ أنْ أنهلَ من العلم الذي لا ينتهي في بحار الدنيا عندَ حدٍّ, أقرأ ما أريدُ وقتما أريد, أعلّمُ نفسي وأولادي تاريخَ الكرد. لن أناقشَكِ يا أمي بأنّ البطلَ (سليمان الحلبي ) هو سليمان محمد أمين أوس قوبار, كردي من قرى عفرين، نسبوه وأسموه مثلما أرادوا مثل الآلاف غيره, ( عبد الرحمن الكواكبي ) أيضاً من ملتنا, ذكر كثيراً وأفردَ طويلاً عن الاستبدادِ والظلم, ولن أخيّبَ ظنّكِ بمثلكِ الأعلى بإسطنبول وقادتها الذين كانتْ ستكسرُ شوكتهم, عندما أعلنتْ بريطانيا في الخامسِ من نوفمبر سنة 1914رسميّاً الحربَ على تركيا واحتلت البصرة في 22من ذلك الشهر. إنه تاريخٌ لا أنساه يا أمي, عرفته وأنا في عمر التاسعة, حفرَ كعمقِ البئر في أعماقي,كيفَ أنّ القبائلَ الكردية تصدتْ للإنجليز قبلَ أنْ تصلَ إلى حدودِ لواء الكوت.كانَ يقودُ الجيوشَ الكردية الشيخ ( محمود البرزنجي ) قُتلَ واستشهدَ العديدُ من الأكراد البارزين مثل رشيد باشا من السليمانية وغيرِهِ كثيرين.
حاربوا الإنجليز ليزيدوا حقدَهم حقداً, لأنّ جدَّنا صلاح الدين, ومازالتْ جراحُهم لم تندملْ, عندما أوقفَ أطماعَ الإمبراطورية الأوروبية تحتَ غطاءِ المسيحية لتتمَّ تصفيةُ الحضارةِ العربية والإسلامية من كلِّ القيم التاريخية, فعلوا وانتقموا وقسّموا بهدية كبرى لنا دونَ وطن, ولتلك الدول التي دافعْنا عنها و ذرفت دماءُ أجدادِنا على مشارفِها, أنها اقتسمتْ زادَنا وبقاءَنا, وهبنا لهم سلاحاً بيدِهم ضدّ بعضِهم بعضاً, ونحن عندما نطلبُ أدنى حقٍّ لنا تتحدُّ كلُّ تلك الدولِ والشرقِ بأكملِه ضدنا, يشتمون ويهتكون عرضَ وطولَ الحدودِ ولا يعترفون بما صنعه الاستعمارُ, عندما يكون الشأنُ خاصاً بهم, وعندما يكونُ الشأنُ عن الأكراد تصبحُ الحدودُ منـزَّلةً ومقدَّسة من آلهةٍ جليلةٍ ومبجّلة..
لا يا أمي لا أنظرُ إليك لأودّعك، لكني أخاطبك من قلبي لتتركيني بهمي. الذي لا أعرفُ هل حملته اختياراً أم اضطراراً. رجعت للحديثِ معي. ربما ظهرتْ عليّ معالمُ الحدّةِ وهدأتْ. كبركانٍ ثارَ وانفجرَ داخلَ نفسِه، حتى سكان القرية الذين يقطنون على سفحِه لم يغادروا البتة. تمتمتْ وهي تُمسكُ سبحتها الخشبية التي طالما حلمتُ بأنْ أستبدلَ بها أخرى من الأحجار الكريمة, أقلّ ذكرى من ولدِها الذي سيرحلُ عنها في أزقة الغد المجهولة. طقطقة حباتها تصدرُ رنيناً كموسيقا الطفل الإلهيّ موزارت لطالما حُببَ إلى سمعي صوتها.
- هذا كلامُك بأنك تحبُّ الذهابَ للقرية والجوُّ باكرٌ وممطرٌ, اليوم هو مرادُك, هيا. هيا انهضْ وكفى لذهنكَ أحلاماً.
- لا بأس أمي أعطيني بعضَ الوقت، واذهبي للنوم، لم تنامي بعدَ الفجر.
رحلتْ وغادرتْ ولحقها تأملٌ مني وراءَها, لأنها تعرفُ أنّ ثالثَ مطلبها سيكونُ جدالاً. فقبضت على لحافي القطني الذي اخترقَ رأسي عبقُ رائحتهِ القروية, كأني أعيشُ الفصولَ الأربعة في اللحظةِ ذاتها ولففته حولَ رأسي, تعرى أسفل جسدي, كمستاءٍ جدّاً من نفسِه, أطفأتُ المذياعَ بحركةٍ من أطرافِ أصابع قدمي وعدتُ لخيالي. لكنْ هذه المرة ليسَ لجدي. إنما إلى شيروان الكردي. (كروبيون). رجلٌ من صلبِ ثنايا الجبال, لم أستطعْ في ليل البارحة البارد الكئيب أنْ أستغلَّ سكونَه لأعيدَ ترتيبَ الكلماتِ التائهة التي كانتْ في لقائِنا, جمعت ثلاثي المآسي على طاولةٍ نحاسية مستديرة.
هذا الذي لبسَ تاجَ فرعون وثوبَ موسى في آنٍ واحد, وجمعَ بينَ نسماتِ فكره وعقله الدهاء والتحرر, مزجَ في كأس حياتِه الحكمة والبوذية والليبرالية ومعاني سامية عن حبّ السلام والإسلام, وإيمانهِ الراسخ بحوار الأديان, وطنيته، اعتزازه الذي لم أرَ له مثيلاً في العصور وكتبِ التاريخ القديمة والحديثة, عاشَ في جسدِه وذهنه كلّ نقيضٍ في هذه الدنيا, لأنّ ما كان يشغله كيفَ يجعلُ شعوبَ العالم تتلاحمُ بمحبةٍ وسلام, دونَ أحقادٍ وكراهية, أحلامُه أكبرُ منه, فكرة اقتناعِه بأنّ السلامَ صعبٌ أنْ يعمَّ بينَ شعبين تقاتلا وسالتْ دماءُ كليهما، كانتْ صعبة, ربما كانَ يظنُّ أنّ الناسَ يحبون ويعشقون السلامَ مثله. لأنه تناسى آلامَه وآلامَ أجداده وتخلى عن أيّ مطلبٍ وثأر, وحلمَ ورضيَ بحياةٍ بسيطةٍ تسودُها الحرية وأجزاءٌ لا تذكر من حقوقهِ، ليقنعَ غيرَه بأنه راضٍ عن أيّ شيءٍ رغم كلّ شيءٍ, لكنْ حتى تلك التي تُسمى أيّ شيء احتاجتْ لانضمامه لنا, لكي يسعى في أنْ يحصلَ مثلنا على أدنى وجودٍ له..
تُذكرني تقاطيعُ وجهِه, حزنُ عينيه, شعرُه الطويلُ الذي يجاهدُ ليصلَ لأكتافهِ, لحيته الكثة بخيال المسيح الذي تناثرتْ صورُه داخلَ الكنيسة, يوم تجمعنا بها في إحدى القرى النائية ووارينا بها الثرى صديق أبي رحمه الله أبا يعرب.
لاقيته في دمشق البارحة, كنتُ هناك لأنهي أوراقَ السفر, لأودّعَ شوارعَها وحواريها, أصدقاءَ الجيش الذي قطفَ من زهرة شبابي عنوةً قرابة ثلاث سنوات. عندما بدأتُ لم أكن لأتخيل أبداً أنه سيأتي يومٌ أنهي فيه خدمتي, وأزور دمشقَ مودعاً وأرحل عنها كما الذي يعودُ محبطاً من الحربِ قاتلَ ودافعَ ورمى بكلّ ثقل جسدِه, ثم تعودُ له قرابينه خاسئة مرفوضة، ويُتوّجُ غيرُه بأوسمةِ النصر رغم أنه لم يسمعْ عن تلك المعركة لكنه حظي بحبٍّ واحتضانٍ لا مثيلَ لهما, عين في وظيفةٍ من تلك الوظائف التي خصصتْ للذين عناهم جدي, لم يعرقوا.
كما قالَ لي العمّ (حميد) ابن عم أبي وهو يضعُ داخلَ يدي نقوداً أسعفتني تلك الأيام حينما قابلته في أحدِ الأحياء مصادفةً في دمشقَ, وأنا لا أملكُ قرشاً واحداً, جائعاً, حائراً، ما كنتُ أملكه أملي بالله الذي قادني بإلهامِه أنْ أمشي في شوارع لا أدري أين تقودني, إلى أين ستوصلني، ربما إلى رحمة الله التي تجلتْ بشخص العمّ حميد ( أبي رشيد) ودونَ أنْ أطلبَ منه أعطاني ما أبتغيه ويفيض, وهو يقول لي:
- لا يدومُ إلا وجهُ الله, كلّ شيءٍ إلى زوال, ستنهي الخدمة وتجد هذه الأيام صارتْ من الماضي.كانَ كلامُه زبد الصواب, أنهيتُ خدمة الجيش, لكن, لم أستطعْ أنْ أنهي كلامي معَه وأجتمعَ به ثانية بموعدٍ أو مصادفةً, لأنّ لقاءَه صارَ أبعدَ من حلم, لكنْ, كنتُ شديدَ الحرص على أنْ لا أنسى ذاكَ المعروفَ الذي زرعه معي، وأحرص كلما ذهبتُ لزيارة أبيه (بافيه خالوه) أن أعطيه ما يقدرني الله عليه جزءاً من ردِّ الجميل, لأنّ الإنسانَ أحياناً يشعرُ بأنه عاجزٌ أمامَ فعل مهما يكنْ بسيطاً لم يلقه من أقربِ الناس منه, لأنه أعطي بسخاءٍ من شخصٍ هو بأمس الحاجة لما عندَه, رغم علمي بأحوالهِ, لكنه لم يترددْ أنْ يقدمَ لي العونَ الذي تجلى بالعطاءِ الحقيقيّ منه, هو عينه الذي قصدَه جبران وقال عنه: (جميلٌ أنْ تعطي مَن يسألك, وأجمل منه أن تعطي من لا يسألك وقد أدركتَ عوزَه).
تلك كقصة الكُرد-لم يلتمسوا العطاءَ حتى من أقربِ الناس منهم, لو أعطوا لكانوا دونَ أدنى شكٍّ مثلي لا ينسون العطاءَ، وإنْ كانَ ذاك العطاءُ الذي سيهبونه لهم ليسَ مما يحتاجونه كما حاجة العمّ حميد لما أعطاني إياه, إنه عطاءٌ من كنوزنا وحقوقِنا ولا نملك إلا كلمة شكرٍ لنقولها, والتي حرمتني الدنيا من ذكرها للعمّ حميد.. لأنه انتهى هو من هذه الضوضاء, رقدَ بسلامٍ فجأة, مبكراً مثلَ العم ( أبي يعرب )..والخال (عبدالله).. وجَدي, كُثر كانوا مَن أخذهم الموتُ, انتزعهم من فم الحياة وهم في عز عطائِهم, ومطرقة العطاء التي ينهالُ بها الحدادُ ليكسبَ عيشه ما زالتْ بيدهم..
كنتُ في طفولتي أحملُ شبقَ التعلق بهم, أحاورُ دائماً نفسي, سيأتي اليومُ الذي أحادثهم بعدما أكونُ نضجتُ وأصبحتُ يافعاً بنظرهم, لأتذكرَ معَهم بعضَ العبارات والأحداث التي مرّتْ علينا, سيكونُ الشيبُ بدا على فروة رؤوسِهم, لكنْ, حتى الشيب استكثرَ أنْ يطولَ بقاؤه عليهم, كم كنتُ تواقاً في صغري للحديث معهم, كم تعلمتُ من حديثهم وصمتهم الكثيرَ وفاتني الأكثرُ منه, لكنّ الزمنَ لا ينتظرُ الأماني والأحلامَ, لا كبيرَ معَ الموت, إنّ الإنسانَ مردُّه إلى مَنْ فطرَه, رحمهم الله. ذهب كل في طريقه, كان آخر مكان أجاهد وألهث لأصل له ذاك القبر الذي نُصب من عبق تراب وصخرتين ترسم مسقط الرأس ونهاية خطوط الأقدام التي جالت الدنيا بنقطةٍ من حلوها وجبلٍ من مرها, الذي قادهم للجنة ونعيمها, وأنا لجهنم التي على الأرض, تركوا شوكةً في القلب لتعصر مر الحياة دون سبب ٍعلى كل برعم ٍ يحاول الانشقاق.
إنَّه قطارُ الحياة يمشي دونما توقفٍ, لا بدّ لكل واحدٍ أنْ ينـزلَ منه, لا بدّ من وصولك إلى المحطة المعيّنة لنـزولك, سينـزلُ غيرُك في محطةٍ أخرى, منهم مَن نزلوا قبلك, لا تستطيعُ أنْ تختارَ متى ومعَ مَن ستنـزل, لتلوّحَ بيدك لجموع الناس الغفيرة ممن ظلّوا في القطار, تودعهم, تذوبُ وسط الزحام, بانتظار الحشر, معَ حزنٍ يبدأ كبيراً داخلَ أعماق محبيك، ثم ما يلبثُ أنْ يصغرَ شيئاً فشيئاً, مثل تلال القرية التي تبتعدُ وتتضاءلُ عندما نغادرُها قاصدين المدينة..
" إنّ سرّ الحياة والموت كانَ ولا يزالُ وسيبقى بيدِ الله, هذه حقيقة, لا تشوبها شائبة ". ألم ترَ أنك تُلف بقماط أبيضَ لحظة ميلادك, وتُلفّ بكفنٍ أبيضَ مثله عند الممات؟ ستجدُ بعدها أنّ الحياة كلها ما هي إلا لحظاتٌ، بضعُ لحظاتٍ آنَ لها أنْ تتبخر.
لم أكنْ أرغبُ في أنْ أترجلَ من القطار دونَ أنْ أعطي للدنيا ولنفسي حقَّها, أنْ أنتزعَه من فم الحياة أو أنْ تنتزعَه الحياة مني لا فرق, آمالي كأيةِ آمال, وأبنائي يجبُ أنْ يكونوا كأي أبناء, عالمٌ كبير يحيط بنا, آفاقٌ نيرة وأخرى مظلمة. عظماء, رؤساء, سلاطين, ملوك،رحلوا، ترجَّلوا من القطار. يُذكر حسنُ فعل بعضهم ويذكر ظلمُ وقبحُ أغلبهم, سجل العمر فيه صفحات يجبُ أنْ تُملأ, أهداف يجبُ أنْ تقطف. ثمة رجال خُلقوا لتُزرع قاماتهم في جبال الصعاب, ما دفعني أنْ أنشئ جمعية (الحزام) لخدمةِ الكرد والإنسانية, والحياة ليستْ إلا أمانة في أعناقنا سنسألُ فيمَ أضعناها إنْ كانَ خيراً لنا ولأبنائنا وإن شرّاً لنا ولأبنائِنا ولعذابنا.
جلستُ مع (شيروان) في مقهى النوفرة, في دمشق العتيقة, كنتُ جديدَ العهد مع الغليون الذي لم أكن أظهره للناس والملأ إلا بعدَ تحرري من العبودية, أظهرته برأيي شعاراً خاصّاً يعبرُ عن جزءٍ مفقود من الحرية, أشعلته ودخانه شكلَ غيمةً وهمية من عبقه، تلاشتْ بسرعة في الهواء, اختفتْ في المجهول كما ضاعتْ نفسي بعدَها في حواشي الغيوم.
جلسَ كعادته السيئة, يلاعبُ لحيته الكثيفة, يستنشقُ من أنفه ليشتمَّ رائحة التبغ التي كانتْ تحلو له من غليوني, والهواءُ يدفعُ بها لترتطمَ بقاياها بوجهِه الصبور, زيّنَ عنقه بسلسلةٍ فضية, وضعَ فيها حرفَ الكاف باللاتينية لتدلَّ على (كردستان) لأنّ ذلك أقصى درجة من الحرية المخفاة التي نمنحها لأنفسِنا, حتى لو علموا ما يرمزُ له ذاك الحرفُ الوحيد لاقتيد وزجَّ به في السّجن.
ينظرُ إلي باستغرابٍ, غيرَ مصدقٍ أني أنهيتُ خدمتي وسأرحلُ بعدَ عدةِ أيام إلى الخليج, كانَ يعتبرُها مزحة مني لأني كنتُ كثيرَ التذمّر عليه, وعلى الإخوة في الآونةِ الأخيرة, كنتُ أطلقُ دائماً عباراتِ التهديد بالانسحاب والتخلي عن كلّ شيءٍ إذا ظلّ تقدمُهم كالسلحفاة, لكنه أيقنَ عندما رأى التأشيرة ألصقتْ على جواز السفر أنّ الموضوعَ خرجَ من قدم السخرية، وتدحرجَ إلى ملعب الجدية, ما ينقصُه صافرة البداية التي ستربكه.
تأهبَ للحديث ومن ثم ضجّ. اتسعتْ قزحيتا عينيه, التقط أنفاسَه, كأنه مصارعُ ثيران يريدُ أنْ يجمعَ قواه في شهيقه, ثم أخرجه بقوّةٍ عارمة لدرجة أني شعرتُ برائحةِ نفَسِه المخلوط معَ عطره.
- أين ستذهبُ ؟ ولماذا؟
- إلى بلاد اللهِ الرحبة. إلى البلاد المقدسة.
- وأحلامك؟. وآمالك؟
كم كنتُ أبله عندما أخفيتُ عليه وآثرتُ ألا أقولَ تلك الحقيقة التي كانت السببَ الرئيسَ وراءَ سفري, وأنّ الحبلَ الذي مددته بيني وبينَ الوسيط مع النظام ( أبي مهران ) التفَّ حولَ عنقي, فهمتُ منه في لقائنا الأخير: اخرج من البلاد سالماً قبلَ أنْ يصيبَ عائلتك أيُّ مكروه, تلك الرسالة,كانت الجوابَ الذي وصلني عندما طلبتُ بكلّ وضوحٍ مقرّاً تدريجيّاً لجمعيتنا, نسي كيفَ أنه حبك مَكرَهُ وتظاهرَ بالتأييد والرضا في البدء, وأخذ يفردُ لي ويلهجُ بحمدِ الكرد, أنّ رؤساء سوريا السابقين (أديب الشيشكلي) و(حسن الزعيم) و(فوزي سلو) هم أكراد, وأنه كانَ معجباً بالزعيم (كمال جنبلاط) ذي الأصول الكردية, وتحدثَ مطولاً عن حرب تشرين التحريرية عندما استخدمَ الجيشُ السوري للتحدث في اللاسلكي اللغة الكردية في الجبهة, حتى لا تلتقط الرادارات ولا يقدر العدو على فهمهم, وأنّ أولَ طلقة كانت ضدّ الاستعمار الفرنسي كانتْ من المناضل الكردي ( محمد أيبو ) من منطقة عفرين. ظلَّ يحفرُ لي إلى أنْ أمسك بخناقي وشد الاعتراف من لساني عمَّا يجولُ في قلبي, سياسة سافلة جوفاء.
التعليق
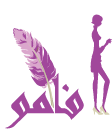

 من نحن
من نحن أشواك الورد
أشواك الورد قصاصات.كوم
قصاصات.كوم متابعات
متابعات فضاء للبوح
فضاء للبوح سرديات
سرديات قصائد
قصائد آراء حرة
آراء حرة في المرآة
في المرآة الأسوأ
الأسوأ دليل فامو
دليل فامو Boutique FaMoh
Boutique FaMoh Café FaMoh
Café FaMoh إتصل بنا
إتصل بنا