سرديات عودة
فصلٌ من سيرة لا تهمُّ أحداً للكاتب اليمني عبدالمجيد التركي (الأربعاء 26 شباط 2014)
ها أنا أجرجر خلفي 37 عاماً من الهزائم والانكسارات.. وبعضَ ذكرياتٍ من الطفولة لا تصلح أن تكون ذكريات.. الدُّمى حافلة بالذكريات أكثر مني..
ليس هناك شيء يستحق الالتفات إليه.. حياة اعتيادية، رغم أني أراها مرعبة بيني وبين نفسي، وما زلتُ مصراً على البقاء في مرحلة الطفولة.. ما زلت أحتفظ بدراجتي الصغيرة وجزء عمّ، وبعض الملابس التي لا أصدق أنها كانت تتسع لي.. ما زلت أحتفظ بروشتة كتبها لي الطبيب، وكم شعرت بالزهو حينها، لأن يد الطبيب كانت أول يد أراها تكتب اسمي.. شعرتُ أنني مهمٌّ جداً، وأن هناك من يقتطع من وقته 15 ثانية لكتابة اسمي.
حين شربتُ لأول مرة زجاجة كوكاكولا- كاملة- أحسستُ أنني رجل كبير، وأن بإمكاني أن أتصرَّف كرجل راشد، وكأن زجاجة البيبسي هي المعيار لدخول عالم الكبار.. وحين تمكَّنت من قيادة الدراجة لأول مرة كنت أوقن أنني قادر على تحريك الأرض بعجلة واحدة.
دخَّنت أول سيجارة في طفولتي لأنني مللتُ من التصرُّف كولد صغير، ولأجرِّب معنى أن أكون رجلاً.. وإلى الآن لم أصل إلى هذا المعنى البعيد.. فطويتُ سنوات كثيرة من البراءة بتدخين سيجارة واحدة بداخل المسجد الذي لم يكن به سوى ولد شقي، وسيجارة راشدة، وثالثهما الشيطان الذي ظننتُه العبد الصالح وهو يمدُّ لي بالولَّاعة.
لم يكن الشيطان إلا أنا في سنٍّ متقدمة، ولم يكن ذلك الطفل- الذي لم يجد مكاناً أكثر أماناً من المسجد ليدخِّن فيه عشر سنوات من البراءة- سواي.
لم يكن لديَّ ألعاب كثيرة، فقد كانت كلُّ ألعابنا مجانية.. نرسم في الشارع مربَّعات بالفحم لنتقافز بداخلها، أو نصنع سيوفاً خشبية لنحارب الكفَّار في الحارة المجاورة..
وكنتُ أنا الوحيد الذي أربط إحدى عينيَّ بخرقة سوداء، فقد كانت تستهويني فكرة أن أصبح قرصاناً بعين واحدة وساق خشبية!!
الآن في السابعة والثلاثين وأشعر أنني كبيتٍ قديم يتداعى.. نوافذ كثيرة لم تعد تنفتح بداخلي، حتى باب بيتنا القديم الذي كنتُ أدفعه بيديَّ الصغيرتين ما زلت أحمله، لكنه أصبح مغلقاً ولم يعد يحتمل الدخول والخروج، لأنه لم يعد قادراً على إصدار تلك الأصوات المرعبة التي كان جدي يُسكتها بقليل من السمن البلدي، وكأنه كان يضع نذوراً لهذا الباب المسكون بأصوات كان يفشل في تقليدها.
أصبحنا نبتهج بالتهاني بعيد الميلاد حتى وإن كان المقابل سنة كاملة، ندفعها للحصول على تهنئة، فكيف نهنئ بعضنا بضياع سنة لنقترب أكثر من الموت!!
الحياة ضربٌ من العبث.. لذلك كنت أحفر اسمي على الصخور، وكأنه تعويذة سيحميها من غوائل الكسَّارات ومطارق البنَّائين.. لكن الديناميت كان أقوى من اسمي المحفور، لذلك آمنتُ أن لكلِّ شيء نهاية.
***
سمحتُ للبعوض أن يقرصني كثيراً.. لا لشيء إلَّا ليتوزَّع دمي بين القبائل، ولأشعر بالتواجد في كلِّ مكان حين يأخذ البعوض قطرة من دمي ويطير.. لم تكن لديَّ البصيرة الكافية لأرى هل كان البعوض يتجشَّأ بعد تلك القطرة أم أنه كان يبصقها لأن فصيلة دمي لا تناسبه!!
تمنَّيتُ كثيراً أن أصبح شخصية كرتونية لأتزوَّج بالليدي أوسكار، وأحمل سيفها لأرى إن كان سيلمع في يدي، ولألمس جاكيتها الأبيض، فقد كنتُ أحلم أن أمتلك مثله في يومٍ ما.. وفي الرابعة والثلاثين توقفت تماماً عن ارتداء أي جاكيت، فقد تصالحت مع الـ نص كُمّْ، وأصبحت نصف يدي محروقة من الشمس، لذلك أحبُّ أن أتعامل معها على أنها يد شخص آخر ما دام لونها مختلفاً عن بقية جسدي.
فرحتُ بالدراجة الصغيرة أكثر من فرحتي بشراء سيارة بآلاف الدولارات.. لماذا كلَّما كبرنا تصغر الفرحة.. كم من الحزن يلزمنا لنفقد فرحتنا بكل شيء!!
***
أكتب الآن وبداخلي رجلٌ ثمانينيٌّ يدخِّن سيجارة طويلة بأصابع مرتعشة وفم خاوٍ يتذكَّر بداية معرفته بأسنانه الَّلبنيَّة.. كغريق يحاول أن يتذكَّر كلَّ شيء، وهو يعلم أن الوقت المتبقي لديه ليس كافياً لأخذ نفس طويل، كي لا يموت وهو يلهث.. وليس كافياً لخلع ملابسه ليلقى الله متخفِّفاً من كلِّ شيء.
هذا الرجل الذي أحمله بداخلي يتوقَّف لألحق به وأصبح من أترابه..
يريدني أن أتقمَّص شخصيته وأسعل كثيراً مثله، وأخبّئ البلغَمَ في منديل قطنيّ كبير، كمنديل حسن عابدين الذي كان يمسح به صلعته وهو على خشبة المسرح..
***
في بداية الأمر كانت تستهويني ساعة الجيب التي يتم تعليقها في الصدر، كنت أرى الارستقراطيين الطليان والإنجليز يخرجونها من جيوبهم- في الأفلام- والغليون في اليد الأخرى.. تمنيت كثيراً لو أنني أنتمي لتلك العصور، وأرتدي قبعة وبنطالاً عريضاً، وأمشي ببطنٍ مترهِّلة وشارب عريض أبيض لأجلس على أحد الكراسي الطويلة التي تنتصب في الحانات أمام المشرب، لأطلب من النادل كأس مارتيني بالتفاح، ثم أضع على طاولته ورقة نقدية كبيرة تتسع لكرمي وأنصرف دون أن آخذ الباقي.
كانت أحلامي واسعة.. العيش بتلك الطريقة مريح ودون تكلفة.. والأفلام الأمريكية تضيف أفقاً أوسع للهرب من الآفاق الضيقة التي ندور في أفلاكها..
وحين تضيق أكثر، أبتسم لنفسي ابتسامة زائفة تشبه ابتسامة فتاة معجون الأسنان..
أحتاج أحياناً كثيرة لهذا الزيف، وأفرح به كما يفرح المتسوِّل بورقة نقدية زائفة..
***
كثيراً ما حلمتُ أن أكون سائق شاحنة.. وكثيراً ما كنتُ أتخيَّلُ أصحابَ الشاحنات الثَّملين في الطريق ما بين فلوريدا والولاية المجاورة لها.. حين توقفه فتاة حسناء وتشير إليه بكُنزتها فيرفض أن يتوقف لها.. ثم يخرج لها يده من النافذة ويرفع لها أصبعه!!
يعتدلُ في جلسته ويصلحُ قبَّعته ويمسح شاربه الأصفر من الخمر المنسكب عليه.. ثم يتحسَّس خاصرته جيداً ليتأكد أن مسدسه- أبو عجلة- ما زال في مكانه..
يتوقَّف عند محطة البنزين ليملأ شاحنته.. ثم ينزل إلى الحانة ليشرب كأساً من المارتيني بالتفاح.. يلتفت فيرى الحسناء ترفع له أصبعها من نافذة سيارة "جغوار"..
يخرج مسدسه من النافذة ويطلق طلقة واحدة ويُـتبعها بشتيمة كبيرة.. كم أغرته هذه الأصبع البيضاء التي رآها عن قرب.
هكذا هو سائق الشاحنة.. يبصقُ على المرآة ليمسحها، ثم يبتسم لنفسه في المرآة عند كلِّ منعطف.. ولا بدَّ أن يكون حذاؤه إلى نصف ساقه.. ولا بد أن يربطَ عنقَه بوشاحٍ بُنِّي اللَّون.. ولا بد أن تكون كلُّ احتياجاته مرميَّة خلف المقعد بعشوائية.. ويكون هناك مسدس احتياطي في دُرج السيارة، إلى جانب صندوق الإسعافات الأولية.
وحين تتعطَّل شاحنته سينزل ويركلُها بقدمه.. وربما أطلق عليها رصاصةً من مسدسه الذي لم يعد يستخدمه في لُعبة الروليت.
يصلُ هذا السائقُ المتهوِّر إلى منعطفٍ خطير.. وهو يعبُّ قارورته التي يدخلها إلى نصفها في فمه.. يقطعُ عليه الطريق كنغرٌ صغير.. يدهسه بالعجلات الخلفية ويخرج رأسه من النافذة ليبصق عليه ويشتُم أمَّه التي تقف على حافة الطريق وهي تصرخ.. ويستمرّ في شتم الكنغر إلى سابع جد.
أبحث عن نهاية لمشوار هذا السائق، فأخترعُ طاحونةً تلوِّحُ له من بعيد.. وهو يفرك عينيه كما لو أنه استيقظ من نومه..
تحت تلك الطاحونة كان يدفن السجائر التي كان يدخنها خفيةً عن أمِّه الراهبة، التي فشلت في جعله يحبّ الكنيسة ليصبح قِسَّاً كبيراً...
فقد كان يرى أن الحانة تتَّسعُ له أكثر من الكنيسة التي كانت تحاصره بتعليماتها المزعجة.
***
تمنيتُ أن أصبح كائناً كرتونياً مثل "كعكي".. هذا الوغد كان يتعبني جداً، وأنا أنتظر إطلالته في مسلسل "افتح يا سمسم"..
استمتاعه بأكل البسكويت، الذي كان يذهب معظمه في الهواء وهو يقضمه.. كان يجعلني أتساءل: ما هي نوعية البسكويت الذي يأكله كعكي، ومن أين يحصل على ثمن كلِّ هذا البسكويت.. فأحسده كثيراً لأنه كائنٌ بسكويتي، وأتغاضى عن صوته البشع..
كنتُ أحبُّ بسكويت فارليز، وأيضاً كنت أحبُّ سيريلاك.. إلى أن شارفت على سن المراهقة التي لم أكن أشعر فيها بأي إرهاق على الإطلاق..
في مطار دبي رأيت بسكويت فارليز.. أخذت علبةً.. دفعت ثمنها للرجل الهندي الذي لن يعرف ماذا يعني فارليز.. ربما أن طعم الفارليز باللغة الهندية سيحتاج إلى ترجمة لكل حبة سُكَّر.. لم أكن أبالي بنظرات الهندي وهو يتفحَّصني باحثاً عن ولد صغير في يدي.. وكأنه بالضرورة أن يكون الفارليز للأطفال فقط؟
كدت أسأله عن الـ سينالكو الأصفر.. لم نكن نسمِّيه برتقال، كنا نسميه أصفر، حسب لونه فقط، وليس حسب طعمه.. وأسأله عن لُبان "فلونة".. وعن ويفر تي شوب، وعن بسكويت جلوكوز.. وبسكويت الأفراح.. وأيضاً عن الـ شونجم أبو أربع حبات.. لم نكن نضطر أن نسميه شونجم أصلي، لأنه لم يكن هناك تقليد.. كان لكلِّ شيء نكهة جميلة.. حتى مسَّاحات الأقلام الرصاص كان لها رائحة مغرية.. وكنا نستنشقها بقوة كما يفعل المدمنون اليوم حين يشمُّون الشَّلَك والتينار.. والبعض كان يأكل هذه المسَّاحات حين يعجز عن مقاومة رائحتها.
حلمت كثيراً أن أصبح شخصية كرتونية وأعيش بداخل مسلسل للأطفال.. حاولتُ إنقاذ سالي كثيراً.. وبحثتُ مع ببيرو عن أبيه الذي اختفى خلف جبال الأولدرادو وهو يبحث عن الذهب.. وفي اليوم التالي أفتح التلفزيون وأتوقع أن أجد ببيرو ممتناً لأني أساعده في العثور على والده..
التعليق
ها أنا أجرجر خلفي 37 عاماً من الهزائم والانكسارات.. وبعضَ ذكرياتٍ من الطفولة لا تصلح أن تكون ذكريات.. الدُّمى حافلة بالذكريات أكثر مني..
ليس هناك شيء يستحق الالتفات إليه.. حياة اعتيادية، رغم أني أراها مرعبة بيني وبين نفسي، وما زلتُ مصراً على البقاء في مرحلة الطفولة.. ما زلت أحتفظ بدراجتي الصغيرة وجزء عمّ، وبعض الملابس التي لا أصدق أنها كانت تتسع لي.. ما زلت أحتفظ بروشتة كتبها لي الطبيب، وكم شعرت بالزهو حينها، لأن يد الطبيب كانت أول يد أراها تكتب اسمي.. شعرتُ أنني مهمٌّ جداً، وأن هناك من يقتطع من وقته 15 ثانية لكتابة اسمي.
حين شربتُ لأول مرة زجاجة كوكاكولا- كاملة- أحسستُ أنني رجل كبير، وأن بإمكاني أن أتصرَّف كرجل راشد، وكأن زجاجة البيبسي هي المعيار لدخول عالم الكبار.. وحين تمكَّنت من قيادة الدراجة لأول مرة كنت أوقن أنني قادر على تحريك الأرض بعجلة واحدة.
دخَّنت أول سيجارة في طفولتي لأنني مللتُ من التصرُّف كولد صغير، ولأجرِّب معنى أن أكون رجلاً.. وإلى الآن لم أصل إلى هذا المعنى البعيد.. فطويتُ سنوات كثيرة من البراءة بتدخين سيجارة واحدة بداخل المسجد الذي لم يكن به سوى ولد شقي، وسيجارة راشدة، وثالثهما الشيطان الذي ظننتُه العبد الصالح وهو يمدُّ لي بالولَّاعة.
لم يكن الشيطان إلا أنا في سنٍّ متقدمة، ولم يكن ذلك الطفل- الذي لم يجد مكاناً أكثر أماناً من المسجد ليدخِّن فيه عشر سنوات من البراءة- سواي.
لم يكن لديَّ ألعاب كثيرة، فقد كانت كلُّ ألعابنا مجانية.. نرسم في الشارع مربَّعات بالفحم لنتقافز بداخلها، أو نصنع سيوفاً خشبية لنحارب الكفَّار في الحارة المجاورة..
وكنتُ أنا الوحيد الذي أربط إحدى عينيَّ بخرقة سوداء، فقد كانت تستهويني فكرة أن أصبح قرصاناً بعين واحدة وساق خشبية!!
الآن في السابعة والثلاثين وأشعر أنني كبيتٍ قديم يتداعى.. نوافذ كثيرة لم تعد تنفتح بداخلي، حتى باب بيتنا القديم الذي كنتُ أدفعه بيديَّ الصغيرتين ما زلت أحمله، لكنه أصبح مغلقاً ولم يعد يحتمل الدخول والخروج، لأنه لم يعد قادراً على إصدار تلك الأصوات المرعبة التي كان جدي يُسكتها بقليل من السمن البلدي، وكأنه كان يضع نذوراً لهذا الباب المسكون بأصوات كان يفشل في تقليدها.
أصبحنا نبتهج بالتهاني بعيد الميلاد حتى وإن كان المقابل سنة كاملة، ندفعها للحصول على تهنئة، فكيف نهنئ بعضنا بضياع سنة لنقترب أكثر من الموت!!
الحياة ضربٌ من العبث.. لذلك كنت أحفر اسمي على الصخور، وكأنه تعويذة سيحميها من غوائل الكسَّارات ومطارق البنَّائين.. لكن الديناميت كان أقوى من اسمي المحفور، لذلك آمنتُ أن لكلِّ شيء نهاية.
***
سمحتُ للبعوض أن يقرصني كثيراً.. لا لشيء إلَّا ليتوزَّع دمي بين القبائل، ولأشعر بالتواجد في كلِّ مكان حين يأخذ البعوض قطرة من دمي ويطير.. لم تكن لديَّ البصيرة الكافية لأرى هل كان البعوض يتجشَّأ بعد تلك القطرة أم أنه كان يبصقها لأن فصيلة دمي لا تناسبه!!
تمنَّيتُ كثيراً أن أصبح شخصية كرتونية لأتزوَّج بالليدي أوسكار، وأحمل سيفها لأرى إن كان سيلمع في يدي، ولألمس جاكيتها الأبيض، فقد كنتُ أحلم أن أمتلك مثله في يومٍ ما.. وفي الرابعة والثلاثين توقفت تماماً عن ارتداء أي جاكيت، فقد تصالحت مع الـ نص كُمّْ، وأصبحت نصف يدي محروقة من الشمس، لذلك أحبُّ أن أتعامل معها على أنها يد شخص آخر ما دام لونها مختلفاً عن بقية جسدي.
فرحتُ بالدراجة الصغيرة أكثر من فرحتي بشراء سيارة بآلاف الدولارات.. لماذا كلَّما كبرنا تصغر الفرحة.. كم من الحزن يلزمنا لنفقد فرحتنا بكل شيء!!
***
أكتب الآن وبداخلي رجلٌ ثمانينيٌّ يدخِّن سيجارة طويلة بأصابع مرتعشة وفم خاوٍ يتذكَّر بداية معرفته بأسنانه الَّلبنيَّة.. كغريق يحاول أن يتذكَّر كلَّ شيء، وهو يعلم أن الوقت المتبقي لديه ليس كافياً لأخذ نفس طويل، كي لا يموت وهو يلهث.. وليس كافياً لخلع ملابسه ليلقى الله متخفِّفاً من كلِّ شيء.
هذا الرجل الذي أحمله بداخلي يتوقَّف لألحق به وأصبح من أترابه..
يريدني أن أتقمَّص شخصيته وأسعل كثيراً مثله، وأخبّئ البلغَمَ في منديل قطنيّ كبير، كمنديل حسن عابدين الذي كان يمسح به صلعته وهو على خشبة المسرح..
***
في بداية الأمر كانت تستهويني ساعة الجيب التي يتم تعليقها في الصدر، كنت أرى الارستقراطيين الطليان والإنجليز يخرجونها من جيوبهم- في الأفلام- والغليون في اليد الأخرى.. تمنيت كثيراً لو أنني أنتمي لتلك العصور، وأرتدي قبعة وبنطالاً عريضاً، وأمشي ببطنٍ مترهِّلة وشارب عريض أبيض لأجلس على أحد الكراسي الطويلة التي تنتصب في الحانات أمام المشرب، لأطلب من النادل كأس مارتيني بالتفاح، ثم أضع على طاولته ورقة نقدية كبيرة تتسع لكرمي وأنصرف دون أن آخذ الباقي.
كانت أحلامي واسعة.. العيش بتلك الطريقة مريح ودون تكلفة.. والأفلام الأمريكية تضيف أفقاً أوسع للهرب من الآفاق الضيقة التي ندور في أفلاكها..
وحين تضيق أكثر، أبتسم لنفسي ابتسامة زائفة تشبه ابتسامة فتاة معجون الأسنان..
أحتاج أحياناً كثيرة لهذا الزيف، وأفرح به كما يفرح المتسوِّل بورقة نقدية زائفة..
***
كثيراً ما حلمتُ أن أكون سائق شاحنة.. وكثيراً ما كنتُ أتخيَّلُ أصحابَ الشاحنات الثَّملين في الطريق ما بين فلوريدا والولاية المجاورة لها.. حين توقفه فتاة حسناء وتشير إليه بكُنزتها فيرفض أن يتوقف لها.. ثم يخرج لها يده من النافذة ويرفع لها أصبعه!!
يعتدلُ في جلسته ويصلحُ قبَّعته ويمسح شاربه الأصفر من الخمر المنسكب عليه.. ثم يتحسَّس خاصرته جيداً ليتأكد أن مسدسه- أبو عجلة- ما زال في مكانه..
يتوقَّف عند محطة البنزين ليملأ شاحنته.. ثم ينزل إلى الحانة ليشرب كأساً من المارتيني بالتفاح.. يلتفت فيرى الحسناء ترفع له أصبعها من نافذة سيارة "جغوار"..
يخرج مسدسه من النافذة ويطلق طلقة واحدة ويُـتبعها بشتيمة كبيرة.. كم أغرته هذه الأصبع البيضاء التي رآها عن قرب.
هكذا هو سائق الشاحنة.. يبصقُ على المرآة ليمسحها، ثم يبتسم لنفسه في المرآة عند كلِّ منعطف.. ولا بدَّ أن يكون حذاؤه إلى نصف ساقه.. ولا بد أن يربطَ عنقَه بوشاحٍ بُنِّي اللَّون.. ولا بد أن تكون كلُّ احتياجاته مرميَّة خلف المقعد بعشوائية.. ويكون هناك مسدس احتياطي في دُرج السيارة، إلى جانب صندوق الإسعافات الأولية.
وحين تتعطَّل شاحنته سينزل ويركلُها بقدمه.. وربما أطلق عليها رصاصةً من مسدسه الذي لم يعد يستخدمه في لُعبة الروليت.
يصلُ هذا السائقُ المتهوِّر إلى منعطفٍ خطير.. وهو يعبُّ قارورته التي يدخلها إلى نصفها في فمه.. يقطعُ عليه الطريق كنغرٌ صغير.. يدهسه بالعجلات الخلفية ويخرج رأسه من النافذة ليبصق عليه ويشتُم أمَّه التي تقف على حافة الطريق وهي تصرخ.. ويستمرّ في شتم الكنغر إلى سابع جد.
أبحث عن نهاية لمشوار هذا السائق، فأخترعُ طاحونةً تلوِّحُ له من بعيد.. وهو يفرك عينيه كما لو أنه استيقظ من نومه..
تحت تلك الطاحونة كان يدفن السجائر التي كان يدخنها خفيةً عن أمِّه الراهبة، التي فشلت في جعله يحبّ الكنيسة ليصبح قِسَّاً كبيراً...
فقد كان يرى أن الحانة تتَّسعُ له أكثر من الكنيسة التي كانت تحاصره بتعليماتها المزعجة.
***
تمنيتُ أن أصبح كائناً كرتونياً مثل "كعكي".. هذا الوغد كان يتعبني جداً، وأنا أنتظر إطلالته في مسلسل "افتح يا سمسم"..
استمتاعه بأكل البسكويت، الذي كان يذهب معظمه في الهواء وهو يقضمه.. كان يجعلني أتساءل: ما هي نوعية البسكويت الذي يأكله كعكي، ومن أين يحصل على ثمن كلِّ هذا البسكويت.. فأحسده كثيراً لأنه كائنٌ بسكويتي، وأتغاضى عن صوته البشع..
كنتُ أحبُّ بسكويت فارليز، وأيضاً كنت أحبُّ سيريلاك.. إلى أن شارفت على سن المراهقة التي لم أكن أشعر فيها بأي إرهاق على الإطلاق..
في مطار دبي رأيت بسكويت فارليز.. أخذت علبةً.. دفعت ثمنها للرجل الهندي الذي لن يعرف ماذا يعني فارليز.. ربما أن طعم الفارليز باللغة الهندية سيحتاج إلى ترجمة لكل حبة سُكَّر.. لم أكن أبالي بنظرات الهندي وهو يتفحَّصني باحثاً عن ولد صغير في يدي.. وكأنه بالضرورة أن يكون الفارليز للأطفال فقط؟
كدت أسأله عن الـ سينالكو الأصفر.. لم نكن نسمِّيه برتقال، كنا نسميه أصفر، حسب لونه فقط، وليس حسب طعمه.. وأسأله عن لُبان "فلونة".. وعن ويفر تي شوب، وعن بسكويت جلوكوز.. وبسكويت الأفراح.. وأيضاً عن الـ شونجم أبو أربع حبات.. لم نكن نضطر أن نسميه شونجم أصلي، لأنه لم يكن هناك تقليد.. كان لكلِّ شيء نكهة جميلة.. حتى مسَّاحات الأقلام الرصاص كان لها رائحة مغرية.. وكنا نستنشقها بقوة كما يفعل المدمنون اليوم حين يشمُّون الشَّلَك والتينار.. والبعض كان يأكل هذه المسَّاحات حين يعجز عن مقاومة رائحتها.
حلمت كثيراً أن أصبح شخصية كرتونية وأعيش بداخل مسلسل للأطفال.. حاولتُ إنقاذ سالي كثيراً.. وبحثتُ مع ببيرو عن أبيه الذي اختفى خلف جبال الأولدرادو وهو يبحث عن الذهب.. وفي اليوم التالي أفتح التلفزيون وأتوقع أن أجد ببيرو ممتناً لأني أساعده في العثور على والده..
التعليق
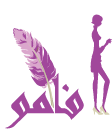

 من نحن
من نحن أشواك الورد
أشواك الورد قصاصات.كوم
قصاصات.كوم متابعات
متابعات فضاء للبوح
فضاء للبوح سرديات
سرديات قصائد
قصائد آراء حرة
آراء حرة في المرآة
في المرآة الأسوأ
الأسوأ دليل فامو
دليل فامو Boutique FaMoh
Boutique FaMoh Café FaMoh
Café FaMoh إتصل بنا
إتصل بنا