سرديات عودة
فصل من رواية : قلوب لمدن قلقة للروائية الفلسطينية دينا سليم (الإثنين 13 أيار 2013)
لم تكن علاقة مكشوفة علنية، بل كانت مستورة خفية.
هي علاقة عبر الانترنت بطلاها اثنان، شاب في أوائل العقد الثالث من عمره، وامرأة في أوائل عقدها الخامس.
عصران متشابهان مختلفان وصديقان حميمان تشاركا الكلمة، النظرة، الصوت والصورة عبر الشبكة العنكبوتية التي جعلت البعيد قريبا، أنها شبكة قادرة أيضا على إبعاد القريب وتجاهل البعيد في آن.
لون أحمر ملح في طرف الجهاز علامة رسالة فورية قادمة، أدخلتني في دوامة التردد، الردّ أم سدّ الطريق أمام المرسل الملح الذي انهمك وأصر على أن يجعل أصابعه تلعب لعبة التواصل مع أنثى مجهولة ظهرت في مكان مجهول، لقّب نفسه (بالعندليب).
ترددتُ كثيرا فأناملي المرتعشة وضعتني في حيرة التردي، لكن الطّارق لا يكف عن إصدار الإيماءات المتكررة فيشتعل الضوء الأحمر مجددا، فأضطر أخيرا إلى الانصياع، كبست على أزرار عجيبة وكأنها صندوق (العجب) الذي أحببته في صغري وما زلت أتذكر صاحبه المتجول في أزقة مدينتي العتيقة، لكن الصندوق هذه المرة يختلف كليا، هو صندوق عصري لا يعتمد إلا على حركة الأنامل والنيّة، الردّ أم التجاهل، التردد أم التسرّع... فاستجبتُ.
عدة كلمات صغيرة الحجم تتصدر الشاشة بلون زهري وبأحرف عربيه، هي اللغة التي أحبها! تحمست وابتسمت، حوطت داخل مربع أزرق فاتح اللون، تتخلله من اليسار صورة المتصل، الذي ظهر أمامي فجأة، شخص لا أعرفه، ولم يسبق لي أن رأيته، كان شابا جميلا في مقتبل العمر.
بحثت في مخزون ذاكرتي عن صورة تشبهه ، فشلت في إيجاد شبيها له يبدو أنه تجاوز الثلاثين، أو ربما أكثر، أو ربما هكذا أردته أن يكون!
بدأت الحوار معه، (سأجرّب)، قلت في سرّي، ولمَ لا، وما المانع؟
أجهضت سلسلة من الأسئلة، وقررت أن أبدأ الحوار دون أن أتذكر حتى اسم السائل المناور، لكنه باغتني بالسؤال:
- مرحبا؟
- أهلا!
- ممكن نتعرف؟
تشاركنا الأسئلة الروتينية قبل أن يبدأ الحوار الجاد:
- كيف حالكِ؟
- هل لديك مانع أن نتحدث قليلا؟
- تفضلّ!
أجبته دون اكتراث حتى بدأت الأسئلة تنهمر عليّ دون سابق إنذار:
- أسمكِ؟
- أين تسكنين؟
- من أين أنتِ؟
- أين تقيمين الآن؟
وهكذا دواليك وحتى...
استطعت قراءة نظرات الطرف الآخر ومكنوناته من خلال صورته المصاحبة، لم تكن الصورة واضحة، لأن وجهه امتلأ بالشعر، فلم أرَ سوى السواد. وعندما طلب رؤيتي عبر الكاميرا، تمنعت بحدة وهددت بإغلاق باب الدردشة إن ألّح، فاستمرت الدردشة كتابيا.
بادرني بالأسئلة العامة وبادلته بدوري بأسئلة استفهامية وتفاصيل كنت بحاجة لها، واستمرت الدردشة حتى طلب أن يراني عبر الكاميرا مجددا، أصررت أن أراه أولا، وكأنه كان مستعدا لطلبي، وبلمح البصر مثلَ أمامي دون مقدمات، حاولت قراءة عينيه وما يختلج فيهما من غموض، كانتا بغاية الجمال، ونظراته أجمل من أن أتوقع وأعمق، أحسست به شابا طموحا، سهل التعامل، لكني برغم كل إلحاحه رفضت أن يراني إلا عبر السطور، ففضلت أن أبقي! تواصلت معه عبر صورتي الشخصية المصاحبة للرسائل، لأني كنت أعلم تماما أن الكاميرا ممكن أن تكشف المدفون!
أصبحت الدردشة من أجمل المهام في حياتي، إلحاح الطالب في الطرف الآخر شيء لا يمكن رفضه، لعبة مسليّة استحوذت عليّ فنسيت نفسي أمام الجهاز، لكن شيئا ما داخلي دعاني إلى خشية التقرب من هذا الطالب الذي استمر مصمما. رفضته بأسلوبي الرقيق، معللة، متحججة، ومن خلال إصراره على الاستمرار، قررت أن أمنح نفسي آخر فرصة كي أختبر من خلالها المجريات، فإما أن أواصل معه دون تعليل، أو أقوم بقطع خيط الوصال من أول الطريق، وعندما سألته عن اسمه، اهتزت دواخلي واضطربت.
هذا الشيء الذي يتحرك أمامي من البعيد يحمل اسما أحببته وما أزال، اسم حبيب فقدته بلمح البصر، غاب عني مدة طويلة ولا أعرف عنه أي شيء، إن كان على قيد الحياة حتى، إنه يعيدني إلى أحب النوبات على قلبي، إلى حبيب قديم، إلى أوّل حب عرفه قلبي، إلى والدي!
- لو تعرف كم أحب هذا الاسم؟ قلتُ له.
- اسمي أنا؟
- نعم اسمكَ!
- ألن تبوحي لي بسرّ حبكِ له؟
- لاحقا
- ولمَ ليس الآن!
- قلت لاحقا. (أجبته بحزم)
غافلتني طرقات صاخبة على باب الشقة، أخرجتني من صومعة خيالي الدافئ وشوشت عليّ اللحظة، بحثت عن زر إغلاق الشاشة، إستغرقني الوقت حتى وجدته، فأنا ما زلت حديثة العهد بهذا الاختراع، أغلقت نافذة الدردشة بسرعة فائقة وتركت المنتظر في الجانب الآخر في حيرة وقلق.
أعرف تلك اليد ، انه ابني الصغير (ديفيد) الذي دخل من فتحة الباب وشرع يحتل المكان بصخبه ووعورة خطواته، مستحوذا على جهاز الحاسوب.
هو الصغير المدلل الذي بقي في البيت، يدرأ عني بعض الملل، خاصة بعد أن غادرني الجميع وأخذوا يمارسون حياتهم الرتيبة بعيدا عني، دون أن يتركوا آثار الاشتياق في قلبي، وحتى وإن مكثوا فكأنهم غير موجودين، لن يتغير الحال، سأبقى أشعر بالوحدة والغربة حتى بين أسرتي المكونة من خمسة رجال وطفل.
طيبتي وقلبي المرهف يدعواني إلى الهذيان، أهذي في فراغ موحش كلما سمعت أصواتهم تتغلغل داخل ضلوعي، يستيقظ صوت الأمومة داخلي، وكذلك صوت الخوف من المجهول، والخوف من المستقبل المبهم الذي يلف عائلتي، أبنائي يتعثرون حتى آخر النفق، يلقون حتفهم رويدا رويدا، هم عالقون داخل ممرات معتمة، وأترابهم طوابير طويلة حيث لا شيء، ثمِلو العقل ميتون، والميت أبدا لا يعود الى الحياة، هم بحاجة لأكثر من السُكر المحرم.
يقبلون على الأوامر وينفذونها لأنهم يخضعون لها دون مناقشة ،كتب عليهم أن يبقوا سُكارى السنين، ومخدري الذهن والعافية، يطلقون في الفضاء المتعفن أصواتهم الميتة، دائمي الطلب والطلب لا يتحقق، الله يتأخر، والمسيح المنتظر لا يستجيب، يناورونه الظهور بالشفاعة، يستعجلونه الوصول، أرواحهم تبقى في سبات قيد عقائدهم، لا يأتون إلا بالخبر الميّت، يبست ألسنتهم من كثرة الدعاء، لا أحد يأتي، جيل يرحل ويأتي آخر إلى القعر ولا شيء يحدث، ميتون منذ الولادة، مَن يدفن مَن، من يأبه لهم، من يسمعهم، أين مخلصهم؟
أشعر كلما تذكرتهم أني زرعت عدة نبتات في أفق الوقت الضائع، وما زلت أنتظر موعد زهوها، والموعد يطول.
كلما استيقظت صباحا أجد إحدى رئتيّ قد نفد منها الهواء، ليتهم لم يكونوا أبنائي، أو بالأصح ليتني لست والدتهم!
*
التعليق
لم تكن علاقة مكشوفة علنية، بل كانت مستورة خفية.
هي علاقة عبر الانترنت بطلاها اثنان، شاب في أوائل العقد الثالث من عمره، وامرأة في أوائل عقدها الخامس.
عصران متشابهان مختلفان وصديقان حميمان تشاركا الكلمة، النظرة، الصوت والصورة عبر الشبكة العنكبوتية التي جعلت البعيد قريبا، أنها شبكة قادرة أيضا على إبعاد القريب وتجاهل البعيد في آن.
لون أحمر ملح في طرف الجهاز علامة رسالة فورية قادمة، أدخلتني في دوامة التردد، الردّ أم سدّ الطريق أمام المرسل الملح الذي انهمك وأصر على أن يجعل أصابعه تلعب لعبة التواصل مع أنثى مجهولة ظهرت في مكان مجهول، لقّب نفسه (بالعندليب).
ترددتُ كثيرا فأناملي المرتعشة وضعتني في حيرة التردي، لكن الطّارق لا يكف عن إصدار الإيماءات المتكررة فيشتعل الضوء الأحمر مجددا، فأضطر أخيرا إلى الانصياع، كبست على أزرار عجيبة وكأنها صندوق (العجب) الذي أحببته في صغري وما زلت أتذكر صاحبه المتجول في أزقة مدينتي العتيقة، لكن الصندوق هذه المرة يختلف كليا، هو صندوق عصري لا يعتمد إلا على حركة الأنامل والنيّة، الردّ أم التجاهل، التردد أم التسرّع... فاستجبتُ.
عدة كلمات صغيرة الحجم تتصدر الشاشة بلون زهري وبأحرف عربيه، هي اللغة التي أحبها! تحمست وابتسمت، حوطت داخل مربع أزرق فاتح اللون، تتخلله من اليسار صورة المتصل، الذي ظهر أمامي فجأة، شخص لا أعرفه، ولم يسبق لي أن رأيته، كان شابا جميلا في مقتبل العمر.
بحثت في مخزون ذاكرتي عن صورة تشبهه ، فشلت في إيجاد شبيها له يبدو أنه تجاوز الثلاثين، أو ربما أكثر، أو ربما هكذا أردته أن يكون!
بدأت الحوار معه، (سأجرّب)، قلت في سرّي، ولمَ لا، وما المانع؟
أجهضت سلسلة من الأسئلة، وقررت أن أبدأ الحوار دون أن أتذكر حتى اسم السائل المناور، لكنه باغتني بالسؤال:
- مرحبا؟
- أهلا!
- ممكن نتعرف؟
تشاركنا الأسئلة الروتينية قبل أن يبدأ الحوار الجاد:
- كيف حالكِ؟
- هل لديك مانع أن نتحدث قليلا؟
- تفضلّ!
أجبته دون اكتراث حتى بدأت الأسئلة تنهمر عليّ دون سابق إنذار:
- أسمكِ؟
- أين تسكنين؟
- من أين أنتِ؟
- أين تقيمين الآن؟
وهكذا دواليك وحتى...
استطعت قراءة نظرات الطرف الآخر ومكنوناته من خلال صورته المصاحبة، لم تكن الصورة واضحة، لأن وجهه امتلأ بالشعر، فلم أرَ سوى السواد. وعندما طلب رؤيتي عبر الكاميرا، تمنعت بحدة وهددت بإغلاق باب الدردشة إن ألّح، فاستمرت الدردشة كتابيا.
بادرني بالأسئلة العامة وبادلته بدوري بأسئلة استفهامية وتفاصيل كنت بحاجة لها، واستمرت الدردشة حتى طلب أن يراني عبر الكاميرا مجددا، أصررت أن أراه أولا، وكأنه كان مستعدا لطلبي، وبلمح البصر مثلَ أمامي دون مقدمات، حاولت قراءة عينيه وما يختلج فيهما من غموض، كانتا بغاية الجمال، ونظراته أجمل من أن أتوقع وأعمق، أحسست به شابا طموحا، سهل التعامل، لكني برغم كل إلحاحه رفضت أن يراني إلا عبر السطور، ففضلت أن أبقي! تواصلت معه عبر صورتي الشخصية المصاحبة للرسائل، لأني كنت أعلم تماما أن الكاميرا ممكن أن تكشف المدفون!
أصبحت الدردشة من أجمل المهام في حياتي، إلحاح الطالب في الطرف الآخر شيء لا يمكن رفضه، لعبة مسليّة استحوذت عليّ فنسيت نفسي أمام الجهاز، لكن شيئا ما داخلي دعاني إلى خشية التقرب من هذا الطالب الذي استمر مصمما. رفضته بأسلوبي الرقيق، معللة، متحججة، ومن خلال إصراره على الاستمرار، قررت أن أمنح نفسي آخر فرصة كي أختبر من خلالها المجريات، فإما أن أواصل معه دون تعليل، أو أقوم بقطع خيط الوصال من أول الطريق، وعندما سألته عن اسمه، اهتزت دواخلي واضطربت.
هذا الشيء الذي يتحرك أمامي من البعيد يحمل اسما أحببته وما أزال، اسم حبيب فقدته بلمح البصر، غاب عني مدة طويلة ولا أعرف عنه أي شيء، إن كان على قيد الحياة حتى، إنه يعيدني إلى أحب النوبات على قلبي، إلى حبيب قديم، إلى أوّل حب عرفه قلبي، إلى والدي!
- لو تعرف كم أحب هذا الاسم؟ قلتُ له.
- اسمي أنا؟
- نعم اسمكَ!
- ألن تبوحي لي بسرّ حبكِ له؟
- لاحقا
- ولمَ ليس الآن!
- قلت لاحقا. (أجبته بحزم)
غافلتني طرقات صاخبة على باب الشقة، أخرجتني من صومعة خيالي الدافئ وشوشت عليّ اللحظة، بحثت عن زر إغلاق الشاشة، إستغرقني الوقت حتى وجدته، فأنا ما زلت حديثة العهد بهذا الاختراع، أغلقت نافذة الدردشة بسرعة فائقة وتركت المنتظر في الجانب الآخر في حيرة وقلق.
أعرف تلك اليد ، انه ابني الصغير (ديفيد) الذي دخل من فتحة الباب وشرع يحتل المكان بصخبه ووعورة خطواته، مستحوذا على جهاز الحاسوب.
هو الصغير المدلل الذي بقي في البيت، يدرأ عني بعض الملل، خاصة بعد أن غادرني الجميع وأخذوا يمارسون حياتهم الرتيبة بعيدا عني، دون أن يتركوا آثار الاشتياق في قلبي، وحتى وإن مكثوا فكأنهم غير موجودين، لن يتغير الحال، سأبقى أشعر بالوحدة والغربة حتى بين أسرتي المكونة من خمسة رجال وطفل.
طيبتي وقلبي المرهف يدعواني إلى الهذيان، أهذي في فراغ موحش كلما سمعت أصواتهم تتغلغل داخل ضلوعي، يستيقظ صوت الأمومة داخلي، وكذلك صوت الخوف من المجهول، والخوف من المستقبل المبهم الذي يلف عائلتي، أبنائي يتعثرون حتى آخر النفق، يلقون حتفهم رويدا رويدا، هم عالقون داخل ممرات معتمة، وأترابهم طوابير طويلة حيث لا شيء، ثمِلو العقل ميتون، والميت أبدا لا يعود الى الحياة، هم بحاجة لأكثر من السُكر المحرم.
يقبلون على الأوامر وينفذونها لأنهم يخضعون لها دون مناقشة ،كتب عليهم أن يبقوا سُكارى السنين، ومخدري الذهن والعافية، يطلقون في الفضاء المتعفن أصواتهم الميتة، دائمي الطلب والطلب لا يتحقق، الله يتأخر، والمسيح المنتظر لا يستجيب، يناورونه الظهور بالشفاعة، يستعجلونه الوصول، أرواحهم تبقى في سبات قيد عقائدهم، لا يأتون إلا بالخبر الميّت، يبست ألسنتهم من كثرة الدعاء، لا أحد يأتي، جيل يرحل ويأتي آخر إلى القعر ولا شيء يحدث، ميتون منذ الولادة، مَن يدفن مَن، من يأبه لهم، من يسمعهم، أين مخلصهم؟
أشعر كلما تذكرتهم أني زرعت عدة نبتات في أفق الوقت الضائع، وما زلت أنتظر موعد زهوها، والموعد يطول.
كلما استيقظت صباحا أجد إحدى رئتيّ قد نفد منها الهواء، ليتهم لم يكونوا أبنائي، أو بالأصح ليتني لست والدتهم!
*
التعليق
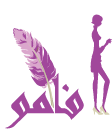

 من نحن
من نحن أشواك الورد
أشواك الورد قصاصات.كوم
قصاصات.كوم متابعات
متابعات فضاء للبوح
فضاء للبوح سرديات
سرديات قصائد
قصائد آراء حرة
آراء حرة في المرآة
في المرآة الأسوأ
الأسوأ دليل فامو
دليل فامو Boutique FaMoh
Boutique FaMoh Café FaMoh
Café FaMoh إتصل بنا
إتصل بنا